طالما نشكو الفجوة بين التربية والتعليم ومآلاتها على الحاضر والمستقبل، ثم البحث عن سبل ردم هذه الفجوة ليكون لدينا خريجو جامعات يحملون العلم مصحوباً بالأخلاق والآداب والقيم الانسانية، ويكاد الواحد منّا يشعر باليأس من تحقيق هذا الأمل، بيد أن التفاتة بسيطة الى سيرة النبي الأكرم، وابنه الإمام الصادق، صلوات الله عليهما، ونحن نعيش هذه الايام ذكرى مولدهما السعيد، تعطينا شعوراً مغايراً نتأمل من خلاله الخلاص من آثار هذه الفجوة على علاقاتنا الاجتماعية.
ما يمكننا اسلتهامه من هذه الذكرى العطرة؛ الاهتمام المشترك للنبي الأكرم والامام الصادق بمسألتين أساس في البناء الحضاري هما؛ التربية والتعليم، مع الفارق أن في عهد النبي الأكرم كان التأسيس، وفي عهد الامام الصادق شهد التطبيق العملي على نطاق أوسع في جسم المجتمع الاسلامي الكبير.
التأسيس للعلم والأخلاق
صحيح أن علم رسول الله، والأئمة المعصومين، ليس اكتسابياً بقدر ما هو "لدنيّاً"، أي هو النور الذي يقذفه الله –تعالى- مباشرة في قلوبهم، فيودعهم علم ما كان وما يكون الى قيام الساعة، بيد أن النبي الأكرم في بدايات تشييده المجتمع الاسلامي حثّ على التعلّم واكتساب العلم والمعرفة، ونحن نقرأ احاديث مشهورة له، صلى الله عليه وآله، شأنها أن تكتب بماء الذهب وتعلق على أبواب المدارس والجامعات: "أطلب العلم من المهد الى اللحد"، ثم يوجه حديثه المباشر الى المسلمين كافة: "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة"، ليغلق الباب الى الأبد بوجه كل محتكري العلم والمعرفة، واصحاب الفهم الخاطئ ممن يرون العلم للميسورين مادياً، او للرجال دون النساء، او يحددوه بعمر معين.
أما عن الأخلاق، فما عسانا ذكره من واحة عطرة على مدّ البصر، إنما نقتطف العفو من جملة خصاله وصفاته، وفي ظروف طالما نعيشها في حياتنا اليومية.
فقد روي أن النبي الأكرم كان جالساً ذات يوم مع اصحابه، وعليه بُرد غليظ الحاشية (أعلى القميص عند الرقبة)، فجذبه أعرابي بشدّة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه، ثم قال: يامحمد! احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك، ولا مال أبيك! فسكت النبي ثم قال: المال ما الله، وأنا عبده، ثم قال، صلى الله عليه وآله: ويُقادّ منك يا أعرابي ما فعلت بي؟ قال: لا، قال النبي: لِمَ؟ قال: لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة، فضحك النبي، وأمر ان يحمل له على بعير شعير، وعلى الآخر تمر.
هذه الرواية تحتاج وقفة تأمّل ودراسة بعد تفكيك الجمل الواردة فيها لنأخذ دروساً عدّة في الحِلم، والعفو عند المقدرة، والتواضع، وتفهّم طبيعة ومزاج الطرف الآخر بغية إيصال الرسالة الصحيحة اليه، يكفي أن نتصور حصول هذا المشهد اليوم مع أبسط انسان كيف تكون ردة الفعل؟!
ولمن يتابع المواقف المشابهة للنبي الأكرم مع ابناء مجتمعه آنذاك، يجد الحرص الواضح منه، صلى الله عليه وآله، لاستيعاب الناس ببرودة أعصاب، للاستيعاب مع رباطة الجأش والصبر، مما يعلمنا تجاوز اللحظة الراهنة والتطلع الى ما بعد الموقف المثير لمشاعر الغضب والكراهية، وهي المرحلة التي يبشرنا بها القرآن الكريم: {فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ}.
الرسالة للعالم الإسلامي الكبير
اذا كانت رسالة العلم والأخلاق في عهد الرسول الأكرم محصورة في حدود المدينة ومجتمعها الصغير في بداية الدعوة، فأنها في عهد الامام الصادق أمام مجتمع اسلامي كبير يعيش في بلاد مترامية الأطراف بين شرق الأرض وغربها، فقد تعددت الأمزجة والطباع والنفوس بعد دخول عشرات الآلاف الى الإسلام من شتى الاعراق والقوميات، مما يجعل مهمة التربية والتعليم صعبة للغاية.
وما عقّد الظروف الاجتماعية والسياسية في عهد الامام الصادق، حاجة الناس الى التهذيب والتقويم الأخلاقي، كما حاجتهم في نفس الوقت الى المعين الصافي للعلم والمعرفة في وقت تزاحمت على الأمة روافد من المعارف الفارسية والرومية واليونانية بعد نشاط حركة الترجمة للكتب الفلسفية التي وجدها البعض من المحسوبين على "علماء الدين" آنذاك بأن يتخذوها بديلاً للقرآن الكريم و سيرة النبي و رواياته وسيرته لصياغة عقيدة الانسان المسلم.
لذا كان عهد الامام الصادق هو الانطلاقة لشخصية العالم العارف، وفي نفس الوقت المتحلّي بالصدق والأمانة والورع والتقوى، فيكون لدينا العالم الخلوق القادر على إدارة شؤون الأمة في ضوء العلوم والمعارف الإسلامية، فكان، عليه السلام، يحرص دائماً على تكريس ثقافة "أدب جعفر" في نفوس تلامذته والمقربين منه ليكونوا النموذج الناصع لثقافة أهل بيت رسول الله بين سائر المسلمين ممن هم على غير مذهب الإمام الصادق، فقد كان عامة المسلمين في عهد الأئمة المعصومين على دين الحكام وما يصدر من وعاظ السلاطين وفقهاء البلاط فقط، وكان يقول: "ان الرجل اذا ورع في دينه وصدق الحديث، وأدى الأمانة، وحسن خلقه مع الناس، قيل: "هذا جعفري" فيسرني ذلك، ويدخل عليّ منه السرور، وقيل "هذا أدب جعفر"، واذا كان على غير ذلك، دخل عليّ بلاؤه، وعاره، وقيل: "هذا أدب جعفر"! (الامام الصادق من المهد الى اللحد- السيد محمد كاظم القزيني).
وليس دقيقاً القول أن الامام الصادق كانت مفروشة له الأرض بالورود لإقامة الدروس العلمية وتأسيس ما نسميه اليوم بالجامعة، إنما كان يواجه تحديات جمّة في هذا الطريق، ليس أخطرها؛ الحقد الأسود للمنصور الدوانيقي عليه، ومحاولة قتله عدة مرات، و ربما كانت الفترة التي سبقت المنصور، وفي بدايات حكم العباسيين ثمة فسحة زمنية كانوا فيها منشغلين بمطاردة فلول الأمويين للتخلص منهم ومن احتمالات الانتقام، بيد أن المنصور كان مشدداً الحصار والحظر على الإمام الصادق في أن يلتقي بشيعته وتلامذته، الى درجة أن بات الشيعة مُجبرين على اعتزال النساء ممن له مسألة شرعية في النكاح او الطلاق بسبب انقطاع الاتصال بالإمام الصادق، عليه السلام.
والتحدي الآخر من أشباه العلماء في عصره، فقد روي عن رجل جاء المدينة وأتى مسجد رسول الله يسأل عن العالم في هذه المدينة فقالوا: "عبد الله بن الحسن" فسأله عدة اسئلة كان اجوبته مثار استغراب الرجل، منها: قوله في أكل الجريّ، أحلال هو أم حرام؟ فقال له: حلال، إلا إنا أهل البيت نعافه! ثم سأله عن المسح على الخفين، قال: قد مسح قومٌ صالحون، ونحن أهل البيت لانمسح!
فخرج من المسجد غير مقتنع بالإجابات، فكرر طلبه بعالم هذه المدينة حتى رفع رجل رأسه وقال: إئت جعفر بن محمد الصادق، فهو أعلم أهل هذا البيت، فلامه بعض من كان بالحضرة، يقول السيد القزويني في مؤلفه القيّم، ويضيف نقلاً عن ذاك الرجل: إن القوم إنما منعهم من إرشادي اليه أول مرة، الحسد.
ومن سمع بقصة ذلك الرجل الذي سرق رغيفين من الخبز، ورمانتين ثم تصدق بهما الى فقير، فهو لم يكن رجلاً عادياً جاهلاً، إنما كان من دعاة العلم ممن وصفه الإمام الصادق نفسه في رواية ينقلها السيد القزويني في كتابه بأنه "اتبع هواه وأعجب برأيه كان كرجلٍ سمعت غُثاء الناس (السطحيون والساذجون) تعظمه وتصفه"، وعندما تبعه الامام وانفرد به ليسأله عما فعله، لم يتورع عن التطاول على الامام بمجادلته متخذاً آيات القرآن الكريم وسيلة لتبرير عمله، وأن {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا}، فردّ عليه الامام بأن القرآن الكريم يقول: {إنّما يتقبّل اللهُ مِنَ المُتّقين}، فلم ينفع معه، فتركه الامام ومضى عنه.
وثمة علماء كُثر في عهد الامام الصادق استأنسوا برأيهم الخاص، مستجيبين لرغباتهم النفسية بحب التألق وكسب الشهرة، حتى وإن تطلب الأمر التخلّي عن القرآن الكريم وعن سيرة النبي الأكرم، فأسسوا لانفسهم ولطائفة من المسلمين شريعة وأحكاماً خاصة تخالف في كثير منها الشريعة التي أتى بها رسول الله، حتى أنه، عليه السلام، حاجج أحدهم بالآية القرآنية فكانت المفاجأة قوله: "يبدو اني لم أقرأها من قبل"!
لم يكن للإمام الصادق، عليه السلام، مكاناً مخصصاً لنشر علوم الدين وعلوم الحياة، بلى؛ ربما كان لفترة من الزمن الى جوار ضريح جدّه المصطفى، أو في الكوفة، بيد أن الحكام الطغاة لم يكونوا ليسمحوا له بالاستمرار في هذا الضخ والعطاء، لربما لو استمر الأمر لفترة طويلة من الزمن لكان التراث أعظم وأكبر بكثير مما لدينا اليوم من الروايات والعلوم.
ينقل السيد القزويني عن المحقق الحلّي في كتابه "المعتبر": "وكانت مدرسته في داره بالمدينة، وفي المسجد، واينما وُجد، وكان من يرد المدينة من الآفاق، في موسم الحج، يسأله ويأخذ عنه"، ويضيف السيد القزويني في مؤلفه القيّم: "ما كان هدف اصحاب وتلاميذ الامام الصادق، عليه السلام، الرياء والسمعة، والشهرة، ولا تحصيل شهادة التخرج من تلك المدرسة، كشهادة الدكتوراه، او الماجستير وامثالها المعروفة في هذا العصر، وإنما هدفهم الاول والاخير؛ خدمة الدين".
هكذا كانت مدرسة الإمام الصادق، عليه السلام، العلمية والاخلاقية ليكون للأمة علماء ناجحون في مجتمعاتهم، يرجع اليهم الناس في مشاكلهم، وايضاً في استفهاماتهم العديدة حول مختلف شؤون الحياة، فيجيبون بكل ثقة واحترام، واذا نجد اليوم الخزين الهائل من الروايات الشريفة، والمؤلفات العظيمة في علوم الدين من عباقرة الفقه في تاريخنا المعاصر والقديم، فانه امتداد لأولئك العباقرة المتعلمين في مدرسة الامام الصادق، عليه السلام.




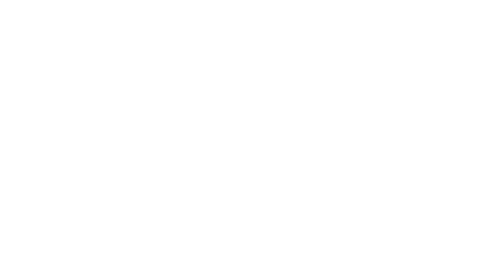
 تقييم المقال
تقييم المقال



