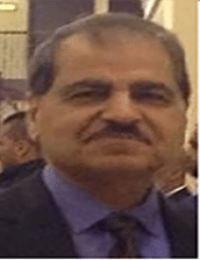من يتأمل تاريخ العراق خلال العهد العثماني، يكتشف أن الحقد الطائفي لم يكن عارضاً أو ناتجاً عن سياسات فردية، بل سلوكاً مؤسسياً ممنهجاً طال المجتمعات الشيعية، لا سيما في النجف وكربلاء، حيث ارتُكبت جرائم مروّعة باسم الدولة والقانون، بحجة فرض النظام أو استعادة الهيبة، بينما كانت في حقيقتها تصفية حسابات مع أتباع مدرسة آل البيت (عليهم السلام).
فهل كان حبّ علي بن أبي طالب (عليه السلام) يستوجب الحصار والمجازر؟ وهل الولاء لأئمة الهدى جريمة تستدعي أن تُستباح المدن وتُنهب البيوت ويُقتل الآلاف؟ هذه الأسئلة تُلقي بظلالها على وقائع موثقة وقعت خلال القرن التاسع عشر، وكانت كربلاء والنجف مسرحاً لها، وشاهداً حيّاً على أقسى أنواع البطش الطائفي الممنهج.
كربلاء.. المدينة المحاصرة والمذبوحة
بدأت سلسلة الجرائم العثمانية بحق كربلاء بشكل صارخ في عام 1835م، حين فرض والي بغداد العثماني علي رضا اللاز (1831-1842م) حصاراً خانقاً على المدينة، لم يُفك إلا بعد أن دفع الأهالي مبلغاً ضخماً قُدّر بـ(70,000) قران، كضريبة قسرية لإنقاذ أرواحهم ومقدساتهم من الاجتياح. لم يكن الهدف من الحصار تأديب الخارجين عن القانون أو ضبط الأمن، بل إذلال مدينة عُرفت بولائها العميق للإمام الحسين (عليه السلام) ومكانتها في وجدان الشيعة.
لكن الأسوأ جاء بعد ذلك بسنوات قليلة، وتحديداً في عام 1842م، حين تولّى محمد نجيب ولاية بغداد (1842-1850م)، وقاد جيشاً كبيراً لمحاصرة كربلاء مجدداً. استمر الحصار (23) يوماً، انتهى باقتحام دموي للمدينة بعد مقاومة شرسة من أهلها. ومع دخول القوات العثمانية، لجأ السكان إلى الحضرة العباسية طلباً للنجاة، لكن قدسية المكان لم تُثنِ العسكر عن ارتكاب مجزرة بشعة.
دخل الوالي محمد نجيب حرم أبي الفضل العباس (عليه السلام) ممتطياً جواده، في مشهد لا يخلو من التحدي والاستهانة بالمقدسات، ثم أمر بإباحة المدينة لجنده ليوم كامل، فكانت النتيجة كارثة إنسانية بكل المقاييس: آلاف القتلى، اغتصاب، نهب للمنازل، وتدنيس للمزارات. وقدّر عدد الشهداء آنذاك بأكثر من (4000) شيعي، في واحدة من أبشع المجازر الطائفية في تاريخ العراق الحديث.
النجف.. مهد العلم تحت تهديد المدافع
النجف، مدينة العلم والمرجعية، لم تكن في مأمن من السياسات القمعية ذاتها. ففي عهد نامق باشا (1850-1851م)، أُوعز إلى الضابط العثماني والشاعر المعروف عبد الباقي العمري بقيادة حملة عسكرية على المدينة، حيث هدد بقصفها بالمدفعية ما لم تخضع لسلطة الدولة، فدخلها مهدداً ومتوعداً، دون مراعاة لرمزيتها العلمية والدينية.
لم تكتفِ السلطة بذلك، بل عمدت إلى تغيير البنية الإدارية للمراقد المقدسة، فعُيّن سدنة من المذهب السني لإدارة أضرحة الأئمة في النجف وكربلاء، في محاولة واضحة للهيمنة الرمزية على هذه المراكز الروحية، ومحو الطابع الشيعي منها، الأمر الذي قوبل برفض شعبي كبير، لكنه لم يكن كافياً لوقف ذلك التعدي.
تجريم الشعائر وتكميم العزاء
استهدفت الدولة العثمانية كذلك الشعائر الحسينية، باعتبارها أحد أبرز رموز الهوية الشيعية. ففي عهد حكم المماليك، لم يكن بمقدور الشيعة إقامة مجالس العزاء علانية، بل اضطروا إلى إحيائها في السراديب، حيث كان صاحب الدار يُجلس امرأة عند الباب لتدوير الرحى وإخفاء صوت القراءة، خشية أن يسمعها الجيران فيبلغوا عنها.
وفي عام 1869م، أصدر مدحت باشا (1869-1872م) قراراً صريحاً بمنع إقامة المجالس الحسينية، مهدداً بمعاقبة من يُقيم العزاء، في خطوة تكشف عمق الخوف العثماني من هذا الإرث التعبوي، الذي يُجذّر في نفوس الناس مفاهيم المقاومة والتحدي ورفض الظلم.
نهب الخزائن.. بيع المقدسات مقابل مشاريع الدولة
في عام 1870م، اقترح مدحت باشا بيع نفائس مرقد الإمام علي (عليه السلام) بحجة تمويل إنشاء خط سكك حديدية من خانقين إلى بغداد. لم يُعرض الأمر على أهالي النجف، ولم يُراعَ فيه أدنى درجات الحرمة، وكأن المراقد مجرد خزائن مفتوحة لخدمة الدولة ومصالحها، لا أماكن مقدسة تعبّر عن هوية شعب وعمق روحي عابر للحدود.
جنوب العراق.. وقود لحروب الآخرين
ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، تجلى أسوأ أشكال الاضطهاد العثماني ضد أبناء الجنوب الشيعي، حيث سُوق الآلاف منهم قسراً إلى جبهات القتال النائية، مثل معركة "صاري قاميش" على الحدود الروسية، وهي معركة جليدية مميتة لم تكن للعراقيين فيها لا ناقة ولا جمل.
مات معظم أولئك الشبان في الثلوج، ومن نجا أُرسل إلى المنافي الباردة، مثل سيبيريا أو جزيرة الخنازير، ليموت هناك بلا هوية، بلا وداع، فقط لأنه وُلد شيعياً في جنوب العراق.
وفي النهاية التاريخ لا يُنسى، لقد شكّلت هذه الأحداث وغيرها فصولاً دامية في كتاب الظلم الطائفي الذي مارسه العثمانيون على الشيعة في العراق. وما كربلاء والنجف سوى رمزين لما تعرضت له مدن الجنوب من تهميش وإذلال وقمع واستباحة. ومع ذلك، بقيت هذه المدن صامدة، رافعة راية الحق، محافظة على هويتها، متمسكة بمبادئها، لتُثبت أن الدم لا يُهزم إذا كان في سبيل العقيدة، وأن من يسير على نهج علي والحسين، قد يُطعن، لكنه لا ينكسر.
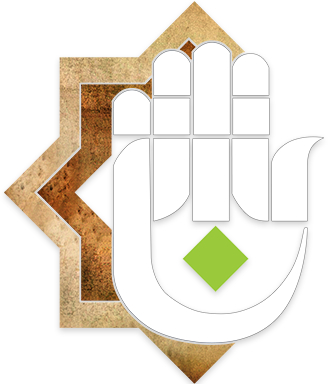


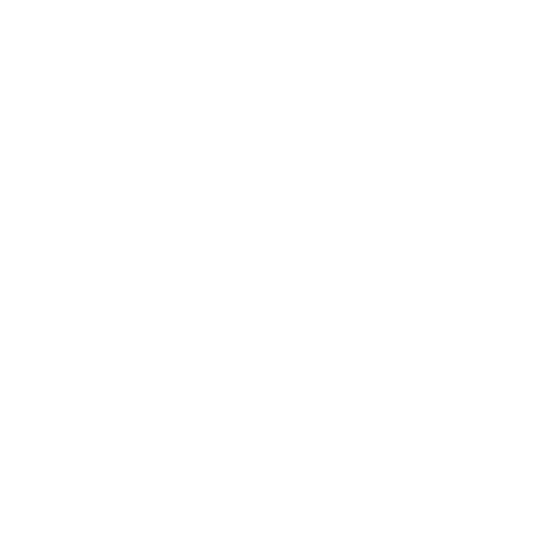
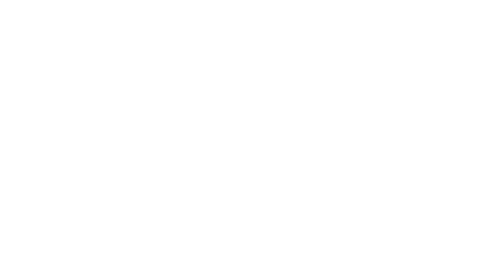
 تقييم المقال
تقييم المقال