منذ فجر التاريخ، لم يكن الانقسام بين الأجيال وليد اللحظة، بل هو ظاهرة ضاربة في جذور الاجتماع البشري، اذ لطالما شكّلت العبارة المتكررة "جيل اليوم لا يشبهنا" مرآةً لمخاوف الأجيال السابقة أمام سلوكيات من يأتون بعدهم، وكأن الزمن خان الذاكرة وبدّل المعايير، إلا أن السؤال الأهم: هل نحن أمام صراع حتمي بين أجيال متباينة، أم أمام عجز متراكم عن بناء لغة تفاهم مشترك؟
من أفلاطون الذي عبّر عن خيبته من شباب أثينا في القرن الرابع قبل الميلاد، إلى الدراسات الحديثة التي أُجريت في الولايات المتحدة وأوروبا عن فجوة القيم بين الآباء والأبناء، يتضح أن الهوة بين الأجيال لا تنشأ من الخلاف حول المبادئ فحسب، بل من تغيّر في السياق الحضاري والزمني الذي ينشأ فيه كل جيل، ففي زمن الرقمنة المتسارعة، أصبحت الهوة أكبر من أي وقت مضى، حيث يتحرك الجيل الجديد بلغة الإيموجي والذكاء الاصطناعي، بينما لا يزال كثير من الكبار يحنّون إلى أيام الرسائل الورقية والهواتف الأرضية، هنا، يحدث التصادم الذي قد يبدو للبعض صراعًا، لكنه في الحقيقة فقدان للمفاتيح المشتركة لفهم الواقع.
أحد الأبحاث التي نشرتها "مجلة علم النفس التنموي" (Developmental Psychology) عام 2021 تشير إلى أن الجيل الجديد يتمتع بقدرة أعلى على التكيّف الرقمي، لكنه يعاني في المقابل من ضعف في التواصل اللفظي مع الأهل، والدراسة ذاتها أوصت بأن السبب لا يعود إلى الجيل الشاب فقط، بل إلى عجز المؤسسة الأسرية والتربوية عن ملاحقة التغيرات النفسية واللغوية التي تفرضها الأدوات الرقمية الحديثة.
في العراق، كما في غيره من البلدان ذات التركيبة الاجتماعية المركبة، تزداد حدة هذا الصراع بسبب خلل في الوسائط التربوية وعدم تجديد الخطاب الأسري المبني على الدين والقيم، ما يخلق شعورًا مزدوجًا لدى الشباب: الاغتراب داخل الأسرة، والخوف من الرفض خارجها، فالأب الذي يرى ابنه غارقًا في "التيك توك"، يظنه ضائعًا؛ والابن الذي يستمع إلى محاضرات دائمة عن "الأيام الذهبية"، يشعر أنه لا يُفهم.
ولأن الصراع بين الأجيال ليس نتيجة حتمية للاختلاف، بل لفشل أدوات الحوار، تصبح المدرسة والمسجد والجامعة والمنزل وسائل ضرورية لا فقط لنقل المعلومات، بل لبناء نماذج تواصلية تُنقذ المجتمع من الانقسام الداخلي، اذ لا بد من استلهام نماذج عالمية نجحت في تقليص الفجوة، مثل برامج "التربية المشتركة" في فنلندا التي تربط الأهل بالطلاب في حلقات نقاش شهرية، ومبادرات "الجدّ الرقمي" في كندا التي تُدرب كبار السن على استخدام التكنولوجيا مع أحفادهم كوسيلة للتواصل، لا كساحة صراع.
المفارقة أن الجيل الجديد لا يرفض القيم كما يُشاع، بل يرفض الأساليب التي يُفرض بها تفسير تلك القيم، على سبيل المثال، جيل ما بعد 2000 لا يطلب التحرر من المسؤولية، بل يبحث عن معنى لها يتلاءم مع عالمه المتغيّر، فالقيم الأخلاقية ليست محل نزاع، لكن ترجمتها بلغة الماضي دون مرونة أو إدراك لسياق الحاضر هو ما يصنع هذا الارتباك الجماعي في التعامل مع الشباب.
ولذلك، فإن المطلوب ليس أن تُفرض القيم على الجيل الجديد، بل أن تُشرح له بطريقة تُقنعه بأنها امتداد لجذوره، لا قيود على حريته، كما أن على الجيل الأكبر أن يعترف بأن المستقبل ليس امتدادًا حتميًا للماضي، بل بناء جديد يحتاج إلى ثقة متبادلة وتفاهم حقيقي.
في النهاية، لا أحد يريد أن يهدم الجسر، لكن كثيرين لا يعرفون كيف يُبنى، وعليه، فإن أفضل ما يمكن فعله هو إعادة هندسة العلاقة بين الأجيال على أسس من الاحترام والإصغاء والتفاهم، فالمجتمع الذي يُحسن استخدام ذاكرته، ويمنح شبابه حق الاختلاف، هو المجتمع الذي لا يسقط حين يتغير الزمان، بل يتجدد بوعي وحنكة، فلا يمكننا منع الزمن من الدوران، لكن يمكننا اختيار ألا ندور في دوامة الصراع ذاته جيلاً بعد جيل.
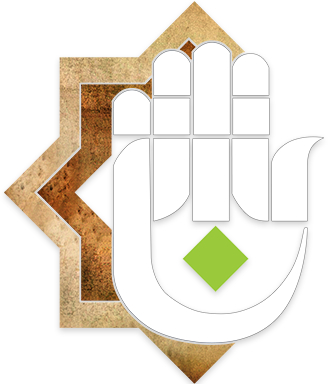


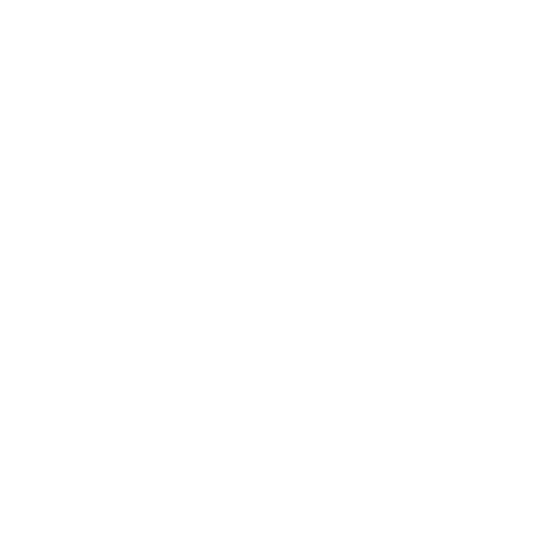
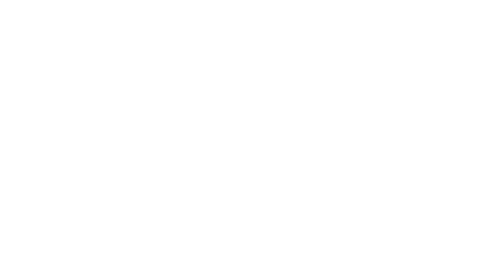
 تقييم المقال
تقييم المقال



