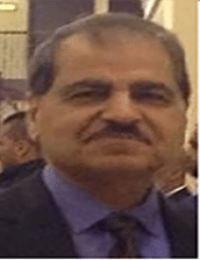رغم ما يملكه العراق من إرث حضاري تعليمي وتربوي عريق، إلا أن ظاهرة التسرّب المدرسي تحوّلت في العقود الأخيرة إلى واحدة من أكثر الأزمات البنيوية خطورة وتأثيراً في مستقبل البلاد، ولم تعد هذه الظاهرة مجرّد خلل في قطاع التعليم، بل تحوّلت إلى معضلة اجتماعية تمس الأمن الوطني وتُهدد الأجيال المقبلة بالفقر والجهل والانقطاع عن المشاركة في البناء الوطني.
من حيث التعريف، يشير التسرّب المدرسي إلى انقطاع الطالب عن التعليم قبل إتمامه للمرحلة الدراسية الإلزامية، وغالبًا ما يكون نتيجةً لمزيج معقّد من الأسباب الاقتصادية، الاجتماعية، التربوية، والصحية، ففي العراق، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا بسبب تراكم الأزمات التي ضربت البلاد من الحروب، والعقوبات، والاحتلال، والإرهاب، والطائفية، والفساد، والحرمان الاقتصادي.
ورغم أن العراق في سبعينيات القرن الماضي سجّل مستويات تعليمية مشرفة، انخفض معها معدل التسرّب إلى ما يقارب 5% وفق تقارير اليونسكو، إلا أن الحال انقلب في العقد الأخير من الألفية، فقد أعلنت وزارة التربية العراقية في تقرير لها عام 2017 أن نسبة التسرب بين الطلبة وصلت إلى 20%، وهي نسبة يُرجّح المختصون أنها أقل من الواقع الفعلي إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار مناطق النزوح والنزاعات، والمناطق المحرومة من الخدمات الأساسية.
وينص الدستور العراقي النافذ في المادة (34) على أن "التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحـة الأمية، والتعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله"، كما أن قانون التعليم الإلزامي رقم 118 لسنة 1976 ينص صراحة على إلزام الأسر بإلحاق أطفالها في المدارس من سن 6 إلى 11 سنة، ويحمّل الإدارات المحلية مسؤولية التنفيذ، لكن على الرغم من هذا التأطير الدستوري والقانوني، فإن الالتزام به لا يتجاوز الورق في كثير من الأحيان، نتيجة ضعف الرقابة وغياب آليات التنفيذ الرادعة.
الأمم المتحدة، بدورها، حذّرت في أكثر من مناسبة من كارثية استمرار هذه الظاهرة في العراق، فحسب تقرير اليونيسف لعام 2023، يوجد نحو 3 ملايين طفل عراقي خارج النظام التعليمي، نصفهم تقريبًا في المرحلة الابتدائية، ويُعد هذا الرقم صادمًا بكل المقاييس، خصوصًا إذا ما قورن بعدد السكان ونسبة الشباب ضمن الهرم السكاني، كما ربطت المنظمة بين التسرب وبين تفاقم مؤشرات مثل عمالة الأطفال، والجريمة المنظمة، وانتشار الأمية المزمنة.
وتعود أسباب الظاهرة إلى طيف واسع من العوامل، في الصدارة تقف الأزمة الاقتصادية، إذ تدفع آلاف الأسر أطفالها إلى العمل في سن مبكر لتأمين مصدر دخل إضافي، على حساب تعليمهم، تليها أسباب اجتماعية وثقافية، مثل ضعف الوعي بأهمية التعليم، والعادات لدى بعض الأسر التي لا ترى في المدرسة سوى مضيعة للوقت، خاصة للفتيات، إلى جانب ذلك، يلعب العنف الأسري، وسوء الخدمات التعليمية، والاكتظاظ في الصفوف، وعدم توفر المدارس خاصة في المناطق الريفية دورًا كبيرًا في هروب الأطفال من مقاعد الدراسة.
إلى ذلك، ساهمت الأحداث السياسية والأمنية، خصوصًا في المناطق التي سيطر عليها داعش، في تدمير المئات من المدارس، وتهجير آلاف العائلات، مما قطع مسيرة التعليم لكثير من التلاميذ دون عودة.
وهنا يُطرح السؤال الجوهري: هل الدولة العراقية عاجزة عن التصدي لهذه الظاهرة؟ الجواب لا ينبغي أن يُبنى على النوايا، بل على السياسات، لا يمكن الحديث عن مكافحة التسرّب دون مراجعة شاملة لمنظومة التعليم: مناهج، بنى تحتية، كفاءة المعلمين، البيئة المدرسية، إلى جانب الشراكة مع الأسر والمجتمع المدني، كما ينبغي أن تمتلك الدولة الإرادة السياسية لمحاسبة الأسر التي لا ترسل أبناءها إلى المدارس، وتفعيل القوانين الداعمة للتعليم الإلزامي.
من الحلول العملية الممكنة: إطلاق برامج "مدارس محمولة" في المناطق النائية، وتوفير النقل المجاني للأطفال في الأرياف، وربط المنح الاجتماعية بتسجيل الأطفال في المدارس، وإنشاء شبكات دعم نفسي واجتماعي للطلبة في مناطق النزاعات، كما يجب أن تشمل المعالجات الجذرية إطلاق مشروع وطني تحت عنوان "العودة إلى المدرسة"، تتكامل فيه جهود الدولة مع المجتمع، تُرصد له ميزانيات خاصة، ويُتابع من أعلى المستويات.
كذلك لا بد من تعديل قانون التعليم الإلزامي ليشمل التعليم حتى سن 18 عامًا، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تعتبر التعليم الثانوي ضرورة، وليس خيارًا، كما يجب تعديل فلسفة النظام التربوي العراقي ليكون تعليمًا للحياة، لا للحفظ فقط، تعليمًا يُنمي المهارات ويعزز القيم الوطنية، ويجعل المدرسة بيتًا يُحتضن فيه الطفل لا مكانًا طاردًا.
إن معالجة التسرّب المدرسي لا تنفصل عن ملف الإصلاح الاجتماعي في العراق، بل هي الخطوة الأولى نحو أي مشروع نهضوي، فالتعليم ليس ترفًا ولا خيارًا ثانوياً، بل هو الطريق الوحيد لبناء الإنسان، ومن دون الإنسان المتعلم لا يمكن بناء وطن.
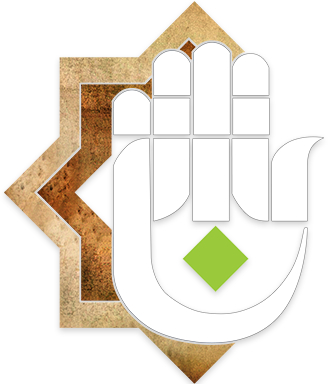


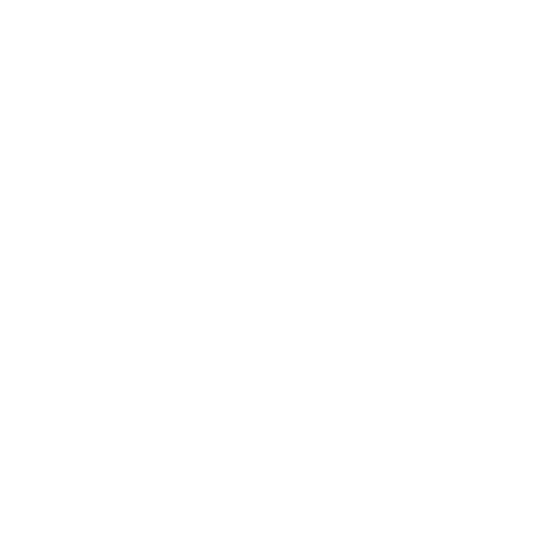
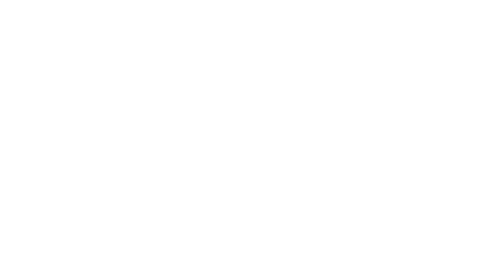
 تقييم المقال
تقييم المقال