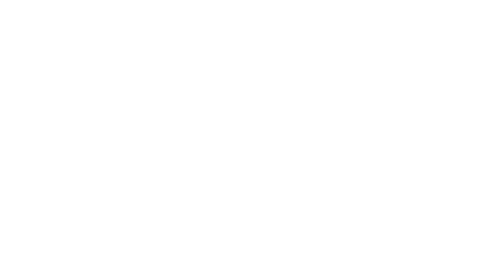المقدمة
الحمد لله رب العلمين، وصلّى الله على سيّدنا محمّد(صلى الله عليه وآله) وعلى آله الأطهار الميامين(عليهم السلام)، وبعد...
يقول الله تعالى: ﴿قُلۡ هَلۡ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحۡدَى ٱلۡحُسۡنَيَيۡنِۖ وَنَحۡنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمۡ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَاب مِّنۡ عِندِهِۦٓ أَوۡ بِأَيۡدِينَاۖ فَتَرَبَّصُوٓاْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ﴾[1].
أيّها العزيز... هل ترى فرقاً بين الشهادة، والنصر؟ في الحقيقة إنّما هو انتصار واحد يسعى وراءه المجاهد، وباقي الأمور من الشهادة والهزيمة وحتى النصر، إنّما هي أمور ظاهرية. الانتصار الأوحد للمكلّف هو بأن يقوم بتكليفه على أكمل وجه، أن يهزم الشيطان الذي يوسوس له بالفرار والهروب والغدر والخيانة. فمتى ما تحقّق ذلك وانتصر المكلّف على شيطانه، فإنْ منَّ الله بالنصر فرح المجاهد به، وإنْ منّ عليه بالشهادة والقتل في
سبيله زادت فرحته أضعافاً، وإن كانت المعركة في الحقيقة قد كسبها الأعداء.
هذا الفكر وهذه الروح هو ما كنا نستلهمه من روح الشهيد الشيخ عماد حيدر أحمد، ونقرأه على صفحات وجهه البريء، قبل أن نسمعه من لسانه. فهنيئاً له الشهادة على هدى القرآن والعترة.
الحمدلله رب العالمين
الرّوح اللّانهائيّ
لَم تكُنْ «رأْس أُسْطا» المسْتلقيةُ بين المنحدَرات والهضاب، اسْتلقاء راعٍ مُتْعَب بين أغنامه الوادعة، المـُطِلَّة ببساطة منازلها، وقناعة قاطنيها، على مدينة جُبيل الساحليّة، أقلَّ حظًّا من رفيقاتها القرى الجبليّة المنتشرة كالعرائس الخضراء على صدر لبنان وأطرافه. فمع استحواذها على مناخ معتدل وامتيازها بعذوبة مياهها وفتنة أوديتها، بدَتْ على ذلك المرتفَع الخلاّب، وأمام تلك الشّواطئ السّاحرة، كجنّيّة حسْناء، أرسلَتها ربَّةُ السُّحُبِ والفصول، لتسْتَنْبت الأشْجار المثْمرة والمواسِم الوافرة، وتتفرَّجَ بخُيلاء على مسارح البَحْر الّذي لا ينام، وتتبرّجَ بزينتها وعُطورها أمام أُفقه السَّاجد بغيْر انْقطاع أمام وجْه الأبديّة.
بين تلالِها الحالمة وكُرومها السَّخيَّة، وعلى مَرْأى من نَسائِمها العذراء وعواصِفها الزَّاعِقة، وُلِد الطِّفل البَهيّ الطّلْعة عِماد حيدر أحمد، وعلى جَنباتِها النَّاضِرة تقلَّبَتْ نَظراتُه، وأزْهرتْ عواطفُه، وبيْن أزقَّتها الضّيِّقة، ودروبها المتعرِّجة، تنقَّلتْ قدَماه، وتسارعتْ خَواطره تبحثُ عن المقاصد المجْهولة
والمعالم المأْهولة، فبَانَ بين اسْتحالة إدْراك الأُولى، وصُعوبة استيعابِ الثّانية، كطائر صامتٍ ألقتْه الرّيحُ الغضوب في صحراء موحِشة، ثمَّ لفَحهُ الهجيرُ فأوْجَعَ جناحيْه ومانَعَه عن الطَّيَران، بَيْدَ أنَّه لم يهدأْ في محطّات طفولته، ولم يسْتكنْ في غمْرة صِباه، كما لم يستسْلم لقيود الحداثة الّتي تعبثُ بآمال الصِّغار، وتنْأى بأمانيهم، بلِ انْقاد لهواجسَ خفيَّة غريبة، وميولٍ لذيذة توالدتْ في أعماقه، وامتزجتْ مع أنفاسه، وتسرْبلتْ سَرائِرَه، فَرسم ببصيرَتِه السَّاطِعةِ على صفحَةِ غدِه صورةً فاقِعةً فارِعة تُحاكِيهِ وتحكيه للعامِلين والعابرين والمعتبرين.
وتمسَّك الفتى الطّموح بشمائل فاضلة، وخِصال كريمة، تمخَّضتْ عن أرْيَحيَّةٍ شائقة وسيرة رائقة.
حِكَمٌ وأمثال وآيات، تنْسابُ من مواعظه كومْضات النّور المنْبثقةِ من ثنايا غيوم الفجر، ابتسامات واثقة تنتظمُ على مُحيّاه كدَوائر مائيَّة أحْدثَها ارْتطام حَصاة بصَفْحة بئْرٍ ساكنة، شعاعٌ لطيف ينعْكس من عينيْه فيزيد سِحْنته رُواءً ونَضَارة، انْزواءٌ مُحبَّبٌ يتلبَّس طِباعَه، يُشْعِركَ وأنت تتفحَّص أحْواله، وتُدقِّق في بواعثه، أنّك أمام فكْر شاعريّ، يحومُ بيْن الإنْشاء
والأشْياء، وتخالُه حينما تُصْغي إلى أحاديثه الآسرة، كَنارًا غِرِّيدًا، مُرفْرفًا على ضِفّة يُنبوع نَمير، انْبَثَق من قَعْرِ المكان، غامرًا ما حولَه بالأُنْس والصَّفاء، فرحًا بالموجودات، مترنّمًا متألِّقًا، هامسًا أسْراره النّامية في آذان الأيّام والليالي.
على زُرْقة البحْر الأخَّاذة انْفرجتْ أساريرُ عِماد النَّقيّة، ومع طيور البراري السّابحة صدحتْ روحُه التَّوّاقة إلى ما وراء المرئيّات، وبين تلك المنْعَطفات الملْتوية ثابر كالنّحلة النَّاشطة، باحثًا تارة عن الرِّزق الكامن في دقائق التُّربة الخِصْبة، وطوْرًا عن الوحْدة الوليدة من رَحِم الطّبيعة البِكْر، حيث يُتيح السّكون الغامرُ للمتأمّل الفطين، والمتفكِّر الرّزين، ابْتداع الإيحاءات الباطنيّة، والإِيماءات العقْليّة، الّتي تَتوالدُ حِكمة جليّة، وعِرْفانًا خاشِعًا، من قَرائحِ المتصوِّفين وَمعابدِ المتولِّهين في هيْكل الرّوح المطْلَق.
لم يخْتر المزارعون مِهْنة الحراثة عن سابق عهْد أو وازعِ إرادة، بلْ وجَدوا أنفُسَهم وذَويهم مقْذوفين من العَدَم، على هذه الحقول المتناثرة، وبين تلك الصّخور المتلاحمة، فانتسبوا إلى مناكبها، وانشغلوا بخدمتها، مُقاومين الفقْر الضَّاربَ أطْنابَه، والحِرمانَ السَّاحِبَ أذْنابَه، بعزيمة لا تَليِن يَرْفدُها رَحاَبَةُ الرَّجاء،
وتَكْتَنِفُهَا ضَرَاوَةُ العَمل، مُتسلِّحين برُفوشهم وفُؤُوسِهم، جائدين بِعَرَقهم الدّافِق، وقُواهم الدّافئة، يتّقون مَهالكَ العناصِر والأنْواء، بِمواقِدهم ومراقِدهم، ويستقْبلون مفاتن الفصول وغِلالَها بمحبَّة لا تَخْمُد وسَواعد لا تهْمُد.
في مَسَاعِي الفَلاّحين وعلى بيادرهم عَثَر عِماد على نفْسِه، وفوْق أديم مكارمهِم ومحامدهم نبتتْ شَجرةُ كيانهِ الغَضَّة، فاتَّصف بقوّة الشّكيمة ودَمَاثَةِ الخُلُق وحلاوَةِ العِشْرَة، وسَلامة الطَّبْع، وإفْشاء السّلام، وَهجْر الَّلهْو، وتجنُّبِ الَّلغْو، وصِدقِ الموْقِف، وحُسْنِ المقال، وَغُنْمِ الفَعَال، وبذْلِ الجُهْد، فإذا ما تفحَّصَه حَصيف، قَرَأ على وجْهه سُطُورًا نُورَانيّة واضحة، تنِمُّ عمَّا يختزن في سَرائره، من بَداهَةِ التَّواضع، وطَلاوة التَّعارف وصَفاء النِّيَّة، ورَباطَة الجأْش، ولَطالما بَدَا لِمُعَايِنيه في مَرابع كدِّه ومَيادين عَطائه، سُنْبُلَةً ذهبيَّة من سنابل المزَارِع، وعُنْقودا متلأْلئًا من عناقيدها، وطاقةً زاهية من ريَاحينها، وما العهْدُ الممْتدُّ بين طفولته المتنامية، وشبابه الفائر إلّا حلقاتٌ متماسكةٌ لامعةٌ، من الاجْتهاد والاعْتماد والاتّحاد، اجْتهادٌ في اكْتساب العِلْم والحكْمة واللُّقْمة، واعتمادٌ على رازقه ونفْسه وكدْحه، واتّحادٌ بالمأْلوف والمعروف والمجهول.
هنا قادَ المواشي إلى المراعي القريبة، وهناك هرْول خَلْفَ أحَدِ عُلماء الدّين مُبْتغِيًا الكُشوف الرّبّانية، وهُنالِك تَلاَ القرآنَ على مسْمع الفجْر، وقرأ الأدعية في محافل قوْمه وسَهَراتهم العامَّة، وفي هذا المنزل علَّم أهْلَه وأرْحَامه الصَّلاة وأَداَء المناسِك، وعنْد ساحَة البلْدة دَعا الشِّيب والشُّبَّان إلى مُؤَازرَة المقَاومة، وفوقَ منْبر المسْجد ذكَّر الناسَ بالارتباط بالله، وتوحيد الصَّف، والتَّراحُم والتَّواصُل بيْن الجيران، والأخْذ بالشِّدّة على أعداء الوطن والحقّ والإنسان. بَرَع في أَدَائِه المدْرسي فَنَال الإطراء تِلْو الإطْراء من معلِّميه، ونَأَى بنفْسه عن الشُّبهات والخوْض مع الجهَلاء والمكابرين، أمَّا الإصلاح بين المتخاصمين فقد غدا ديْدنَه المحبَّب، ومُتْعتَه الرّائجة.
وبِذكاء وقّاد، ورويَّة حَسنة وَفَّق بيْن واجباته الدينيّة ومهامِّه الثّقافيّة، وبيْن شؤون العائلة وشجون المجتمع، فأصْبح على الرُّغمِ من يَفَاعتِه مثلًا راقيًا يُحْتذى للشَّبيبه الطّامحة، والأجْيال المشرئبَّة الأَعْنَاق إلى غَدٍ ناهض.
نَعَمْ، كان الشابّ عِماد يفكِّر بقلْبه ويشْعر بعقْله، ويحلُم في يقظته الدّائمة ببلوغ آفاقٍ لم تطأْها أجْنِحَة طائر، واكتشاف معالِمَ لمْ تُلامسْها بَعْدُ أشِعَّةُ الشَّمْسِ.
لم يخيِّب الحِرْمان القابضُ على أنْفاس القرويّين آماله الواسعة، فلَكَمْ شَعَر بالاكتِفاء بالقليل من مَتاع الدُّنيا، والرِّضا بالكَفاف من طيّبات الأرض، فالغِنى في شرْعه هو ثَراءُ العقْل، وأمَّا الجوع الحقيقيّ فإنَّه الخَواء الرُّوحيُّ المميت، الّذي لا يسُدُّه إلاَّ خبْزُ المعْرفة المجلَّلةِ بالنُّور، والعِرفانُ المستمرُّ الدَّوران في قُبَّة الذَّات العُلْيا حَيْثُ تَتَّحدُ إرادةُ الله بِسَعَادة الإنسان.
أمَّا المصائبُ الّتي تعثَّر بها، والمصاعِب الّتي استخفَّتْ به، فقد قَهَر طَلاَئعَها، وأَبادَ تَوابعَها، بمُثَابَرَة نافذة، وبسْمة فائضة، تتقلَّب وتتلوَّنُ مَزْهُوَّة على طَلْعَتِهِ المزْهِرَة، صفراء كالذَّهَب بيضاء كاللُّجيْن سنيَّةً كوَجْنَةِ طِفلٍ رَضيع.
الوثبْةُ الأُولى
إنّ أجْمَل لِباسٍ يرْتديه المرْءُ هو لِباس التّقوى؛ فالفضائل الّتي تحلَّى بها الأنبياء، والمكارمُ الّتي تَباهَى بها العُظماء، والكمالات المحْتَدِمةُ في صُدور الموْهوبين والمتأدِّبين، هي الجواهرُ الثَّمينة والدَّفينة في خزَائن الحياة المحْفوفة بالمخاطِر والمكاره، بلْ إنّها السُّدود المعْنويّة، الّتي تحولُ دون انْجراف الأمم إلى الْحضيض المشْؤُوم وانْحراف المدنيّة عن مَسَالك الأمن والسَّلامة؛ فالأخلاق الكريمة تجسِّد سلامةَ المدنيَّات، وتصون لُبابَ الثّقافات، وهي أيضًا الرَّادع الأَقْوى للكوارث والمجاعات والحُروب، والرَّافع الأعْظم للبِنَاء الْحَضَاريّ الّذي تَنْشُدُه الشُّعوب، في مَراحل تَطَوُّرِها ومعارج تكاملها.
وعِماد حيدر بَطَل قصَّتنا هذه، جَمع ثرْوته الخلُقيَّة من مناجم كيْنونَته ومَواقع أصالته، إذْ ورِث الوطنيّة والتَّضحية والوَفَاء عن عَشيرته الّتي ناوأتِ الاستعمار والهَوَان في عصْر الانتداب البغيض، وعن أهْلِه الّذين صَدَقوا الله فأعْطاهُم الأمل، وصَادقوا الأرْض فوافَتْهم بالأقْوات، ونَظَر إلى ما حَوْلَه
من الكائنات فاسْتهان بِها واندَفَع نَحْوها، بضرورة الاسْتخلاف وقوَّة الاسْتمرار، وقلَّب بصيرتَه في صفَحات الكُتُب وحواشِي المجلَّدات، فأضاءتْ زوايا عاقِلته، وحملتْه على أجْنحة الخيال إلى حقائق الماضِي ودقائق الحاضر، ثمَّ التأَم مع ذاته، وأحبَّها حبًّا جمًّا حتّى اقترنَ بِها، مُحصِيًا حَسناتِها وسيّئاتها، محاسِبا إيّاها حسابًا عسيرًا، قبْلَ فَناءِ الأَزْمان وفَوات الأوان، مستعينًا بالرَّحيم الأرحم والكريم الأَكْرم، الّذي اصْطَفاه عبدًا مُطيعًا تزكِّيه العبادة المجرَّدة، والمعاملةُ المؤيَّدة.
بيْن اجتهاده الأفْضَل وَوَرَعهِ الأمثَل توقَّد فِكرُهُ وتشعَّب أمرُه، ولم تتَّسع ثانويَّة جبيْل ومنزلُه الأَبَويّ، لِمراميه البعيدة، وأُمنياته العديدة، وغاياته الرّشيدة، فغادر تلك الرّبوع، يدْفعُه حِرْصه على النَّجاح في الدّنيا، والفلاح في الآخرة، إلى الحوزة الدينيّة في بيروت حيث التّعفف يصاحب التَّهجُّد، والانْضباط يلازم الارْتباط، والسّعادة تُعانق العِبادة.
وارْتسمتْ طرائقُه، واخْتمرتْ مآربُه، وابتهجتْ سَرائرُه بالعِلْم الّذي يقوده إلى الهدى، والتّبتُّل الّذي يطهِّره من أقذار الشّهوات وسُموم الموبِقات.
استقبلَ المعهدُ الشّرعيّ الإسلاميّ، القابع في قلْب ضاحية بيروت الجنوبيّة، طالبَه الجديدَ، بحفاوة بالغة وفرَح جارف، فإدارة المعهد السّاهرة، وأساتذتُه المجتهدون، حريصون على زيادة عديد المنتسبين إلى هذا الصَّرح التعليميّ الرّائد، ولا سيّما النابهون والأذكياء، فكان قدوم عِماد بنهجه الأصيل وخطوه النّبيل وروحِه الوثّابة بارقة أمل ثاقب يواكب مؤسَّستهم ويُوائم رغبتَها في تخريج كوكبة من العلماء الإلهيّين، الّذين ينذرون أوقاتهم للهدْم والبناء، في حاضرٍ قلقٍ ومستقْبَل مجْهول مُتعطّشٍ للإرْشاد والازْدهار.
بدَأَ عِماد الزَّاهدُ في المادَّة ووشائِجِها، الرّاغبُ بما وراءَ الأَعْراض الزّائلة من جواهرَ حيَّة، دوْرة حياته الحوْزوّية، الحافلة بالاسْتقراء والاسْتيعاب.
غرِق بين المجلَّدات الضّخْمة والمقاصد الغامضة، غاص في عُباب اللّغة والفِقْه، واسْترسل متجوِّلًا بيْن الفلْسفة والتاريخ، ينقّب بلا كللٍ عن الوثائق والحقائق، مقارنًا بين المذاهب الفكريّة مستنطِقًا المعاني المبْهَمة، مستفسرًا عن كلّ ما تراه عيناه وما تسمعُه أُذُناه.
فارسُ المعرفة الّذي لا يترجَّل، عطشانُ من كرام المسافرين، ينْهلُ من بُطون القرآن ومنابع الحديث، رائدُه صبْرٌ لا ينْثلِم، ورفيقُه كتابٌ لا ينْغلق، تضطرمُ جوارحُه حماسةً، وتتسارعُ خطواتُه لَجاجة، رائدُه الحضور عند المهمّات الصّعبة، وغايته العبور على العقَبات الكأْداء، يُعرِّض فؤاده للوهَن، وعيْنيه للعَياء، فهو يَودُّ اجتياز المسافة القصيرة بين المهْد واللَّحْد في برهة خاطفة، حاملًا على كاهله الأمانةَ الكونيَّة، الّتي أشْفقت الجبالُ من حَمْلها، أمانة خِلافة الأرْض الّتي يرثُها عبادُ الله الصّالحون.
القائدُ والمعلِّم
بَدَأَتْ رِعَاية الشّيخ عِماد تمتدُّ إلى أبناء قرْيته، فاتَّبع الطُّرُق الواضحة، والتجاربَ الفالحةَ الّتي اقتبسَها عن أساطين الفكر، وجهَابذة التّصوُّف، أَضْراب صدْر المتألّهين الشّيرازي، والإمام روحِ الله الخمينيّ.
رتّب أوْلويّاته، وطبَّقَ نظرِيَّاته، ولمْ يكنْ ليَخفَى عليه، أنَّ نهوضَ الأمّة يبدأُ بتنوير عقول أبنْائها، وصِحَّةَ الجماعات مَنوطةٌ بسلامة الأفراد، وتلْقيحَ الأفكار مُوازٍ لِتنْقيح الآداب، فكُلُّ أُفولٍ معنويّ أو نُزوعٍ حضاريّ، تقرِّره أهواءُ النَّفْس وميولُها «إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ». واصْطدمتْ منهجيَّةُ الشّيخ اليافِع في رحلته التبليغيّة الرَّصينة، بمصاعبِ النّزاع ومشاقِّ الصِّراع، صِراع الأضْداد على حَلْبَةِ بيئته وجِوارها: الجهْلُ والعِلْمُ، التخلُّف والتقدُّم، العوَزُ والرَّخاء، الشكّ والإيمان، والنّزاعُ الأبديّ القائم بين العادات والتقالِيد البائدة الّتي يتوارثُها اليومُ الحائر عن الأمسِ الخائر وبين المبادئ الخُلُقِيّة والأفْكار السَّامية الّتي تختزنُها الكُتُب المنزَّلة من الله، تلك المناراتُ الهادية إلى
الصّواب، المتجدّدة بالسَّلام، المسدَّدةُ بالكمال.
انْبَجَسَ وعيُه، وانْجَلتْ رُؤاهُ، يواكِبُ سُنَّة التّنافُس، وناموسَ التَّدافُع، بيْن الثّقافات الطّارئة، الّتي تمزُج السُّمَّ في الدَّسَم، والّتي تحملُها الرّياحُ الحضاريّة من فضاء إلى فضاء، وبيْن الهُويَّة الشَّرقيّة المرْسومة بعبْقريَّة الأنبْياء، الموسومة بحدْسِهم وحِسِّهم وأَسْفارهم.
وتفتَّقتْ ذهنيَّة الإيمان الفيَّاضة في مساعي الشّيخ اليافع، عنْ وصايا حكيمة، ومواعظ جمَّة، غرسَها في قلوب خالية ونفوس خاوية، فارْتادَ المسْجدَ، يؤُمُّ فيه الصّلوات، وارتفعَ صوتُه في الشّعائر الدينيّة، والذّكريات الوطنيّة بشيرًا نذيرًا، داعيًا إلى سبيل ربّه بالحكمْة والموْعظة الحسَنة، مُدغْدغًا أرْواح القرويِّين، بيقظَة خمينيّة ناهضة، ونهْضة إسْلاميّة مستيقِظة، تكْبَحُ جِماحَ الضّياع، وتمْنعُ تسَرُّب الضَّلال، منتصرًا لثوْرةٍ حسيْنيّة مشْتعِلة بيْن المشْرق والمغْرب، تناوئُ المستكْبرين، وتُؤازرُ المستضْعَفين وتقِفُ للظَّالمين وأذْنابهم وأظْلافهم بالمِرْصَاد.
عُيِّن الشّيخ التقيّ قائدًا كشْفيًّا لِفوْج الإمام الرّضا c فوَقَفَ وَقْتَهُ ووطَّدَ نفْسَهُ، على الاتِّباع المعْروف، والابتْداع
الموصوف، في مضامين هذه الحركة التّربويّة الرّائدة، فحدَّد أدْوار الأشْبال، ودرَّبهم على احْتمال الأعْباء، الّتي تنتظرُ كواهلَهم في غَدٍ مُشَرِّف، أتْحفَهم بروائع حِكْمته وبَدائع معارِفِهِ، من دون تملُّقٍ انْتهازي، أو تعثُّر أَدبيّ، أو إساءة طائشة، همُّه الأوَّل سلامة عقُولهم، ورَباطة جأْشهم، ولَكمْ كانوا مشْدُوهين بالبرامج المشوِّقة الّتي تُغذِّي مَلَكَاتِهم، وتسْتهْوي مواهِبَهم، وتربِطهمْ بِعُرًى وَثِيقةٍ من الأدَب الخلاَّق، وتُشْبعُ نَهَمهم من الصَّداقة المجرَّدة، وتُحفِّزُهُم على اجْتراح المعْجزات لإنْقاذِ موطنهم، وَمثَوى جُدودهِم، منْ بَراثِن الصّهيونية الغادرة.
مرَّ فصلُ الخريف على قرية «رأْس أُسطا» شاحبَ الوجْه كعادته، عاريَ الأطراف إلّا من بعض الأسْمال الرَّثّة الّتي لا تكادُ تسْترُ عوْرته، وهُرعَ الفلّاحون إلى محارثهم ودوابِّهم، يستوْدعون بِذارَهم صدْر الأرْض المكلوم، ويُطعمون مَواشيَهم ما أبقتْه العناصرُ لها من هشيمٍ يابس وأوراق صفْراء.
في أواسِطِ هذا الفصْل الكئيب، وفي اليوم الحاديَ عشَر من تشْرين الثّاني، كانت ذكْرى الشّهيد أحمد قصير العاملي، فاتح عصْر الاسْتشهاديّين، تنهضُ من مَدافِن العصور الخالية، مسْتعْرضةً مآتي صاحِبها الأَبيّ، متجوّلة على منازل الأحْرار،
ومعاهد الأنْصار، فتلقَّفَ الشّيخ عِماد هذه الذّكْرى كمن عثَر على ضالَّته، وراودَه الحنينُ إلى ذلك البطَل المسلم الشّجاع الّذي عَبَر المسافات الشّاسعة، الفاصلة بين الفَناء والبقاء، بلحْظةٍ فدائيّة واحدة.
وعندما بلغت الشَّمسُ ضُحاها جمع الكشّافة مهنّئًا، وحيّا باسمهم النجيع الّذي ضاع عبيره والبطولة الّتي عزَّ نظيرها.
ثمَّ دَعا الفوْجَ الّذي يتعهَّده إلى صعود تلَّة منزَوِيَةٍ علَى أطْراف القرية، هناك جلسُوا حوْل مائدة مختلفةِ الألوان، وقد شاطرهم تناول الطّعام، وساهَمهم التأمُّلَ في الغيوم المهاجِرة، والاسْتمتاع بموحيات الطّبيعة، ثم وقَفَ في وسَطهِم كالقُطْب من الرَّحَى، وعَرضَ بلسانٍ فصيح، ومنطقٍ رجيح، للفِتْيان المتحمِّسين، مُعْجزة هذا اليوم المبارك، مفسّرًا تبعاتِه، واصفًا ما حمله من بشائر ومسرَّات ورسائل، إلى الوطن والأمّة، وسمّاه عيد الثّائر والمقاوم، الثّائِر الّذي لا يُساوم، والمقاوم الّذي لا يُهادِنُ.
وبيَّنَ بفراسة المؤمن، أنَّ الوطن التائه في الفتنِ المتأجّجة، والحبائل المتعرِّجة، الُمغْتصبةَ أرْضُه المدنَّسَ عِرْضُهُ، يُعَوِّلُ
على حداثتهم الصّاعدة على سلالِم الأدب والاستقامة، مُتمايلةً في كَنَف المستقْبل المـُزبد، أشجارًا سامقة مُثْمرة، تظلِّل العابرين، وتُطْعم الجائعين، روَى لهم القِصصَ المأْساويَة المبكية المذْهلة، الطّافحة بضَحايا الاضْطهاد، وجرائم الاسْتبداد، الشّاهدة على التّعسُّف الصُّهيوني المعْهود، واصِفًا بجَزالةِ بيَانِه قداسة الدّماء المبْذولة، وسيولَها الجارفة في أودية الجنوب ومَعابِره، طالبًا منهم العهْدَ على مُعانقَةِ المجْد مُوصِيًا: برفع الرّايات الصّفراء ولو بعْد حين.
الْتأمتْ جماعةُ الكشَّاف حوْل معلِّمها الفاضِل، ومُربِّيها الصَّدوق، التآم أوراقِ الوردة النَّدية حوْل بذورها، ثمّ وقَفَ الشّيخ أمامهم مرفوعَ الهامة وُقوف سِنديانةٍ قويَّة أمام الأزاهِر وأجال بصَره على سِحْنَاتِهم، كأنَّه يَبْحثُ عن أشْياء ثمينة، مُودَعَةٍ وراءَها، وأطْلق وجهَه بابتسامة رِضًى واستْكفاء قائلًا:
«أنتم براعمُ عابقة تزيّن حدائق الوطَن، الّذي يَفْخر بعناية آبائكم ودِراية أحْلامكم، فهو يرى بَهْجته وعُمرانه في تناديكُم الحثيثِ وتلاقيكُم الأليف، بلْ إنَّه يَخْتالُ بآثاره المحمودة، ومعالِمه المحفوظة بتآخيكم، المصونة بسواعِدكم».
«ها أنذا أرْقُبُ في ألْحاظكم سِعَةَ رِحابِهِ، وعُمْقَ مودَّتهِ، وسِرَّ اسْتمراره، وقد عَبرْنا يا إخوتي البراري الوعِرة، والمفاوزَ المهلِكة. أمَّا تلك المهامهُ الشَّاقَّة فسوف تجتازونَها على عقباتنا المضْنية، بعْد أنْ تتخطَّفنَاَ سِهَام الأقْدَار، فالجنوب الّذي يتلقّى بصدره البلاء والأرزاءَ، خليقٌ باسْتنزافنا واسْتبسالكم. وإذا سألتموني عن أجمل مُنايَ فَأُجيب: هي أن تبْقَوْا صوتَنا المدوِّي وهُيامنا الفائق!».
«ففي كؤوسِكُم المترَعَةِ سَكَبْتُ عُصارَةَ يَراعي ومهارةَ انْدِفاعي، وعلى دُروبِكم الموبوءة بالجاحِدينَ والمارِقين، أسهَرُ عليكم حارِسًا وأدافِعُ عنكم فارِسًا، لأنَّكم حملةُ رايتي وكَتَبَةُ روايتي. والحقَّ أقولُ لكم: «لأجلِكُم أحيا وبِكم أبقى»، فلا غَرْوَ إذا اختَرْتُكُم رِفاقَ جهادي وأُمناءَ حقيقتي، لأنَّني «أُريدُ أنْ أؤسِّسَ جيلًا يحْملُ البُنْدُقِيَّة بعْد اسْتشْهادي».
ثمَّ يَمَّمَ وَجْهَهُ شَطْرَ الجَنُوُب، شاخِصَ البَصَر، وعَيْنَاه تَبُوحانِ بِوَجْدِهِ الشَّدِيد، وغِبْطَتِه الدَّفِينَة، كأنَّه شاهد الشّهيد أحْمد قصير، يُحلِّق في مَعاليه، مخَضُوبَ الجَنَاحَيْن، فوق بلْدتِه «ديْر قانون النّهر»، ثمّ حَنى رأسَه، وأثْنى قامته أمام تلك الأخْيلةِ الطَّارئة، اسْتدار بعْدها نحو الفوْج مُخاطبًا:
«إنَّ هذا اليْوم المتْخَمَ بالعَجائب والغرائب، هو أجْملُ أيّامي وأيامكم.
إنَّه المرآةُ الّتي يرى لبنانُ فيها مقامَهُ كما ينبغي أن يكونَ.
لأنَّه الحدثُ الأغرُّ في العصْر الأنْور.
احْتفظَ بصورة بَطَلهِ، وصفَاقَة أشْلائه.
له تسْجدُ جميعُ الأيَّام.
ومنه تستمدُّ الحياةُ جَدَارتها وقدْرتها.
وهو أيضًا، خالٌ يزيِّنُ وجْنةَ الزَّمن.
تحوَّلتْ دقائقُه إلى سِنينَ غاضبة.
وساعاتُه إلى دهُور عاصفة.
توالدتْ في فلَكهِ الشُّهُبُ والنَّيازِكُ.
وتوارتْ خلْف ضبابه الرُّكْبان.
حَمَلَ أثيرُه أصْواتَ الرَّصاص الرَّافض.
فوق مواكب الأمواج الثّائرة، والأمم السَّائرة.
به تبدَّلتْ مقاييسُ الهزيمة، ومكاييل النَّصْر.
لأنَّ الفجْر الّذي تلاهُ قهَرَ الظَّلام الأبَديَّ.
فإذا بالنّور يزحَفُ، كالجحافل فوق الجبال.
والثّعابين تَنْتَحِرُ خائِفة في أوكارها.
أمّا الذِّئاب المفترسة، فقدْ هُرِعَتْ جائعة جازِعة.
فالرَّاعي المتيقِّظ يتَلفَّتُ كالبَرْق يَمنةً ويَسْرة.
يراقِبُ المراعي والفِجاجَ بألْفِ عيْن.
وحولَه صِحابُه البُسَلاء، ينْشرون الرُّعب في النُّفوس الحاقدة.
ودموعه تذوب صلاةَ شكرٍ على المفارِقِ والمعابرِ.
بيْد أنَّ عَصاه الغليظةَ، تشُقُّ الصّخور، وتهْدمُ القصور.
أمّا صوْتُه الرَّاعبُ، فقد اخترق مجاهلَ الغاباتِ.
وأرْهبَ زئيرُهُ العنيف نمُورَها وأسُودَها».
ورَفَع أحَدُ الكشَّافة يده، مسْتأْذنًا ثُمَّ قالَ متسائِلًا:
«إنَّ الأمم العظيمة، تُكرِّمُ أبطالَها في حياتهم قبل مماتهم، فأَرى أنْ نَبْنيَ تِمثالًا لذلك الشَّهيد العميد، وسَطَ المدينة ليُصبح مَزارًا، يحدِّث الأجْيال عن بطولات الشّبيبة المؤمنة، في ساحاتِ
الشّرف والوطنيّة، فإذا فاتنا تكْريمُ اللّيْث العامليّ، عندما كان ناطقًا بيْن أحْضان الحياة، فلِمَ لا نُعلِنُ مَجدَه وهو صامتٌ وراء حجاب الموت؟». فضحك الشّيخ عِماد ضحكَ المنتصرين، ثمَّ قال بصْوتٍ تجمْع نَبَرَاتُه اليقينَ الطّافحَ، والحماسة الرَّاعِدةَ:
«إنَّ راعي الأمَّة الهُمام رابضٌ على الثّغور.
لقد تداركَ جوعَ القطيع وعَطشَه.
إنَّ حاملي كنوزِه، ووارثي خزائنه، على موْعِدٍ مع فجْر آخَر.
ها هم حُرَّاسُ الوطن وحُجَّابه، يقْتاتونَ بأَثْماره اليانعة.
ويرْوُون غليلَهم من ينابيعه المنسابة بيْن السُّفوح والتِّلال.
وروحه المولَعةُ بالإنْفاق المطْلق، تكادُ تبلُغُ نهايةَ رحْلَتها.
فالقدْسُ الفَخورَةُ بِشَجاعَتِه، تتمنّعُ على جلاَّديها وسجَّانيها وتُجدِّفُ على أسْمائهم.
وهَضَبة الجوْلان تَشتمُّ رائحةَ الياسَمين الدِّمَشْقيّ.
ونهرُ الوزَّاني المتمرِّد يرقصُ جَذِلًا بَيْنَ ضِفَّتيْه.
والعِمامةُ السَّوداء تخفْر السّواحل وتُخيف أبناء القِردة والخنازير.
إنّ الراعي الشَّاب يغتبطُ معنا بزِفافه السَّماوي.
وعرائِسُ الحُور العِين تُمْطرهُ بقبُلاتِها على الأرائك.
لقد تحوَّلتْ ابْتسامتُه الأبيّة إلى شَجرة سِنديان.
تُظلِّلُ مقاوِمًا وجَدْولًا وزهْرة خضراء.
أمَّا شبَّابتُه الحزينة، فقد اسْتودعَها أيّارُ أنْفاسَه الدّافقة، وبَثَّ منْها أناشيدَه الخالدة».
ووقَفَ كشَّافٌ آخر قائلًا:
«أنتَ سمْتُنا الناطق يا شيْخ عِماد، وصمتُنا الرَّائق، فاذا ما غيَّبَتْكَ صروفُ الحِدْثانِ عنَّا، فمنْ غيرُك يفسِّر أحْلامنا، ويلُمُّ شعْثنا ويُثيرُ غمائمنا الرَّاقِدة؟»، فأجابه والثّقة تملأ نَبَرات صوْته، فتزيدُه حلاوةً وجاذبَّيةً:
«أنا حيّ في كلّ عِرْق يفورُ بالدِّماء الزّكيَّة، وحاضر في كلّ باع مُقاوم وإنْ غيّبني الموت وراء الغَسق الأزْرق.
بل إنَّ صدورَكم الّتي تبْتلع الرَّصاص، وتقْتلِع العارَ، لهِي المفسِّر الحقيقيُّ لأحْلامكم وهواجِسكم.
إنّ مُقاومتنا للشّرِّ المطْلَق، ذرْوةُ أمجادنا العظيمة.
فوْقَ شواطئها تطهَّرْنا من دَنسِ العُبوديَّة.
وعلى سُفوحها صَعدنا لنُلاقي النُّور البهيّ.
ومن لا يتطهَّر بالكرم والإيثار، يبقى مُنْتِنًا إلى آخر الدّهور.
ومنْ يصرفْ عينيْه عن القِمم، يَندثرْ بيْن ظلُمات المغاوِر، وبداءة الأغْوار.
أنتم أيَّها الرِّفاق تعيشون ألْفَ عام إذا شئتم.
وتموتون كلَّ هنيْهة، إذا أردتم أو استطالتْ بكُم إعاقةُ الشَّطْط، ولَوْثةُ الطَّمع، وسقْطةُ الارْتهان.
كونوا توْقًا متوقِّدًا إلى الغد، وسَاقيَةً مترنِّمَةً أمامَ اللاَّنِهاية، وسِراجًا منيرًا لا تُطْفِئُه الأنْواء.
أنتم غرَسات حقل آخر تعهَّده القَدَرُ بعنايته.
فلا تمرحوا في الفَراغ، ولا تسْرحوا في فضاءٍ آخر، غير الفضاء الموعود بحفيفِ أجْنحتِكم.
اطْرحوا شباكَكم في بحر الظّلُمات، هناك سوف تنقذون آلاف الأسْماك من الانقضاض والانْقراض.
أنتم حافظو المصائر، وصائنو الحقوق.
لأنّكم تبْذرون وتحرُثون، لتملأوا أهْراء الأرْض حَبًّا طَهورًا، وحُبًّا شَكُورًا.
وكلّما بكَتِ الفصولُ في عيونكم، وابْتسمتْ في ثغوركم، يعُمُّ خِصْبُها وتضُوع طُيوبها.
ولا تناموا إلّا بعيْن واحدة، أمَّا العيْن الأخْرى فهي ترقبُ الفَضاءَ المـُدْلَهِمَّ، وتنتظرُ الصّباحَ السَّافر، ورموشها مرتعشةٌ أبدًا مع الرِّيح الشّمالية.
اِبسِطُوا أيْديَكم، واحملوا أمتعتكم، فالسَّفر إلى البلاد النّائية قد حانَ.
وآن الأوانُ أنْ تسْبقوا النّكْبةَ الكُبْرى والهزائم العظمى على صهوات جيادكم».
وسكتَ الشّيخ عِماد، ماسحًا عرَقَ جبينه براحته، وأرْسل بصرَه إلى الأفق الموَشَّح بالغيوم الدَّكْناء، كمنْ يفتِّش بيْن ذرَّاته عن معانٍ مفقودةٍ، ثمّ ألْقى بِنظره على الفِتْية سائلًا:
«هل اتَّسعَت اليوم حنايا سرائرِكم، وثنايا مطامحكم؟
أما عثرْتم فيها على أشواق وأبواق لم تَعْهدوها من قبْلُ؟».
فوقفَ أحَد الفِتْيان هاتفًا: «أجَلْ يا سيّدي، لقد طرَقتْ آذانَنا عُذوبتُك فطرِبْنَا بما لم نسمعْه في ماضي عهْدنا وفتحتْ عيوننَا محبَّتُك فرأينْا أدْنى الأشْياء إلى قلوبنا، وأقْرَبها إلى الله».
ثمّ أضاف قائلًا بإلحاح وإصْرار كبيريْن:
«ولكنْ أيّها الشّيخ اللّطيف العفيف بحقّنا عليك بل بحقّك علينا، هلاّ علَّمْتنا نشيدًا نصْدحُ به في أذان الإصْباح كلّما أيقظَنا النُّورُ ودعانا إلى ملاقاة النَّهار؟».
فاهْتزَّ الشّيخ طرَبًا وقال:
«ها قد ودّعت الشّمسُ السّهولَ والجبال.
وغطَستْ وراءَ الأفُقِ الرَّحيب.
واكتسَحَ اللّيْلُ ربوعَ بِلادي.
وخرجَ قُطَّاع الطُّرقُ الطّامعين مِن أوجِرَتِهم.
بين أشْباح العَتْمة يتسَلَّلُ اللّصوص الأشْقياء.
إلى حقول الجنوب الخالية، وقُراه المنكوبة.
يزْرعون الألْغام على دروب الطيِّبين.
ويقتلعون بقساوتهم العمياء شتَلاتِ التَّبْغ الرَّافِلة.
ها أنذا أسْمع أنينَ المعذَّبين، أيُّها الرِّفاق الأقْوياء.
وأرى في أعماقكم الّتي لا تَضيق، غيْرة لا تضيع.
هلُمَّ إلى مصارع الكرام ومُقارعةِ اللِّئام.
لقد ملَلْنا الانتظارَ في الظِّلال.
وسئمْنا الحياة بلا طِعان ونِزال.
هيّا إلى معارج النُّفوس الكريمة.
نُخاطِب الزَّمان ونرْصدُ المكان.
ونخْطب الحرِّيّة الكئيبة، بهذا النّشيد الجَسوُر الجميل:
سلام على أهْلنا في الجنوب.
على كلّ جُرْح بليغٍ وقلْبٍ حزينٍ وغُصْنٍ كسير.
سنقْطعُ الحديدَ بالوريد.
ونقهرُ الغزْوةَ البَغْضاءَ، بالقطْرة الحمراء.
ونُسْقطُ يزيدًا، والظّلمَ واليهودَ.
ونثْأرُ لطالب الحقيقةِ السَّجين.
لطفْلةٍ مُمزّقة، وقِبْلةٍ مُحَرَّقة.
وصِبْيةٍ قدْ قُطِّعُوا وأُحْرِقُوا في العَراء.
سننْزعُ الرَّصاصة الخبيثةَ الآثِمةَ.
منْ رأسِ فلاَّحٍ علَى مَرأَى بِذَاره.
ونَطْردُ الدُّخان، والرُّعْبَ والْهَوان.
ونَسحَقُ الْهَزيمةَ المحصَّنة فوْق الجبالْ.
فيا غَدي، يا مَعْقِلَ الجَنوبِ المـُعَذَّب.
سأوافيكَ مع حبيبتي البنْدقيَّة.
وساعدي يمُدُّني بَعزْمه وحُبِّهِ.
سأَعْبُر فوْقه إليكَ، وأتدفَّق عليكَ.
فارسًا مدجَّجًا وفاتحًا مُضَرَّجًا.
سأُنْقِذُ السَّلام وأنْصُر الإِسْلام.
وتغمر محبَّتي الأنام».
ظلَّ قائد الفوْج يتمدَّد مع إنْشاده، ويتأوَّدُ مع ترْداده، اسْتحسانًا واسْتئْناسًا، ورفاقُه الكشَّافةُ الملْتئمون أمام خيامهم يتمايلون كأفْنان دوْحة باسقة، تجْمعُها الرِّيحُ ثمَّ تفَرِّقُها، هاتفين بالكلمات الملتْهبة، مُتماوجين مع المعاني الجامحة، حتَّى إذا بلغَتْ مُتعةُ الإنْشاد، حدودَ الإنْشَاء والارْتقاء، خلَدوا إلى الصَّمْت كلَلًا لا مللًا، وبعْد أنْ حَبَس التَّعبُ أنْفاسَهم بُرْهة قصيرة، وقبْلَ عودتهم إلى بيوتهم مكلَّلين بالحبور، هتفتْ حناجرُهم القويَّة: «تحيا المقاومةُ الإسلاميّة إلى الأبد، وعاش قائدُنا الشّيخ عِماد أملًا لها، وحاميًا للوطن وذُخرًا نفيسًا لأُمَّتنا العظْمى».
بوارِقُ وبيارِق
في حَوْمَتِهِ الجَامِعَة وحَمْلَتِه الواسِعَة، وهو حائرٌ بين ما تطلُبُهُ الرُّوح ومَا يستَطِيعُهُ الجَسَد، اسْتشَفَّ الشّابُّ الورِعُ عِماد حيْدر التَّقصير المشينَ في أَدائِه الرِّساليّ، واتّهم نفْسَه بالغُبْن الفاضح؛ فالعدوّ الّذي اغتصبَ الجنوب وهجّر قاطنيه، واعْتقل مُناوئيه، وهدَّم المنازلَ وحرَقَ البساتين، هذا الكابُوس الثّقيل بلِ الوحْش المفْترس الرّابضُ على صدْر الوطن المسحوق، ذاكَ الطّاغيةُ الّذي ملَّكه المسْتعمِرون أرْض فلسطين، وعاضَدوه في إطْفاء الثّورات المشتعلة، وسَفْك الدِّماء الفائرة وتحطيم النّفوس والرّؤوس، ذلك العدوان الشّنيع الّذي ابتُليتْ به شعوبنا المستضعَفة، ما كان ليستشري أورامًا خبيثة في الجَسد العربي المنخور، لولا تخاذُلُ ولاة أمورنا المـُطْلَق وصمْت الحكومات المطبِق، وقد رأى بفَراسة المؤْمن النَجيب، أنّ المقاومة الإسلاميّة الّتي نذَرتْ دمَ شبابها لسِقاية شجرة الحرّية المحطَّمة الأغْصان، هي البَصيصُ الّذي اخترقَ حُجُبَ هذه الأمّة الثّكْلى الممحَّصة بِالبَلايا، الممرَّغة بالتُّراب، وعايَن في قَوَافِلِها بَيارقَ النّصر تلوحُ مع أنْوار الفجْر
البازغ على جنوب لبنان وبقاعه الغربيّ.
إنَّ المؤمن العاقلَ لا يَقدِرُ أنْ ينفصلَ عن ضوابط دينه ومُقْتضيات إيمانه، والعزّة الّتي تنمو في الصّدور مع المشاعر والغرائز، وتتغذّى من أنفاس الأمومة الفاضلة وعَرَق الأبوّة الشَّرِيفة، جديرة بالرّسوخ والازْدهار، فالنفْس الّتي لا تملك عِقالَها تعْجَز عن حماية مكاسِبها وصِيانة موازينها.
انْتفضَ قلْبُ الشّيخ عِماد انتِفاضةَ عُصفورٍ بلَّلَه المطرُ، وحملَ هواجسَه اللَّجوجةَ، ورغْبتَه الجامحة إلى مَواقع الدِّفاع المستَعرِة، عارضًا ما يملك من دماء ووَفاء، علَّه يستطيعُ أنْ يدْفعَ بعْض ذلك البَلاء الجسيم، ولم يَجِدِ القادَة الميدانيّون مندوحةً عن إجابته إلى مطلبه الأمثل، وهَدفِه الأفْضل، فانْتَظم الشّيخ الغيور في رِكاب الظّاعِنين إلى مرابِعِ الخُلودِ، مُرابطًا يُتابعُ الدَّورات التدْريبيّة العسْكريّة والمهنيّة فتمكّن خِلال أشْهُرٍ قَليلة، من اكتساب أقْصى درَجات الخِبْرة في تضْميد الجِراح، والإسعاف الأوّليّ، وسلاح الهنْدسة.
وبلغ به إصرارُهُ وَوَلَعُهُ شفيرَ الخطر والكَدَرِ، فانطلق كالسَّهْم المصوَّب بِدقَّةٍ وشِدَّة، مُنْقضًّا على مواقع العُملاء،
ودُشَمِ الدُّخَلاء، النَّافِثةِ أحقادها على الدّاني والقاصي، المتسلِّطَة على القُرى الجنوبيّة الخائرة، تحت وطْأَة القصْفِ الغادر، والاحْتلال الغاشِم.
عِبَرٌ وعبَرَات
إنَّ كأْسا واحدة لا تتّسع لماء بحيرة واسعة، وخطوة صغيرة لا تجتاز سهلًا شاسع الأبْعاد، وإنَّ سلَّة مهْما كانت قويّة الحبْك، شديدة التّماسُك، يستحيلُ عليها احْتواء أعناب الكروم وأثمار البساتين.
لم يَقْوَ جسدُ الشّيخ عماد، مع رشاقته وليَاقته، على حَمْلِ أعْباء الرّوح الراضية المرْضيّة، المتغلْغِلة في جوارحه، المحلّقة بألف جناح فوق الجنوب السّليب، فالصَّبر على المرارة في شرعه ليس قبولَ الإهانة، ومضغَ الحنظل، والرِّضا بما تخبِّئه صروفُ الدّهر من صِعاب وأرزاء ومكاره، ولا انتظارَ الفرَج على فراش وثير أو تحت ظلٍّ ظليل، فمقارعةُ المعْتدين على التُّربة المسروقة وأمام الأنْفُس المزهوقة، وردعُ أولئك القراصنة العابثين بأمنِ الجنوبيّين ومُسْتقبلِهم، القابضين على أعْناقهِم بمخالبَ خانقة، بلْ إنَّ دحْر هذه الهجْمة البرْبريَّة التّعسّفيّة، لَهو الصّبر الجميل والرّباط الحكيم، بلْ هو عيْن الحقيقة، ومحجّة الصّواب والسّداد.
وبقدْر ما فاض قلب «السّيّد رضا» وهو الاسم الجهاديّ للشّيخ، بالوَلاء لوطنه المسحوق ومواطنيه المستضعفين، اكتظّ صدره بالحقْد والضّغينة، على أولئك الأشْرار، الّذين سوَّلتْ لهم وساوسُهم التّوراتيّة وشياطينُهم المادّيّة، اغْتصابَ أراضي الضّعفاء، والهيْمنة على أقوات النّاس، ومصائر العباد، فلم يهدأْ له بال، حتَّى بيْن أفراد أُسْرته أو في مقامات التأمّل والعبادة، كما أنّه لم يهنأْ بنومٍ وطعام، أو يستمتعْ براحة، وأُذُناه تستقْبلان يوْميًا، دويَّ الطّائرات المـُغيرة على العُزّل والأبرياء، في طول الشّريط الحدودي وعَرْضه، وأخبارَ النّاس الحَيارى، وما يتعرَّضون له من ذُلّ مَقيت، وأذًى مُميت، ولطالما تساءَل في خلَواته الشّخصيّة، وحلَقاته الجمَاعيّة:
«ماذا ارتكبْنا من ذنوب، وفعَلْنا من فواحش تؤذي أو تصيب هؤلاء الجُناة؟
هل سرقْنا أموالَهم أم قصَفْنا مدنيِّيهم؟
هل غصبْنا لهم أرْضًا أو دنَّسْنا لهم عِرْضًا؟
لِمَ يقيمون فينا المجازرَ الرّهيبة، ويسْلبون النّوم من عيوننا، ويحرقون زرْعنا، وينتهكون حُرُماتنا؟
بلْ لماذا يصطادوننا كعصافير البرّيَّة، نازعين منّا قهْرًا، ما للعصافير من حقّ في الحياة والحرّيّة؟!
كيف نردّ على هذه الجرائم البَكْماء، والقنابل العمياء؟!
هلْ بالبكاء على قتْلانا كالنّساء، والنّحيب على جرْحانا وأسْرانا كالأطفال؟!
أم باللّجوء إلى المظاهرات، والاحتجاج العقيم إلى هيئة الأمم؟ وقد اتّفقتْ تلك العصابة مع عدوّنا على إذْلالنا وقهْرنا وإفنائنا؟! هل نُقِرُّ بعجْزنا وضعفنا، فنكتفي بالصّمت الحزين، ونلوذ بالمساوَمة مع من سوَّفوا، ونتمنَّى الموت البائسَ مع مَن تمنّوْا، أو نسْتسلم كالجبناء والخائنين مع الّذين استسلموا وخانوا واستكانوا؟! أمْ نحمل على هؤلاء الشُّذّاذ حمْلة رجل واحد، تقتلعُ جذورَهم، وتمحو آثارهم، وتُبيد أوَّلهم وآخرهم، فنقْطع رأسَ الأفْعى، ويصبح العالم جنّة من الأمنْ والأمان، بعد أنْ جعلوه سعيرًا من المتفجرّات الهوْجاء، والحرائق البلْهاء الّتي تمزِّق الأجساد وتعذِّب الأرواح؟».
وفي ذات ليلةٍ حافلةٍ بالسُّكون والتأمُّل، وبينما كان «السّيّد رضا» أسيرَ هذه الأسئلة الصّارخة، والأجوبة الطّارئة، دخلَ عليه
رفيقُ دراسته، المجاهد «أبو حسن» ملْقيًا عليه السّلام، فردّ تحيّته بصوْت يَحزُّه الأسى، ويقطِّعه الأسف، فسأله والاسْتغراب يغْشى ملامحه: «متى كان التّشاؤم يلْتهم بِشْرَك ويحجبُ فرَحَك؟ بلْ أين تلك البسمة الّتي تلْمع كاللؤلؤة على وجهك الهادئ؟».
فشهق «السّيّد رضا» شهقة أليمة، أتْبعها بزفْرة مريرة، ساندًا بيمينه رأسه المنْحني انْحناء غصنٍ لوتْه العاصفة قائلًا:
«نحن نعيش يا أخي على فوَّهة بركان، ليس في بلدنا الجريح فقط، بل فيما حوله ومَنْ حولَه مِن عَربٍ مقْموعين، وعجَم مغبونين، وقد فار فوراتٍ قاتلة ماحقة، فأعْمى دخانُه العيون، ومزَّقتْ حممُه الأجْساد، فشرّد أبناء الدّيار، وحُماة المقدّسات، في الأصقاع البعيدة، فلا شقيق يؤازرهم، ولا صديق يؤاويهم.
ولم يكْتفِ العدُّو اللئيم بمن قتلَهمْ وسجنهم وحرمهم، بل دارتْ دورةُ عنصريّته واغْتصابه على منْ تبقّى من شعب فلسطين وأرْضها الكريمة، ناهبًا خيراتها مُضاعِفًا ويلاتها، مبدّدًا أجيالها الناقمة منه والحاقدة عليه، في المنافي القصيّة والمهاجر الغريبة المجهولة».
فقطّب «أبو حسن» جبينه، وانْسدَلتْ عليه غِلالةٌ دكناءْ، كأنّها سحابة شتاء كثيفة ثمّ خاطبه:
«أنت تغوص في لُبابِ القضايا، ولا تفوتك قشورُها الطّارئة، صحيحٌ أنّ تلك النّار الآذية الّتي تضطرم في فضائنا، وتنْدلعُ فوق خنادقنا، ستمتدُّ ألسنتُها الحارقة إلى البقاع النّائية، من كوكبنا المضطرب، وسوف تشوّهُ أوبِئتُها الفاتِكة وجْه المدنيّة المضيء، ولكنْ....
هلْ نهرب كالبلابل من هدير الطّائرات وجلَبة المدرَّعات، أمْ نثبت في ربوعنا كالجبال الرّاسخة، غير عابئين بعديد الأعداء وعُدَّتهم؟
هلْ نلجأ إلى التّواكل والتّواني مُردِّدين في أعماقنا: هذا ما شاءه الله لنا منذ الخليقة الأولى، أمْ نتصدَّى للقراصنة شارين النّصر بالدّم، والغلَبة بالتّضحية؟
إنّ قومَنا العرب، وأشِقّاءَنا المسلمين، يتجشَّمون اسْتبداد حُكَّامهم ويقاسون نفاق قادتهم، وسوف يتّخذوننا أُسْوةً حسنة وعِبرَةً جليَّة، بعد أن نفتح بالقرابين البشريّة النَّاضحة، معابر الجنوب المقفلة، وأبواب فلسطين الموصدة، باذلين إحساسَنا
وأنْفاسنا، ثمنا لكبريائنا الممْتَهن، وقدسنا السّليبة».
توقف «أبو حسن» عن الحديث ليرتاح هنيهة، فلم يمهلْه «السّيّد رضا» فأجابه بعد أن زادت كلماته الحوار اشتعالًا وانْتقالًا:
«أنا أقرأ على أُفْق المعركة، ما تراه عيناكَ الثّاقبتان، واستشْعرُ الخطَرَ المحْدِق بنا وبالعالم الواسع الجنبات، وها أنذا أحمل روحي على عاتقي، جائبًا الممَرّات الشّائكة والمسالك المربِكة، لأدفعَ قسْطي من الدَّيْن المتوجِّب على عُنقي، إلى موْطئ أقدام آبائي، ومثْوى جدودي، وأنت تعلم مدى ولائي لتلك المقَل الّتي تَرصدُ الأشقياء، غيرَ عابِئَةٍ بتسلّط الوسَن وتَقلُّب الزَّمَن، كما أَنّك تسبُرُ أغواري المفْعَمَة بمبايعة فوارس الهيجاء وأشاوس النّصر، ولطالما رفعْتُ عنوانًا لحياتي، ورمْزًا لمِماتي هذه العبارة الحكيمة:
«كتابكَ محْوَرُكَ، وقلَمُكَ بُنْدقيّتُكَ، ورصاصُك دمُكَ، فليس لنا منَاص من الانتشار والاقْتدار على الشّرّ المـُلِمّ بنا، وما للعدوّ مفرٌّ من الملاحم الطّارقة، والهزائم اللّاحقة، إنّ الظّلم عاقبته وخيمة، والظّالم حظوظه عديمة، فلا يسْلم إلّا المنطقُ السّويّ وصاحبُه، ولا يخيبُ إلاّ الخدّاعُ اللئيم وفاعلُه، إنَّ هذه الأرض
الطيّبة المقهورة، أنْبتتْ بيْن ينابيعها النَّميرة وحقولها الخصبة، رجالًا لا تُلْهيهم تجارة ولا بيْعٌ عنْ ذكْر الله.
لم نتقهْقرْ كالضّعفاء، ولنْ نُساومَ كالمنافقين، «فهيْهاتَ منّا الذِّلَّة، يأْبى الله لنا ذلك ورسولُه والمؤمنون».
وتضرَّجَ وجْهُ «أبو حسن» لينِمَّ عن سرور عميق، واطمئْنان وثيق، بما نثرَهُ «السّيّد رضا» من فمِه المعطّر، ثمّ أشار إليه براحة يده، طالبًا بدوْره التحليل والتعليل في دوّامة الأمور الشّائكة، قائلًا:
«أيّها الحبيب المتوَّج بالتّقوى، المدجَّج بالإيمان، المسْتسلِم لخالقه، البارُّ بأهْله وقوْمه.
أنت رجل عِلْم وعرفان تعشقُ المتصوِّفين، وتغوصُ في ألبابهم، وتدرس طرائقهم، لقد عبَّرْتَ لي مِرارًا عن ذوَبانك في قدوتك المثْلى صدْر المتألّهين الشّيرازي، كما جذبَتْكَ علاقة الإمام الخمينيّ بالله، الّتي لاحتْ كخطوط الفجْر الأُولى، خيوطًا نورانيّة أحاطَت هالةً جاذِبَة بهذا السّيّد الغالب، فهابَه الخلْق طُرًّا، وعلِقتْ به قلوبُ المؤمنين، فكان قَرْمَ الحقّ، وقرنَ العدل، وفيْصلَ الحُكْم، وعَلَمَ الإِيمان، ونِبْراسَ الزّمان، وأنت
القائل أيّها الأخ الحبيب «أريد أنْ أؤسِّسَ جيلًا يحْملُ البنْدقية بعْد اسْتشهادي» وزوّدْتَ بهذه المقولة فوْجَ الكشّاف أفرادًا وجماعات، والّتي ما زالت ترنُّ كالأجْراس النُّحاسيّة في أسْماعهم.
لقد عايشتُك سنوات طويلة، مملوءة باللّذّة والأُنْس، اللَّذَين يزرعهما الله في قلبَيْن متحابَّيْن، وعايَنْتُ توفيرَك بعض القروش من معاشِك الزَّهيد، الّذي تُسْعفِكَ به إدارة الحوْزة، لتسدَّ رمَقَكَ، وتؤمِّن اليسير من حاجاتك، واسْتطعتَ أنْ تجمع بعض إخوانك، مُكْرمًا مضيفًا، في سهْرة شاي أو حفلة حلوى، مُنْفقًا عليهم ممّا تبقّى في يدك السّخيّة، وإذا ما علِقَ بها قرْش أخير، كنت تدفعه ثمنًا لكتاب تتَّخذُه رفيقًا جديدًا، في رحلتك العصيبة الكأداء.
أنت قريب إلى القلوب يا «سيّد رضا»، فما حدَّثْت امْرءًا قطُّ إلّا ووهبكَ ثقته، واغْتبط بما تعلِنُه، واطمأنَّ إلى ما تُسِرُّه، فما أراه ملاصقًا لشخصيّتك العرفانيّة، وموافقًا لشبابك، الزّاهد فيما يزول، الرّاغب فيما يبقى، من غنائم الدُّنيا ومَكاسِبِها، هو أن تقتفي خطوات الواعظين، وتسخِّر منْبرَك منْفذًا إلى عقول القوْم، والمحراب ذريعة إلى هدايتهم، وما أنصحك به، وأنت الصّديق الصَّدوق الّذي أمْحضُه الودَّ، أنْ تتبوَّأَ إمامة مسْجد
قريتك المحرومة من عالم يجمع شتاتها، ويوحِّد صفوف أبنائها، ويعلِّم أجيالها دروسَ أئمّتنا الهادين وأعلامنا النّابهين، ويجعلهم رفْدًا لا يغيض للجنوب المنْهَك، ومددًا لا ينفذ للوطن المهْمَل، وسَنَدًا قويًّا للدِّين الحنيف».
فظهرتْ أَماراتُ الحنَق والاستياء على ملامح «السّيّد رضا» وكأنَّه تأذَّى بما حبَاهُ به أخوه من نصائح، لمْ تلْقَ عنده صدْرًا مفتوحًا، ولا عُذرًا مقبولًا، وبلهْجة حازمة هي أقْرب إلى اللَّوْم والتَّلقين منه إلى الإفْصاح عمّا يجول في الخاطر أجابه:
«إنَّ آثرَ الهوايات عندي ركوبُ الأهوال، وكثْرة التَّرحال، وريادة الأدْغال، أمّا الاشتباك مع الغازين، ومقارعة المعتدين، فهو أمْتع وأشهى ما خلقه الله من زينة وطيِّبات، وأمّا الموت في سبيل الحقّ، فإنَّه سعادتي الكبْرى ونعيمي المقيم، «فوالله لا أرى الموت إلّا سعادة والحياة مع الظّالمين إلاّ بَرَما».
نَعمْ، لقد أدَّبتُ أشْبال الكشَّاف بأدَب البندقيَّة، وعبّأْتهُم بالاستمتاع بالكرّ والمناورة، في حلَبة الظّفر المعجَّل والفوز المؤجَّل، وأوْعزْتُ إلى وجْدانهم، التَّهافُتَ على مُقارعة الغُزاة، وجها في وجه، وقبضةً في قبضة، ودعوتُ أهْلي وصحْبي وناسي،
إلى إعْداد العُدَّة، ورصِّ الصّفوف، والالتحاق بقامات الفداء، الّتي تموج كالسّنابل السّمراء في مرابعِ الجنوب المغمور بالأوجاع والأحزان، وحينما أطلقتُ دعوتي تلك، أهْرقتُ عليها دموعي وخُشوعي، دموعَ الغبْطة بالانْتصار المحتوم، وخشوعَ الارْتقاء بالشَّهادة المشرِّفة، كنتُ أدرِّبُ الصِّغار على مُداوَرة الشَّدائد، بجسدي وأطرافي فقط، أمَّا قلْبي الحاقد على القَتَلةِ الغُرباء، فقد أنْشأَ منذُ ذلك العهْد يتكوَّن كالسَّاحر على شكْل طائر غرِّيد، يسابق الصّقور ويهْوى العبور، واصِلًا فضاء جبيْل بأجْواء (بِئْر كَلاّب) وأشجار سُجُد وعرمتى، هلْ تظنّ يا «أبو حسن» أنَّك أكثر منّي شغفًا بالجهاد؟ أو أشدُّ رغْبة في لقاء الله؟ ألاَ تذكُر يا رفيقي، وأنت الذّاكر الذَّكيّ، يوم شاورْتَني في قيامك بزيارة إلى الإمام الرّضا أنّني قد نصحْتك بتأجيلها، وإبْدالها بزيارة سُوح الفِداء، وأردفْتُ مبيّنًا ما قاله الأمينُ العامّ: الجهاد خيرٌ من الحجّ إلى مكّة وغيرها من المقامات المكرّمة؟
ألاَ تعلَم يا أخي أنَّ روحي متيَّمة بجبل صافي ذلك التّنّين القويّ الواقف في وجْه الغزاة وقوف المارد أمام الأقزام؟ كَمْ أحِنُّ إلى ما يعكس فضاؤُه من بَدائع قِتالية وما يْطويه تُرابُه منْ عَرقٍ سيَّال، نضحتْ به هاماتُ نبلاء بني عامل وأجْوادهم،
أولئك السّمحاء القابضون على الزِّناد في المآزق والكمائن، دَرْءًا لانتشارِ الجراد الماحق أو تسلُّل الخفافيش الضّالّة!
هل تطلب مني أنْ أُزَوِّدَ النَّشءَ الصَّاعِدَ بالمسْتحسَن من الأفكار، والمسْتظْرَف من الاعْتبار، وتدعوني إلى امْتشاق كتابٍ بيَدٍ، وقلَمٍ بالأُخرى، مكْتفيًا بدوْر الواعِظ الوقور، والرّاعي الصّالح والأديب الأريب؟ وأنا، أنا العبْد المشْتاق إلى ربّه التوّاق إلى الانعتاق، أنا الطّالب ثأْرَ أمَّتي بدمي وتحرير وطني بدموعي!!
صحيح أنّ البُنْية الثقافية والعمْقَ التربويّ، هو أوَّلُ لَبِنة في حَصانة الرّوح الّتي تبارك الجسد، وأنّ روائع الفكر هي الّتي تلدُ بدائع الدَّم، ولكنَّ صِيانة الحدود، ورعاية الحُرمات تتمُّ وتكتمل بالسَّواعد النّقيّة والدّماء الزّكيّة الّتي تُزْهق الباطل وتوطّد الأمن وتنشر الوئام.
إنّ عدد الوُعَّاظ يا «أبو حسن» قد فاق عددَ الجنود، وصناعة البيان والبديع قد بزَّت صناعة الخبزْ والدّواء، أمَّا النّجيع الّذي يلوِّن أعلام الوطن، ويمنحه العُلَى والسُّؤدَدَ، والّذي يجعل الشّمس سِراجًا وهَّاجًا، والقمرَ مصْباحًا منيرًا، فهو معدن
إلهيّ نادر بل هو أكْرم دُرَرِ الأرْض، وأغْلى جواهرِ الوجود.
أُنْظرْ إلى قبْضتي القويّة، حدّقْ جيدًا في عضَلاتي المتشابكة المفعمة بالعزم والأمل والحياة، افتحْ صدري بنور بصِيرَتِكَ، وحطِّم أضْلاعي الّتي تحجُب قلْبي عن دَقائِق الأثير، ستعثر في شِغافه على البأْس الّذي لا يخور، والحبِّ الّذي لا يراوغ، والثّورة الّتي لا تهدأُ، والنّخْوة الّتي لا تضمحلّ».
عندما بلغتْ حرارة مشاعره هذا الغوْر، اغرورقتْ عيناه، واحمرَّتْ وجنتاه احْمرار غمائم الأصيل، المتلوّنة بأشعّة الشَّفق القِرمزيّة، وأطْبقَ فمَه ليمْنَع دموعَه عن اجْتياح لُعابه ولسانه، وانْفرجتْ شفتاه ثانيةً لتبثّ بهَمْسٍ شفَّاف عواطفه المتأجّجة، وشوقه الدّفين لأهْل الثّغور، بيْدَ أنّ لواعجَ «أبو حسن» لم تكُنْ أقلَّ غزارة وأضْيق مَسارًا، فقد انْثنَى على ركبتيْه ومدَّ ذراعيه القويّيْن، محتضنًا بوداد لا يوصف وحنان لم يُعْرَفْ المجاهد «السّيّد رضا» وتبلَّلت الوجنات من هنا وهنالك، وتضاعفت الحسَرات، وخفق القلبان المسْتهامان على إيقاع الألحان الجهاديّة الرتيبة.
واشتدّت حُمَيّا المشاعر، واتَّحدت الظّواهِرُ والبَواطن، وكان
الرّابحُ في عَرْض هذه المشاهد الملائِكيّة، واللّوْحات الصّوفيّة، المقاومة الإسلاميّة وفحولَها، وجبلَ صافي وصخورَه، أمَّا الخاسر في هذه النَّوبة، فهو العدّو الموعود بالهزيمة، المصعوق بقبَضات المقاومين الميامين، على الثّغور العامرة، وفي المرابض القاهِرة، وبين الأشجار المتشابكة، في ربوع الجنوب السَّليب الصّامد.
حُبٌّ وحياةٌ وموْت
إنَّ المرأة الفاضلة الجميلة، فقدَتْ توازنَها عَبْر العصور، عندما اسْتأْثر الرّجل بقوّة سلْطانه على عواطفها ومفاتنها، فهربتْ منه تارة إلى الحسْرة والاسْتسْلام، وطوْرًا إلى التربُّص والانتظار، وعندما نفَضَ عن عقله غُبار الجهالة، وطرَد من خياله شَبَح الأنانية، ومنَحها الحبَّ الّذي هو إكْسير الحياة، والولاء المحْضَ الّذي ينزع وحْشة أيّامها ويُبدِّد جَزَع لياليها، سعتْ إليه بكلّيّتها، باحثة في أعماقه عن مقامها الأعلى، ومقرِّها الأدْنى، الّذي أعدَّه الله لها، منذ خلق الذَّكر والأنْثى، وجعلَ المودَّة والرّحمة بينهما، الجامعةَ المثْلى والعُروةَ الوُثْقى.
تعرَّف المجاهد الفتيّ «السّيّد رضا»، على شابّة رزينة من قريته، استأثرتْ بعطْفِه ونالتْ إعْجابه، وبادلتْه الثّقة والقناعةَ والرِّضا.
خفقَ قلْباهما اليافعان بتلك الأحاسيس النّاعمة الشّبيهة بنسيْمات الفجر الأولى، تلك الأسْرار العميقة الآسرة الّتي تراودُ
الكيان لأوّل مرّة، فيغْتني بها جذِلًا، ناظرًا من ورائها إلى العالم مُسْتفسرًا باسْتئناس، مسْتطلعًا باكْتفاء، ولا يلتفتُ بعْدُ إلى الوراء، لأنَّ الحبّ هو مفتاحُ السّعادة والسّعادة هي المحجّة البيضاء.
وخطَبَ عروسته من أبيها، فرحَّب به صِهْرًا تقيًّا يحفظُ عِرْضَه ويصون ابنته، وضمَّه إلى أُسْرته كأحَد أَبنائه، وابْتسَمتِ الأَيَّام للخطيبيْن فشرَعا ينسجان من أحْلامهما أفكارًا جديدة، ومشاربَ نَضيدَة، تُطِلُّ كالضّباب من وراء حُجُبِ المستقْبل، ثمّ تتبدَّدُ بعْد أنْ تسطَع شمسُ الحاضر الرّاجف، وتنفُخَ رياحُ الأقْدار أنْفاسَها الضَّاربة في آفاق الزَّمَن.
ازْدانتْ مخيِّلةُ «السّيّد رضا» بِصُوَرِ حبيبته، وتكاثرَت زياراتهما المتبادلة المتَتالية، وراوح الحبُّ بيْن صدريْهما، متوهِّجا تتجاذبَهما قُواهُ الباطنيّة، الكامنةُ في جذور متينة، سليمَة النَّوايا، طريفة المزايا، وتآلفت روحاهُما المتوحِّدتان، فلا فرحَ هنا إلاَّ ويُقابلُه حُبور غامر هناك، ولا حزنٌ متْلفٌ داخل هذه الأحْشاء إلاّ وتُضارِعُه لهْفة لافتة عند تلك، كانا كائنيْن غريبيْن متباعدَيْن، فقرَّبتْهما بعناية، وجمعتْهما برفْق، تلك العواطفُ الفيّاضةُ الممْتعة الّتي نسمِّيها الحبّ، ذلك الشُّعاع الّذي يولدُ في الأفْئدة
ويستمرُّ فيها إلى آخر الحياة.
وذاتَ مساء، عاد المحاربُ الشّجاع إلى قريته، بعد أنْ روَّع بعبُوَاته رعاديدَ الصّهاينة، المخْتبئين كالفئران القذرة في شُقوق حُصونهم، وزوايا دُشَمهم، وهناك التقَى بوالديْه وإخْوته، استأذنَهم وهو على عَجلَة من أمْره، في الذّهاب إلى خطيبته، يسلِّم عليها، وعندما بلغتْ به قدماه باب دارها، طرقهُ ففتحتْ له، ووجهُها الصَّبيح يفيضُ بشْرًا ونضارة، قائلة: «تفضَّل يا أخي، أُدخلْ يا حبيبي».
قرَّت عيْنُ المجاهد العائد برؤية حوريّته الضّاحِكة، وانْحنى أمامَها كغصن غضّ راودته النّسائم، مقبِّلًا يديْها الفضّيَّتيْن، ماسحًا براحته جبينَها الوضّاح، فمسكتْ ساعِدَه كما يتمسَّك الغريقُ بخشبة النَّجاة، ودعَتْه إلى الاسْتراحة على الشّرفة المشْرفة على الشّاطئ، فجلسَ على سجّادة ناعمة أعدَّتْها له، ثانيًا رُكْبَتيْه، سابلًا ذراعيْه، كمَنْ يتأهّبُ للمُغادرة.
فأخذَتْها الغرابة وسألتْه والقلقُ يحرِّك شفتيْها: «ما وراءَك َيا «سيّد رضا»؟ هل أصابكَ مكْروه؟ أمْ أنّك مُتْعبٌ من وعْثاء السّفر؟ أترومُ الخلود إلى النّوم؟ أمْ أنَّ ما وراء الثّغور من
مشاغل ومفاجآت، تقْتفيكَ أيْنما توجَّهتَ، حتّى إلى فِراشك ومهْبط أحْلامك؟».
أجابها باقْتضاب غريب لمْ تألفْه من قبلُ: «أجَلْ يا حبيبتي، في هذه الأيّام الحُبْلى بما تكْره الأيّام، في هذه السّاعات البطيئة المرور، وبيْن لحظاتها الّتي أحْسبُها أعوامًا طِوالًا، تتوافدُ أصْوات رفاقي إلى مسامعي من بين الأنقاض، مشْفوعةً بأزيز الرّصاص، وجلَبة الوَغى، مستنْجدين مسْتغيثين، حِرْصًا على إنقاذ الوطن السّجين لا خوفًا من السّجَّان الظّالم».
فسألتْه والحيْرة تسْلبها متْعةَ اللِّقاء: «كيف تستطيع سَماع الأصْداء النّائية، وهلْ بلغتْ بك الشّهامة والحميّة اتّهام نفْسك البريئة، وتأنيبَ ضميركَ المطْمئنّ؟». أجابها بصوت واثق كأنّه نغْمة نايٍ شجيَّة: «لقد حَمِيَ وطيسُ المعركة في هذه اللّيالي، بين جُنْد الرَّحمان وعَبَدةِ الشَّيطان، وأزْهَقْنا منهم الكثير، وأنزلْنا الرُّعب في قلوبهم، والهزيمة في صفوفهم، فتركوا أشْلاءَهم الممزَّقة طعامًا للجوارح، وقد لاحظْنا وصولَ مزيد من الذّخائر والعتاد، من قيادتهم لملْأ الفراغ، ورأْبِ الصَّدع في خلاياهم المحطَّمة، ثمَّ غادرتُ الجبهة اليوم، والقصْف المتَبادلُ يُشْعل الشَّجرَ والحجَر، ودُخان الحرائق
المضطرمة، يحجب نور الشّمس عن المتحاربين؛ ففي الوقت الّذي أنتشي فرحًا بكفَّتنا الرّاجحة، وفلولِهم الهاربة، أكادُ أسْقطُ أسيرَ القَلقَ، لِتألُّبهم علينا، وتكالُبهم وانتشارهم بين تلك المنْحدرات كالذّئاب الجائعة، يرومون افْتراس المقاومين الشّرفاء، وتمزيقَهم إِرْبًا إِرْبًا، انْتقامًا لِما فقدوه من أراوح وآليّات».
وسألتْه غيرَ مقْتنعة بصحّة افْتراضه وشدّة اضْطرابه: «أَلا يوجد شبابٌ مخْلصون من أمثالك، يؤدّون دوْرهم في الذَّوْد عن كرامة الجنوب المنْتهكة؟
إنّ محافظات لبنان الخمسة تزْدان بشبابها الأقْوياء، ورجالها الكُرماء، فلماذا يتلبَّس خطابَك الخوْف، ولا يفارق ذهْنك الحذَرُ، على إخْوتك ورفاقك الكادحين، من صلافة العدوّ وبطْشه؟».
فردّ عليها، والحكْمة تنْبُع من شفتيْه: «إنّ رهطًا حاشدًا من اللّبنانيين، لا يضعُه الصَّهاينة في خانة المعارضين لاحتلالهم، بلْ يفترضونه من الموالين والمؤازرين، ويتلقّوْن منه المناصرة والمعاضَدة.
إنّهم نوْع غريبٌ من البشر، الّذين لا يُراعون حقوق وطن،
أوْ وصايا دِين، أوْ أواصِرَ قوميّة، وعندما يدقّ الواجب المقدّسُ ناقوسَ الخطَر، وتفتحُ الحرْبُ أبوابَها، وينادي الفُرقاء أشْياعَهم، يُشيحون بأبصارهم عن المشاهد الدَّمويّة، ويسدّون آذانَهم بكُتَل حديديّة، وأنوفَهم بِقِطَع قطنيّة، حتّى لا يؤْذي عواطفهم النّجيعُ المتجمّد، ولا ينغِّصُ عيْشَهم أنينُ الجرْحى، ولا تُفْسدُ موائدَهم روائحُ الجُثَث المنْتِنة.
إنّ عبيدَ الرَّفاه والمال، لا قِيَم لهم... ولا أمَلَ منهم، فهمْ أجْسام هَشَّة وأرواح مريضة، تلوثتْ بأوحالِ المدنيَّةِ، وكلِفتْ بها، حتّى الخَبال، وهي تركُض على الرّغم منها، وكآلهتها العمياء، خلْفَ العناء والشَّقاء».
فقاطعتْه خطيبتُه، والواقع الأليم يحزُّ في نفْسها:
«ولكنَّكَ يا سيِّدي، انتسبْتَ إلى المقاومة بالرّوح قبل الجسَد، وحملْتَ أعْباءها الثِّقال، طَوال سَنوات مشحونة بالمتاعب، مسْبوقة بالتّعبئة، مشفوعةٍ بالابتلاء، أَفَلا يحقُّ لمحارب قدير قمينٍ من طِرازك، أنْ يُضمِّد جراحَه المشهودة، ويسترْجع أنْفاسَه المفْقودة، ويستعيدَ توازنَه المطلوب، ثُمَّ يرْجع إلى ميْدان العِراك العتيد، برغْبة أشدّ وهِمَّة أقْوى، وعِنادٍ أرْوع؟».
لمْ يَسْتَسِغْ المقاومُ الجَلُود مَرامَ خطيبته ومبرِّراتها الواهية، فانْتصب على ساقيْه، جائلًا طَرْفه في أفُق الجنوب الممتلئ بالصُّداع والصُّراخِ والحسراتِ، وبَدا بهامته المرفوعة، ووقاره المهيب، كعمود من النّور، ماثل بيْن الأرض واللّانهاية، فأجابها وصوته الجهْوري يتماوجُ ثقةً بالنّفْس وحنوًّا عليْها:
«لم أشِخْ يا حبيبتي بعْدُ فأتقاعد كالعجائز، أو أُلازِمَ الفِراش والنَّقاهة كالمعتلِّين، ولم يهدّ النَّصَبُ عزيمتي فاسْتسلم للكسل المميت والفَراغ المـَقيت، إنَّ الجهادَ بابٌ من أبواب الجنّة، والجنوب باب الجهاد والجنان، المفتوح على مصراعيْه؛ إنّ الجنوب الرَّازح تحت أوْجاعه، والمثخَنَ المكبَّل، العالق بين فكَّيْ الإهْمال السياسيّ، ومخالب الافْتراس الصُّهيونيّ، والمبتلى بمباضع العنْصريّة الطّائفيّة المسوِّسة، يصْرخ متظلّمًا ولا من يسمع، ويتقلَّب مريضًا ولا من معالج، وينادي واعظًا ولا من مجيب، ويدافع مستميتًا عن المحاسن الطّبيعيّة والكمالات الروحيّة، ولا من مناصر، فماذا تنصحينني أنْ أفْعَل يا أمَةَ الله؟
هل أُديرُ له ظهْري، وأقدِّم عذري في لياليه المظلمة، الّتي لا تعْبأُ بالأقوال، ولا تقبل الأعْذار؟
أمْ أتلَهّى عنه بَبَهرجَة المرئيّات ومفاتن المخلوقات، والحياة الّتي لا تكترثُ بالمرْضى والضّعفاء، لم تعُدْ تحسبُه من أبنْائها.
أمْ أنْزحُ إلى بلادٍ نائية، لاهثًا وراء المباهج والمنافع؟ والهجرةُ إلى سفوحِ «سُجد» و«عرمتى»، هو أهمّ الأسْفار وأمتعها، والنّزوح إلى جبل «بو ركاب»، هو أجْمل أُمنيّات الشّباب المؤمن الحيّ وأنبلُ مَطالبه.
لقد تعبَ جَسَدي من حمْل روحي المثقلة بأثمارها، إنّ في أعماقي توْقًا غامرًا إلى تضحية مجرَّدة من العناصر الفاسدة، تبقى محفوظة كالكنوز، ناصعة كالثّلوج في ذاكرة الزّمن.
أريد أن أدورَ حول نفسي وفوْق الجنوب أربعًا وعشرين مرّة في اليوم مشْرقًا عليه بكلّ ما في خلجاتي من الوَلعِ والانعطافِ والإيثار.
أُحبُّ أنْ أُبارِك مساعيَ المجاهدين وأواسيهم بما ينْبجس في خَلَدِي، من نُسيْمات العِشْق الإلهيّ المتيّم بفوّهات بنادقهم، وآثار أقْدامهم.
أتمنّى أنْ أنالَ الشّهادة بكلّ ما فيها من حلاوة وآلام، أَوَدُّ أنْ أعانق جذْعَ زيتونةٍ مقطوعةٍ، مُضَرَّجًا، صاعدًا إلى الله، مع حفْنة
من تراب الجنوب، وورقة من تَبْغه، وثمرة من برتقاله».
بعدما عاينَت الخطيبةُ العاشقة شلاَّل الغضب ينْحدر من فم «السّيّد رضا» وشَررَ الثّار يتطاير من ناظِرَيْه، أدْركتْ بحِدَّة فَراستها، أنّ الأسَدَ الهصُور الّذي تمثُلُ حائرة أمام سطْوته وسوْرته، لم يُخلَقْ ليعيش طويلًا، ولم يطلبِ الشّهادة ليكْتفي بالرِّيادة، فقالتْ وعواطفُ الأنوثة تنْسكب حبّاتٍ بلّورِيَّة من عينيْها الوالِهتيْن:
«طوبى لكَ يا عمادَ أفْراحي وأحزاني، بلْ يا عمادَ تلك الأمَّة الباحثة عن غَدها في مجاهل الغرْب، النّاسية ماضيها المجيد وحاضرَها الشّريد، بين معارف الشّرْق ومعاركه.
أنا أفهمك جيّدًا، وأستنطقُ حماستك وأمانتك، كما أتصوّر مناعة صَحْبك وصِدْقهم، البادِرة النّادرة، واليد المنقِذة لهذه الأمّة البائسة اليائسة.
ولكنَّني يا حبيبي امرأة تسْتميلُها زهرةٌ خضيلة، وتسْتبيها ابتسامة أسيلة، لا أستطيع أنْ أتجاهل حناني الفيَّاض عليك، ونفْسي الجامحة إليك، ولا أقْوى على دفْن براعم مودّتي النّديَّة في لواعجي الملْتهبة، أنا قفيرٌ مليء بالشَّهْد البرِّيّ،
بلْ أنا وردة تسكَرُ بملامَسَة الأنْسام ومناجاة الأنْوار، فهلاَّ عرَفْتَني وأترعْتَ فراغي بفطْنتك وغِبْطتك، وعزيّتَ فتوَّتي بنضارتك ومَلاحَتِكَ؟».
طفَت على حَدَقتَي الخطيب الحسّاس، حروفٌ وأسمْاء عويصة مُبهمة، لا تُحسن قراءتها إلّا النّفوسُ الكبيرة، والضّلوع الموتورة، فتقدّم منها ولزَّها إليه، وتأوَّدتْ جوارحُه اضْطرابًا معها، واحتفاظًا بها، وأحاطَ مَنْكبيْها بذراعه المفْتول كحبال المنجنيق، وهمَس في أذنها همْس الفراشة للأغصان:
«أحبُّكِ كثيرًا أيّتها الحمامةُ الوادعة وفوْق الكثير.
قد وقفْتُ شِغاف قلبي سكَنًا لمسرّاتكِ وآهاتكِ.
بيْد أنَّ أعماقي الّتي تلِدُ الأشْياء، ولَدتْ لذَّة أُخرى.
لذَّةً ملكَتْني قبلَ ولادتي، وتُزْمِعُ الآنَ هَلاكي وإبِادتي.
إنَّ صوتَها أجملُ الأصْوات فهي تُثيرني دائمًا كعاصفة صاخبة.
حبَّذا لو تعرفين مكانَتها الرّفيعة عنْدي.
أو تتعقَّبينَ آثارها المحفورة على رمال الشّواطئ، المنحوتة في كُثْبان الصَّحارى.
وفي اليوم الّذي بعثتْ لي مَلَك الموت، أمطرتْني بالأعباء الثِّقال.
لقد حمَّلتْني ألفَ وصيَّةٍ غير قابلة للتأْجيل.
آه، لو تقرئين رسالتَها الّتي كتَبتْها لي بِمِداد من دماء!
إنَّها حبيبتي الأُولى الّتي لا مفَر َّمن الزّواج منها.
كيف تُسامرين رجلًا تعلَّق فؤادُه بامرأة أخرى؟
أحببتكِ بإرادتي كلّها وكَلِفْتُ بِها بلا وازعٍ ولا لِقاء.
إنَّ عشيقتي الأميرة تَغار منكِ على بُنْدُقيَّتي ورَصاصتي.
وهي تُجمِّل إليَّ وجْهَ الموت القبيح، بقدْر ما تحبِّبين إليَّ مفاتنَ الحياة.
شتَّانِ بين عروس هامتْ بي لِذاتها وأخْرى تولَّهْت بي لله.
الأُولى تعلِّق صورتي على جدار غرفتها، وتحفر اسْمي على عِقْدِها الذَّهبيّ.
أمَّا الثّانية فتقدّمني قرْبانًا شهيًّا على مذْبح الحرّيّة.
الوَداعَ! الوَداعَ! أيّتها الغيْمةُ العابرة، أيّها الشّعاع الجميل
المهدَّد بالظّلام والضَّياع.
أريد أن أُسافرَ إلى عرَاقة الأرْض وصَلاَبة الأحْجار.
أَراني مصْطحبًا إلى أرائك الرَّغَد والحبور، غبارَ الخنادق، وأَوارَ البنادِق.
ها قدْ فتَح الجنوبُ أبْوابَه، وحمَلتْ أمْواجُه الرَّاحلين إلى الجزائر البعيدة.
وعلى أديمِه المشبَعِ بالقصائدِ والزَّغاريدِ، سأبني مجدي الكبير في حُفرَةٍ صغيرةٍ.
إنَّ عرْشي الصّغير لا يتَّسع لِجناحيَّ الطّليقيْن.
إنَّه يضيق حتَّى بأنفاسي المقطوعة وأطْرافي الهامدة.
بيْد أنّه يستطيع الاحتفاظ ببَركة التُّراب وعَبقِ النَّجيع.
وفي أثناء نومي الأبديّ ويقَظتي الدّائمة.
وحين تلجأُ الدّهور إلى السّكينة.
وحيث أفسِّر أحلامي المبْهمة، على ضفَّة بِركة من دمائي.
بلْ بعدما تقْهر نعْشي رُفاتي، ويتمرَّد كفَني على رِثائي.
هنالك، في رحِم الأرْض الصَّامت.
بعْدما أولدُ من جديد، ويضُمُّني الخلودُ إلى صدْره، سوف أفرح مع الفَرِحين وأسْتبشِرُ مع المستبشِرين، وأفوزُ معَ الفائِزين.
والآن، الآن، وبهمَّة تتمرَّدُ على القُصُورِ وتذمُّ الضّغينة.
وأنا على الضفّة الأولى لحياتي الثّانية.
أَوَدُّ أنْ أتزَّوج الشَّهادة.
خِلال نهارٍ جنوبيٍّ مُضيء.
مع وثبة علَويّة راهبة.
وبجسارة حسيْنيَّة فائقة.
وفي ليلة مباركة من ليالي القدْر.
من أجْل أنْ يُزْهِرَ نيْسان.
ويفْرحَ الإنْسان».
دمُوع الوداع
فَسَخَ «السّيّد رِضا» عقْد خطوبته، بلا حرَج يعْتريِه أو ندم ينْتابه، بعد إقناع حبيبته الوالهة بقراره الجريء، الّتي وقَع عليها الانفصال وقوع الصّاعقة، فالآمال العِراض الّتي كانت تختزِنُها في مرابع صِبَاها، سحقتْها الأقْدار الحديديّة، والأطيار الصّادحة الّتي كانت تُصغْي إليها مغرّدة في حدائق الحبّ النَّضِرة، رماها الصّيّاد فسقطت مُتمَلْمِلة على الحضيض، ولكنّها لجأتْ إلى القبول بالواقع المرّ، راضية بالأعْذار الوافية، والبيّنات الوافِرة، الّتي بسطَها أمامها الخطيب المقاوم إذْ قال:
«لا أريد أنْ أَغيبَ عن هذه الدّنيا، مخلّفًا ورائي طفلًا يتيمًا، يبْحثُ عن أبٍ يسْند إليه ظهره، فلا يعْثر إلّا علَى الخيْبة والكآبة، فينمو بين العُزلةِ والوحْشَةِ، كبَنَفْسَجةٍ مُهمَلة نابتة بين الأحْجار، أو تاركًا أرْملة تندُب قدَرها بيْن بناتِ جنْسها، شاكية الوحْدة القاسية، معانية الفَقْد الأليم، راثية طائرَها الرّاحل وحظّها العاثر».
وعزَم «السّيّد رضا»، كما هو دأْبُه، على مُعاقرة العِلْم ومُواكبة العمل، فزار الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة الّتي تولَّع بإمامها، وتمسَّك بثورتها، وانْتسب إلى جامعة آزاد، ليروي غليله من ينابيعها الفكريّة العذْبة، وفي تلك الدّيار العامرة بالسّعْي والحيويّة، الضّاجَّة بالنُموِّ والغَناء، حيث يُسابق المسلمون الإيرانيّون الزَّمن، مُتأهِّبين متوحِّدين، في مسيرة الإبْداع والدِّفاع، قضى عامًا ونصف العام مغْمورًا بالسّعادة، مُجلْببًا بالفلاح، ولم يكنْ ينغِّصُ عليه عيْشَه ودراسته، غير ذلك الصّوْت الخافت الصّاعد من أحْشائه المضطرِبة، ذلك النّداء الآتي من جنوب لبنان، تلك الاستغاثة الدّائبة، الّتي امتدَّت دعوتُها النّافذة من وطنه الأوّل المنْكوب إلى وطنه الثّاني الموْهوب. وطال سُهْدُه، وكادتْ تسوءُ حالتُه، فالنّجاح الّذي يبتغيه في الدّولة الفتيّة، وإنْ عظُم شأْنُه وظهرتْ آثاره، لنْ يساوي مَغانِمَ السّهر الدّائب على ثغور لبنان، والفوز المنتَظر بالعزَّة المنشودة أو الشّهادة المجيدة.
وحطّتْ طائرةُ العوْدة الميْمونة على مطار بيروت، فارتعشتْ شَفَتا المسافر المتيَّم، وهو يقبّل تراب الوطن، وانتعشتْ سرائرهُ بالأنْسام الجنوبيّة، المخْتمرة بأنفاس الثّوّار الأبرار، وبلغ قريته
«رأس أسطا» فاحتفتْ به وقرَّت عيون أُسْرته بحبيبها الكبير.
مضَت اللّيلة الطّافحة بمسرّات الأحبّة، العامرة بحضور الغائب الغالي، المستبْشرة بالشّابّ السّعيد بملاقاة أحَبّ النّاس إليه، ولم يُسْفر الصّباح عن وجْهه، حتّى هجرَ «السّيّد رضا» فراشه، ودلَفَ نحو رابية قريبة من بيته، توشَّحتْ بكساء ربيعيّ بهيج، ووجَّه بصَره نحو فضاء الجنوب، كأنّه يدعو نسورَه إلى حمْله على أجْنحتها، وإلْقائه على تلك القُنَن الشَّامخة المرموقة بهجَمات الأحْرار الظّافرة.
وبينما كان مشْدوهًا بحلاوة التّأمُّل، تائهًا بيْن الواقع والخيال، امتدَّتْ يدٌ رفيقة إلى كتِفه، وهزَّتْه هزًّا لطيفًا فصلَه عن غيْبوبته الممْتعة، وسمع والدَه مسْتفهمًا: أيْ بُنيّ، ماذا تفعل هنا قبل طلوع الشّمس وانْدحار الضّباب؟
أنْصت الشّابّ بإمْعان إلى صوْت أبيه كأنّه قوّة غيبيّة تجذبُ سمْعَه وفؤادَه، والتفتَ نحوَه غاضَّ الطَّرْف منفَرِجَ الثَّغْر قائلًا: «السّلام عليك يا والدي، يا وراثَ جسَدي الفاني وروحي الرّاحلة».
فأجابه والاسْتغرابُ يُراود كلماته: «وعليك السّلام يا عبدَ
الله الصّالح»، ثم أرْدَف: «أنا أفهم من طبيعة الأشْياء وأشياء الطّبيعة، أنّ الفَرْعَ يسْتمدُّ بقاءَه وسلامتَه من الأصْل، وأنَّ الأبناء يرثون صفات الآباء ومآتيهم، فلماذا قلَبْتَ رأْسَ المعْنى على عقِبه، وبدّلْتَ الموازين الإنسانيّة والمعادلات الوراثيّة؟».
فأجابه والّلياقة تسبق صوته إلى مسامعه: «أنا لستُ يا أَبَتاه دابّة تجرّها الحياة أينما تشاء، ويُهلكها الموت حيثما يُريد، أنا فراشة طليقة تُراقص الغصْن الّذي تَنْشُد، وتلْثُم الزَّهرَة الّتي تشْتهي، لن أنتظر ملَكَ الموْت على فِراش الخُمول والخُنوع، مثْلما يفعل عبيدُ الحياة، بلْ سأبحثُ عن مخالبه الحادَّة، في مرابع الأخْطار وعلى حِفافِ المهالك، وتحت هَدير الصّواعق ورهبة البوارق، متربِّعا على عرْش الخلود سيِّدًا على الموْت وملِكًا على الحياة.
فاتَّسعتِ الدّائرةُ المبْهمة، حوْل خيال الوالدِ الشّغوف، فزاد سائلًا: «كيف تفتِّش عمَّن لا يغْفلُ عنْك، ويقتفي أبدًا خطواتكَ، وهو أقْربُ إليك من نبضات قلْبك؟».
فأجاب مُداعبًا: «لأنني أحنُّ إليه كما تحنُّ الأُمّ إلى ولدها المسافر، ولا أطيق العيْشَ من دونه».
فردَّ الوالدُ بصوْت متهدِّج والقلق يغزو سحْنته: «ماذا دهاكَ يا شيخ عماد حتّى تتمنّى الموْت الّذي يفرّ منه جميع الأنام؟ دَعِ الأمور تجْري في مقاديرها، ولا تستعجلْ ما أجَّله الله، كما لا تؤجِّلْ ما اسْتعجلَه».
أجابَه والفرحُ يتدفَّق من حُنجرته: «لقد طلب الموتَ الجبان، بلْ سعى إلى عَقَباتِهِ المغروسَةِ بالأضاحي، منْ هو أعْظم منِّي شأْنًا عنْد النّاس وأكرمُ منزلةً عند الله، إنّه الإمام الحسيْن، الّذي غلَب الموْت بالموْت، واشترى السّعادة بالآلام، وطرقَ بابَ الإصلاح مقطوعَ الرّأْس، ممزّق الجسد، كما أنّ هذا الرّافض العظيم، لمْ يكْتفِ بشُرْب كأْس الحِمام، بلْ احتسى الألم صِرفًا من كؤوس أخرى طفحت بالمآسي، وتحنَّت بالدّماء، تناولها بصبرٍ عنيدٍ ويقينٍ رشيدٍ صحْبُهُ الأخْيار وآلُهُ الأطهار».
فضحك الوالد حتّى بانتْ ثناياه معْجبًا برُؤى ولَده وبُعْد خياله وقال:
«أنا لا أنكرُ الحقيقة الّتي وصفْتَها وفضَّلتَها والبارزةَ في ذِهنكَ وأمامَ عاقِلتي، ولكنَّك يا بُنيَّ، أصْغر أولادي الذّكور سنًّا، ولَكم وعدَتْ أمُّك نفْسَها بصُحْبتكِ، في سفرَتها الدّنْيويّة
القصيرة، وقد أخبرَتْني منذ سنوات خلَتْ أنَّها رأتْ في المنام أفْعى سوْداء مخيفة، تقتربُ منها وهي جالسة على ضِفّة نهْر غزير، فهربتْ مذْعورة، والحيَّة تلاحِقُها مسْرعة كَنَبْلَةٍ أطْلقَها رامٍ ماهر، وإذا بك تخرجُ من النَّهر، ممتطيًا فرسًا أبيضَ، متقلِّدًا رمحًا طويلًا، طعَنْتَ الثّعبان بسنانه فأرديتَه صريعًا، ثمّ انْحنيْتَ رافعًا أمَّك الخائفة، بذراعك القويّ، وأردفْتَها خلْفَك، مُطْلِقًا لجوادك العِنان، وفي غمْرة غِبْطتها بالخلاص، ارتفع صوْت الأذان، فاسْتيقظت مُبْتسمةً باحثة عن فارسها النّبيل وحِصانه الجميل.
لقد طوتِ السنونُ الخوالي هذه الرُّؤْيا، وكلّما دار الزّمنُ دوْرةً، تزْداد والدتك بك تعلُّقًا، وعليك اعْتمادًا، فهل تريد يا ولدي أنْ تموت باكرًا لتقضي على أمِّك الحالمة بمصاحبتك ومعاشرتك ما أعطاها الله من أجَل وأمَل؟».
فاضتْ عيْنا الابْن البارّ بالدّموع، فراح يمسحُها بطرَف كُمِّه، ثمَّ قال والأدبُ الجمُّ يزيِّن عباراتِه، والتّقدير الوثيق يجعلها أكثْرَ دلالةً، وأشدَّ اختراقًا:
«صحيح يا أبي، أنَّ الأُمّ ربّةُ أُسْرتها، تأمرُ فتُطاعُ، وتدعو فتُجابُ، ولكنَّ الله جلَّ جلالُه خلَقَ المرأةَ وادعةً رائعةً لإسعاد
الرّجل، ثمّ جعلَها أُمًّا رؤومًا لإثْراء الوطَن، وزرعَ في نفوس الأبْناء قبل مجيئهم إلى هذا العالم غريزة الانْتشار، وفضيلَة الانْتصار، فعمليّة الوُجود الموجَّه والإيجاد البديع، تبدأُ جذُورها من الخالق لتصلَ فروعُها إلى المخْلوق.
أنت تعرفُ يا أبي حقَّ المعرِفة أنّني ما طلبْتُ جاهًا دُنْيويًّا قطُّ، ولا غرَّتْني نفائِسُ هذا العالَم السَّائر نحو الزّوال، ولا اسْتمالتْني كنوزُه ومكاسبُه، لقد علَّمتْنا سيرتُك الصّالحة، وشقوقُ راحتيْكَ، وثباتُ قدميْك، أنْ نُصادق العملَ الشَّاقَ، الّذي يحفظ أسماءنا في سجلّ الشُّرفاء، ونُعادي البَطالةَ البالية، الّتي تجعلُ حياة الخاملين راكدةً كالمستنقعات الآسنة، تلك الحياة السَّاقطة الّتي ما إن تلوح للعَيانِ، حتّى يَكتِنَفَها الدَّيْجورُ، ويُخفيها نكرَةً مجهولة، وكلمة ممحيّة، مطويَّة في عالم العدم والنِّسيانِ.
إنّ احتلال العدوّ الصُّهيوني، هي مأْساة هائلة مُرَوِّعة خرْساء، أصابتْ الجنوبيّين المعذَّبين في صميم آمالِهِم ومآلِهِم، فبدَّلَتْ معالِمَهُمْ، وأفْسَدَتْ مَعاشَهم، فتقهْقروا مصْلوبين على جذوع أشجارهم، مُلاحَقين في مساجدهم، محاصَرين في كنائسهم، معتقَلين على أسِرَّتهم، مُهانين حتّى أمامَ نِسائهم وأطفالهم.
العدُوّ في وعيد دائم، وتهْديد قائم، والشّقيق قد تجاهَلنا كالغريب، ونأَى عنّا كما ينأى الصّحيح عن المريض مخافةَ العدْوى، أمّا الصّديق فأَصَمٌّ أبْكمٌ أعْمى، لا يُبْصرُ ولا يعي.
وغرِق الجنوب في أحْزانه، وتخضَّب بدم الأبْرياء والضّعفاء والعُزَّل، ولمْ يجدْ في هذا البحر البشريّ من العرَب والمسلمين مُناصرًا أوْ مُعينًا، غيرَ أولئك اللُّيوث الكُرماء، والمتطوِّعين الأشاوس، الّذين أوجعَهم مُصابُ النّاس الطّيّبين، وأثارتْ نخْوتَهم فواحشُ المحتلِّين وقساوتُهم، فآلوا على أنْفسهم إنقاذه، ومداواة كُلُوم أبنائه.
فإذا ما تخلَّفْنا عن رَكْبِ النِّزاع والصِّراع يا أبي، وتركْنا النَّار مشْتعلةً في ديارنا، فمنْ يصدُّ العدوَّ الباغي، ويُطفئ جحيمَه الممتلئ بالعظام والجماجم؟
بلْ كيف نرفعُ رؤوسَنا في الصّلاة قائلين الله أكْبر، وشياطين اليهود تتَحكّم بمصائرنا وتُحْصي أنْفاسَنا؟
أليس الشّباب المسؤول حامي الدّيار القويّ، ووقود الحياة المستعر؟».
فقاطعه أبوه، مستبْشرًا بروحه المتمرّدة على ظُلمْ الصّهاينة
وطُغْيانهم، وقال مُشجّعًا: «إنّي أرى في شبابك الرّافض، مناقِبَ أخْوالي وأعْمامي، الّذين أعلنوا الثّورة على المسْتعمر الفرنسيّ، وحاربوه بالخناجر والمِدى، بلْ قاوموه بأدوات الحرثْ والحصاد، ولا أجد غرابةً في حماستك الوطنيّة، وغيْرتك الدّينيّة، لأنَّ الأرْض المغتصبة الّتي لا يدافع عنها أصحابُها هي أرضٌ عقيمة، وأبناؤها لُقَطاء، وحاشا أن تكون بلادُنا مقرًّا آمنًا للطُّغاة، أو يُصبح شبابُنا لقمةً سائغةً بيْن أشْداقهم.
سِرْ يا بُنيّ إلى مقرِّكَ الأسمى وربِّك الأعْلى، وإنّني لألْحظُ الآن في قَوامِك المنيعِ، صقْرًا لا يخفقُ في اقْتناص طريدته، وأجدُ في سيرة المجاهدين فتحًا مُبينًا، وألْمحُ على المشارف والجنباتِ، أعْلامًا صفْراء تصفِّق للفرَح والنَّصر، وتبشِّر برِفْعة هذه الأُمَّة وعُنفُوانها».
سُرَّ الشّيخ عماد بوصايا أبيه ونبَالته، واهتزَّ طرَبًا بين يديْه، طابعًا قُبْلة الشّكر على جبينه، ثمّ سأله تمامَ الرّضى عن قراره المصيريّ، طالبًا منه الدّعاء له للاحتظاء بلقاء الله وأضاف: «لقد قرُبَ موعدُ الحجّ إلى مكّة، ولا يفصلنا عنه إلّا أيّام معدودة، ولعلّك تسمح لي بأداء هذه الفريضة الّتي تستهْوي سريرتي، وتستحْوذ على حواسِّي، كما أرغَبُ بقَبول اعْتذاري عن عدم
رجوعي من أرض الحجاز إلى لقائكم الأثير لديَّ، فقد نُبِّئْتُ أنَّ المحتلّين القُساة، قد ضيّقوا الخِناقَ على أهْلنا البُسطاء، وقُراهم المعْزولة عن الجسد اللّبنانيّ، المنسيَّة من فئاته المسْتغربة المسْتسلمة، والمقاوَمة الجادّةُ هي الباعُ الطَّويل لهؤلاء القوم، الّذي يردُّ عن أحيائهم وأقْواتهم الصَّاعَ صاعيْن، والكيْدَ كيْدين، وقد نويْتُ أنْ أُيمِّمَ شطْر الجنوب بعْد أداء مناسك الحِجّ، لمقارعة عدوّ الله وعدوّنا، فاذا حرمَتْني الشّهادة من رؤيتكم في دنيا الزُّخْرف والغرور، فسوف تجمعُني بكم في دار الهناء والسّرور».
بكى الوالد العطوف بكاء مُرًّا لذيذًا، وحضن ولدَه بِحِرْصٍ وَحنُوٍّ غريبَيْن، كأنّه أيْقن بغيبته الطّويلة، فشَاء أنْ يوافيَه بالوَداع الأخير، ثمّ كَفْكَفَ القَطرات السَّخيَّةَ المنهمرة على وجنتيْه، ووضع وجهَهُ قُبالة مُحيّاه قائلًا: «بورِك فيكَ يا عِماد، يا أميرَ العارفين، ويا دليلَ الجاهلين، وسلِمَتْ البطْن الّتي أنجبتْكَ فلا حرَمَنا الله من مواهبك، يا عماد الدِّين والوطن».
مرَّت ثلاثة أيَّام مرور لحظة واحدة، والأُسْرة المسْتعينةُ بالصَّبْر والصَّلاة، تتماسكُ وتتآلف، وتَلْتَفُّ حوْل ولَدها التفاف وُريْقات الوردة على بذورها، فهذه الأخْتُ تقبِّلُه، وذاك الأخ
يُمازحه، وتلك تنام على كتِفه، وأخْرى تُريق دموعَها فرحًا به وجزعًا عليْه، فتناغمتْ مشاهدُ الوداع العائليّة الحميمة، لوْحةً فنّيَّة رائعة، تزهو بثلاثة ألْوان خلاّبة، هي الأبيض والأسود والأحمر، واحد يرْمز إلى أصالة الأُسْرة ونقاء معْدنها، وآخر يُشير إلى الموت القويّ، الّذي يقْهَرُه المقاومون وتمْحوهُ بسالتُهم وتضْحياتهم، وثالث يدُلّ على الشَّفق الجميل، حيث تتألَّقُ آلاء الشُّهداء وترفْرفُ أرواحُهم، وتتلألأُ دماؤهم كواكبَ ثاقبة، تجلو ببهائها ظلمات الأيّام واللّيالي.
الرَّاجعُ المنْتصِر
سافر الشيخ عماد إلى الحجاز، تحمله عبوديّتُه الخالصة للخالق، على جناحيْها المنبسطيْن بين المشْرق والمغرب، وهنالك باح بمكنونات صدْره، متعلِّقا بجدار البيت العتيق، وسجَد على رمال عرفات مودِعًا فيها أشواقه وشكْواه، وسامر في وادي مِنى النّجوم والغيوم، مَادًّا إليها بلْ إلى مَنْ وراءَها يديْه، راجيًا المغفرة، طالبًا حُسْنَ العاقِبة، شاكرًا الله على ما هداه وأعطاه، وطرقَ باب المصطفى في مدينته مسلّمًا عليه سائلًا مُجاوَرَتَهُ، متوسِّلًا إليه المحبَّة والشّفاعة، مبايعًا إِيّاه رسولًا أمينًا، وقائدًا مُطاعًا، وهاديًا إلى صراط مستقيم، ولم يغادِرِ الدِّيار المقدَّسة إلاَّ بعْد أنْ دفنَ في رمالها، وترك في مساجدها نوايا كيانه المنيب وقضايا ذاته التّائبة، أمّا روحُهُ الّتي لا سكونَ لحَرَكَتِها ولا انكفاءَ لمداها فقد ظلَّتْ حائمَةً هادِلةً كالحمَام الزّاجل، بين مكّة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة.
عاد الشيخ عماد إلى لبنان، مهْبط آماله، ومحطَّ رحاله، فاستقبلتْه أنْسامه المشحونة بأنفاس السّرايا المجاهدة، المختَمِرة
بروائحِ التّوتُّر والتّربّص والتّصبّر، فعضَّ على شفَته، ولوّح بقبْضته، كأنّه يتوعَّدُ المجْرمين، وتوجّه إلى كلّيّة الرّسول الأعظم، وفي رحابها المطمئنّة، التقى شريكه الأمين «أبو حسن» الّذي شاطره في غمْرة السّنوات الخالية، رحلَة البحْث والاسْتقراء، في قاعات الدّراسة وساهمه المرابطةَ والمصابرةَ والمقارعة، على الشّريط الحدوديّ المحتلّ.
أرْجعت الذِّكرى الصّديقيْن إلى مآتي الأمْسِ البعيد، المطبوع بشغَفهما العِلْميّ المدْنِف، فهما الطّالبان المجتهدان، والمنهومان اللّذان لا يشْبعان من خُبْز المعرفة، ولا يرتويان من ماء الحكْمة، ووصلَتْ بهما خواطرُهما إلى استرْجاع صُوَر المواقع والمعابر والمخابي، الّتي شهِدتْ جهودَهما القُصْوى، ومآثرَهما الدّفاعيّة عن التُّراب الّذي لا يبيعُه مالكوه بخزائن الملوك ولآلئ البحار، واستعراض تلك السّاعات المباركة السَّابحة في الأفْلاك الرّبَّانيّة، المأْهولة بالمزايا والعَطايا، تلك الدّقائق الغنيّة بأمْجاد الرّجال، الّذين يضبطون وهم في أوْج كِفاحِهِم، إيقاعَ العِلْم والعِرْفان، على نيران المدافع والبنادق، يَوْمَ تَنادي الجحافلِ والفَطاحل، في ميادين الحُسامِ واليَراعِ.
بينما كان المقاومان الودودان، يتجاذبان الأخْبارَ والأحْداثَ
والمواضيع، رنَّ جرَسُ الهاتف فأسْرع «السّيّد رضا» ليردَّ على الطّارق، وإذا به يصفِّقُ مسْرورًا قائلًا الحمدُ لله. لقد أقلَّ له الهاتف ما كان يسْتطيبه من بشائر سارّة، وفاض ثغْره شكرًا وعِرْفانًا، وهمَتْ دمْعتا غِبطة واستكْفاء على خدَّيْه، ثمّ قال بصوت ترقْرقه النّبالةُ وتهدْهده الرَّخامة: «لم ينْسَني الله من رحمته يا «أبو حسن» لقد جاءني التّكليف بإحْدى العمليّات الصَّعبة، لقد حان وقت إيابي إلى عالِم الغيْب والشّهادة، هذا هو الذّهاب المنتظر الّذي لا إياب لي بعدَه». ثمّ رتَّب كُتُبه وأمْتعَته الشّخصيّة، تاركًا وصيّته أمانة في عُنقه، احتضنه من بعْدُ مودِّعا وهو يقول:
«أنا مُوقنٌ أنّك حافظ للمودّة وفِيٌّ للصّداقة، أنت أهْلُ ثقتي، ومقرُّ أملي ومُستوْدع سِرِّي، ومُنفِّذ وصيَّتي». وخرج من حرَم الجامعة خروج المارد من القُمْقُم الأسْطوريّ، وقبل أنْ تختفي قامتُه الرّشيقة الأنيقة خلْف الباب الخارجيّ، أعاد الالتفات صوْبَه مُلحًّا: «أوصيكَ بأنْ يصلّي على جثماني بعْد اسْتشهادي «السّيّد القائد» «، فردّ عليه بلهْجة مُفْعَمة بالصِّدق: «سأبلِّغه ما طلبتَ، وسأتبعكَ بعد سويْعات إلى عَرين المحَرِّرين، فلعلَّ الله يفتح على أيادينا فتحًا مُبينًا». فأرسل إليه «السّيّد رضا»
إيماءَة ثقةٍ وإعْجاب هازًّا رأسه وزاد داعيًا: «ليباركْكَ الله».
أدْرك صِنديدُ المرابطين مكامِنَ رفاقه السّاهرين، في الهزيع الثّالث من اللّيل، وشرَع قائدُ المجموعة يرسمُ الخطّة الهجوميّة على أسْراب العلوج الصّهاينة، والعملاء الأجْلاف، ثمّ وجَّه خِطابَه «إلى السّيّد رضا»: «نريد أن نشاهد اليوم بل الآن، ما عهدناه فيك أيّها الأسدُ المهاب، من براعة في التّفجير، وذكاء في التّدمير، وفِطْنة في الانْسحاب»، فأجابه بلسان يتلجلجُ بآيات الرّضا والقناعة: «أنا لها يا أخي، فلمثْل هذه المواقف أنجبتْني أمّي، أنا جنديّ مُطيع في صفوفكم المتراصَّة، قد حملْنا أمانة الجنوب على مصاعد أرواحنا، ومقابض أسلحتنا، وأكْملنا رسالة الحسيْن الّتي انفجرتْ، على رمال الطّفوف، جداول َمن الدّماء وآلاءَ من الرُّؤوس، وهِباتٍ من الأطْراف المبْتورة بالحراب، والهياكل المسْحوقة بسنابِك الخيْل، وما صراعنا مع الصّهاينة إلّا فصلٌ دمويّ مرير شاقّ، من فصول تلك المعركة الحاسمة، المضطرمة بالعطش والألم والتّظلُّم، المكتوبة بالمآسي والمآثر والتّضحيات، والّتي هي مسرح الصّراع الفاصل بين الفضيلة البشرية والرّذيلة المتوحِّشة، بين قوى الخيْر الّتي تُبْدع عبْقريَّة الفِداء ولوْحة الانتصار، وعصابات الشّرّ الموغِلة في الإيذاء والاعتداء، تلك
العناكِب البشريّة الموْصوبَةُ بالانْدِثار، المصحوبة بالرِّثاء، الفانية بدعواها الباطلة، وأصولها الواهية، وفروعها الماكرة، وسوف تظلّ تلك الواقعة حيَّةً إلى الأبَد الّذي لا أمَد بعدَه، بنا يقْطع الله دابِرَ الظَّالمين، ويمحقُ الجوْر، ويعزُّ الإسلام، وينصر الحقّ الغصيب».
نصبَ «السّيّد رضا» الكمينَ المحكَم بصُحبة ستّة من فُحول المقاومة الأشدّاء، وغرقتْ قاماتُهم بين أفْنان السِّنديان الكثيفة، حتّى إذا ما ظهرتْ فِرَقُ المغْتصبين الهائمين على وجوههم كالخفافيش الضّالّة، هبَّ اللّيْث المتربِّص، هُبوبَ إعصارٍ مُدمِّر، مُفجِّرًا العُبوَة النّاسفة، بالمرتزقة الجُبناء، ثمّ صوَّب رشَّاشه إلى بقاياهم، وكان أوَّل من أطْلق النّار كوابل من الأمْطار، فخرقَ أجْسادهم وبدَّد عديدَهم، ثمَّ تلاه رفاقُه البواسل بإعْدام المفْترين، وإبادة الجناة.
بيْد أنَّ نجاحَ هذه العمليّة الجريئة، لمْ يولدْ من دون مخَاض، ولمْ يتجسَّد فخرًا مؤثَّلًا من غير أوْجاع ومُكابدة، لقد فتحت الجِنانُ أبوابها، واسْتعجلت الشّهادة الحسْنى، حبيبَها المِقْداَم، مُمْتطيًا الحزْمَ والأملَ واليقين، في موكب الضَّراعة والرّجولة والوفاء، وقد تمَّ الاقْترانُ السَّعيد بُعيْدَ احْتدام التَّراشُق بالنِّيران،
والمعركة حامية الوطيس، بين أنصار الهدى، وأذْناب الضَّلال، بلْ بيْن الشُّرفاء الأتْقياء، والدُّخَلاء الأدْعياء، أصابت الرّصاصاتُ الشِّرِّيرة جسَد «السّيّد رضا» واخْترقتِ الشَّظايا الآثمة عمودَه الفقريّ، وهشَّمت هامتَه الرَّفيعة، الّتي أبتْ أنْ تنْحني لغيْر الله.
السُّنبلة المتواضعةُ كسرَها حدُّ المنجل.
السِّراج المضيء أطفأتْه الرِّيح العمياء.
القدَمان السّاعيتان لسَعَتْهما أفاعي الظّلام.
على جبل «بو ركاب» مهوى قلوب الذَّائدين، والمتعبين.
تجمَّد نجيعُ الشّهيد السَّعيد، فوق الصّخور الرّابضة.
وتخضَّبتْ حَصاه بِحِنَّاءٍ كربلائيٍّ عاطر.
ها هو أحد الصُّقور السَّبعة يحمل جثَّة المجاهد الأكْبر.
المحارب الّذي انتصر قبْل أنْ يموت، ومات بعْد أن انتصر.
إنّه يحتضنها كما يحتضن النَّاسكُ كتابًا مقدَّسًا.
وبعد لأْيٍ، وصل إلى كهْف مجْهول، حيث تنتظرُ عُصبةُ
الحقّ الأميرَ الظَّافر.
لقد سجَّاه بانْعطاف وتُؤَدَة، أمام حُرَّاس الوَطن، وعمالقة البذْل الكريم.
فجلسوا حوْله كالنُّسور القويّة، وهيبته تملأُ المكان.
وفصاحة جِراحه تحْبسُ أنْفاسَهم، وتسْتدرُّ التّوقير والتَّقدير.
وفي اليوم الثّاني انْبلَج الفجْر المنْتَظَر، وانْتفضَ الزَّمن من رُقاده.
امتلأَ الفضاء بالأهازيج والبيارق، فالشَّهيد الرَّائد في أبْهى حُلَلِه، وأطْيب عطوره.
وهلَّلتْ موَاكب الملائكة، مُهنِّئة العميد، بعُرْسِه الرَّغيد، وغسّل الخِلُّ الوفي «أبو حسن» جثْمان عروس الخُلْد المبَجَّل.
وصلَّى أمينُ المقاومة عليه، صلاة البذْل المظفَّر والنَّصر المؤزَّر.
في قرية «رأس أسطا»، وعلى قاب قَوْسَيْن أو أدْنى من غروب الشّمس، أمامَ زُرْقة البحْر المسْحور بسَخاء المقاومين، دُفِنَ الملاكُ الطَّاهر الشيخ عماد حيدر أحمد أو «السّيّد رضا» تاركًا آثارَه المعنويّة وألْقابَه الجهاديّة، إرْثًا نفيسًا للوطن المعذَّب، وحِرْزًا واقيًا للأُمَّة التّعيسة. وقد كُتِبَ على رخامة ضريحه:
هنا يرْقدُ منْ قال: «أريدُ أنْ أُؤَسِّس جيلًا يحْملُ البُنْدقيَّة بعْد اسْتشهادي».
[1] سورة التوبة، الآية 52.