مواقف الشعراء الخالدة في نصرة الدين -وقفة مع الفرزدق والدروس النافعة-
لم يحفل البلاغيون بظاهرة اللفّ والنشر كثيرا، فقد كانوا يعرضون لها بشيء من الإيجاز، لذا سنقف على النزر اليسير من أسرار هذا الفنّ، وإبراز ظواهره من النصّ القرآني، فهو يرتبط بالفنون البلاغية الأخرى؛ لتشكيل صور بلاغية كاملة(1)، ونستعرض لبعض شواهد هذا الفنّ البديعي، وبيان وظيفته وصلته بالسياق، وبيان آلية توظيفه؛ خدمة لكتاب الله المجيد.
- مفهوم اللفّ والنشر:
يُسمى (الطيّ والنشر)، ولكن أكثر البلاغيين يسمّونه (اللفّ والنشر).
في اللغة: جاء اللفّ في مختار الصحاح: باب (ل ف ف): لفّ الشيءَ: من باب ردَّ(2).
أمّا النّشْر: بوزن النصر: الرائحة الطيبة، ونشرَ المتاعَ وغيره: بسطَه، وبابه نصر(3).
وفي لسان العرب: لفّ الشيءَ يلفُّه لفّا: جمعَه: وقد التفّ، وجمعٌ لفيف: مجتمعٌ ملتفٌّ من كل مكان(4). أمّا النّشْر: نشر المتاع وغيره، وينشُرُه نشرا: يبسطه، والنشر خلاف الطيّ، نشر الثوب ونحوه: ينشره نشرا، ونشرَه: بسطَه(5). وبذلك نخلص إلى أن اللفّ في اللغة هو الجمع، وإن النشر هو البسطُ والتفريق.
نظرة تاريخية في اللفّ والنشر اصطلاحا:
هناك من يرى أنّ أول إشارة لفنّ اللفّ والنشر وردت في كتاب مفتاح العلوم للسكاكي (ت 626 هـ)؛ حيث أوردها ضمن المحسّنات البديعية المعنوية التي يرجع فيها الحسن إلى المعنى أولا: كالمطابقة، والمقابلة، والمشاكلة، وغيرها(6). لكنّ المبرّد (ت 285 هـ) يعدّ من أوائل البلاغيين الذي التفتوا إلى هذا الفن، وكان ذلك في كتابه (الكامل)، حيث قال: «والعرب تلفّ الخبرين المختلفين ثم ترمي بتفسيرهما جملة؛ ثقة بأنّ السامعَ يردّ إلى كلّ خبره، قال تعالى: «وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»(7).
أمّا عند المحدثين، فقد عرّفه الدكتور بدور طبانة في معجمه بقوله: «أن يُذكر متعدد، ثم يُذكر لكلّ من أفراده شائعا من غير تعيين؛ اعتمادا على تصرف السامع في تمييز ما لكل واحد منهما، وردّه إلى ما هو عليه»(8).
- أقسام اللفّ والنشر:
القسم الأول: اللفّ المفصل والنشر المرتب:
وهو ذكر الأشياء المتعددة على نحو التفصيل، ثم ذكر ما يتصل بها على سبيل الترتيب، من غير تعيين؛ ثقة بأنّ السامع يردّه إليه، وله في القرآن الكريم شواهد كثيرة، ومن أمثلته:
- قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّوَرِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ»(سورة الأنعام: 73)؛ حيث ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية عبارتين هما: «خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ»، و«عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ»، ثم ذكرَ ما يناسب كل عبارة، فقال: «وَهُوَ الْحَكِيمُ»، وهو راجع إلى العبارة الأولى، أي: هو حكيم في خلقه السماوات والأرض وفي كل ما يفعله، ثم قال: «الْخَبِير»، وهو راجع إلى العبارة الثانية، أي: هو خبير بجميع الأمور: الغيبية منها والمشاهَدة، وقد جاء الأسلوب على طريقة اللفّ المفصل والنشر المرتب(9).
- وقوله تعالى: «قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ»(سورة سبأ: 24)؛ إذ ذكرَ تعالى متعددا وهو ضمير المتكلم (نا) في (إنّا)، وضمير المخاطبين (إِيَّاكُمْ)، ثم ذكر ما يقابل كل واحد منهما على سبيل الترتيب، فقال تعالى: «لَعَلَى هُدًى»، وهو يقابل ضمير المتكلم (نا)، ثم قال تعالى: «أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ»، وهو يقابل ضمير المخاطَب «إِيَّاكُمْ»، فجاءت الآية على أسلوب اللفّ المفصل والنشر المرتب(10).
- وقوله تعالى: «وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ») سورة القصص: 73)؛ حيث ورد اللفّ في هذه الآية في قوله تعالى: «اللَّيْلَ»، و«النَّهَارَ»، ثم جاء النشر بعد ذلك بذكر ما يخصّ كل واحد منهما من غير تعيين، فقال: «لِتَسْكُنُوا فِيهِ» وهذا يخصّ الليل، وقال: «وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ»، وهذا يخصّ النهار، ففي الآية لفّ مفصّل ونشر مرتب(11).
القسم الثاني: اللفّ المفصل والنشر غير المرتب:
وهو ذكر الأشياء المتعددة مفصّلة، ثم يُذكر ما يتصل بها، ولكن من غير ترتيب، فقد يكون الأول للثاني، والثاني للأول، والسامع هو الذي يردّ كل شيء إلى ما يناسبه، ويمتاز هذا النوع بأنّ له إعمالًا للذهن أكثر، وشواهده كثيرة في القرآن الكريم، ومن أمثلته:
- قال تعالى: «وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ {147} فَآتَاهُمُ اللّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»(سورة آل عمران: 147-148)؛ إذ ذكر (عزّ وجل) في هذه الآيات دعاء المؤمنين، وأنهم جمعوا في دعائهم بين أمري الدنيا والآخرة، فقال تعالى: «ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا»، وهذا من أمر الآخرة، ثم قال تعالى: «وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ» وهذا من أمر الدنيا، ثم جاء الجواب من عنده سبحانه بتقديم جزاء الدنيا على جزاء الآخرة، فقال: «فَآتَاهُمُ اللّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا»، وهذا جزاؤهم في الدنيا، ثم قال: «وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ» وهذا جزاؤهم في الآخرة؛ فالإنسان يحبّ تعجيل ثواب الدنيا، فقدّم سبحانه هذا الجزاء أولا، فعدم الترتيب هذا في أسلوب النشر خرج لغايات تتعلق بأسرار نظم القرآن الكريم، وعظمة أساليبه، لا أن يُسمّى بـ(النشر المشوش)، كما ذهب إليه بعض المفسرين: كالبقاعي (ت 885 هـ)، والآلوسي (ت 1270هـ)، وابن عاشور (ت 1393 هـ)(12).
- وقَولُه اللهِ تَعَالَى: «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»(سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: الآية: 106، 107)؛ ففي الآيتين لفّ وَنشر غير مُرتب، فقد ذكرَ في اللفّ الابيضَاضَ قَبلَ الاسودَاد، وَذكرَ فِي النشر حُكمَ من اسودتْ وجوهُهُم قبلَ حُكم من ابيضتْ وجُوهُهُم.
القسم الثالث: اللفّ المجمل والنشر المفصّل:
وهو ذكر الأشياء المتعددة على سبيل الإجمال، ثم ذكر ما لكل واحد منها من غير تعيين؛ ثقة بـأنّ السامع يردّه إليه، وإذا كان اللفّ مجملا فلا يُوصف النشر بـأنه مرتب أو غير مرتب؛ لأنّ اللفّ مجمل ولا يعُرف ترتيبه، ومن أمثلته:
- قوله تعالى: « وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ»(سورة البقرة: 111)؛ فإنّ الضمير في «قَالُواْ» يشتمل على فريقين مختلفين من أهل الكتاب، هما: اليهود والنصارى، ومعنى هذه الآية: وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من يهوديا، وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، فجاء اللفّ مجملا متعددا في «قَالُواْ»، ثم ذكر ما يخصّ كل فريق بالتفصيل من غير تعيين؛ ثقة بأنّ السامع يردّ كل قول إلى صاحبه(13).
الخاتمة:
تبيّن من خلال تلك الإضاءات على هذا الفنّ القرآني البلاغي، الذي ورد في القرآن الكريم بصوره المختلفة، جاء رافدا من روافد الإعجاز البلاغي، وأسلوبا مؤثرا من الأساليب القرآنية المؤثرة، خاض في موضوعات قرآنية عدة، منها: (العقيدة، والعبادات، والأخلاق، وقصص الأمم السابقة، وضرب الأمثال وغيرها، وانطوت فيه حكمة، تعمل على تهيئة النفوس، وإعدادها لتلقي ما سيأتي بعده من ذكر النشر العائد على اللفّ، فإذا ذُكر النشر وقع في النفوس وقعا مأنوسا، فيتم المعنى، وتتحق الفائدة، فالنشر جاء والنفوس إليه مشتاقة، وله مترقبة(14).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- اللفّ والنشر في النظم القرآني، عطا الله العنزي، 1430هـ، كلية اللغة العربية، المملكة العربية السعودية: ص5.
2- مختار الصحاح، مادة (ل ف ف): ص283.
3- المصدر السابق، (مادة نشر): ص310.
4- لسان العرب، مادة (لفّ): 12/ 304.
5- المصدر نفسه، مادة نشر: 14/ 141.
6- يُنظر: مفتاح العلوم، للسكاكي: 660-672.
7- الكامل في اللغة والأدب، المبرّد، مؤسسة المعارف، بيروت – لبنان، 1/75، والآية من سورة القصص: 73.
8- معجم البلاغة العربية، بدوي طبانة، ط1402 هـ - 1982م، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض: 1/ 485.
9- يُنظر: روح المعاني: م4/ ج7/ ص191، واللفّ والنشر في النظم القرآني: ص34.
10- يُنظر: اللفّ والنشر في النظم القرآني: ص24.
11- يُنظر: اللفّ والنشر في النظم القرآني: ص19.
12- يُنظر: تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، ط1، 1396هـ-1976م، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، ج10/ ص318، سورة الرعد: 17، وروح المعاني، للآلوسي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط1408 هـ - 1987م، (م10/ج19/ص69)، سورة الشعراء: 19، والتحرير والتنوير، للطاهر ابن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، مجلد9/ ج24/ ص48، سورة الزمر: 59.
13- يُنظر: اللفّ والنشر في النظم القرآني: ص26.
14- يُنظر: اللفّ والنشر في النظم القرآني: ص361.
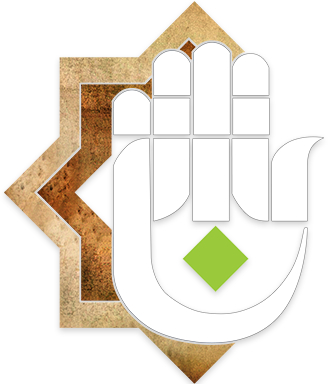


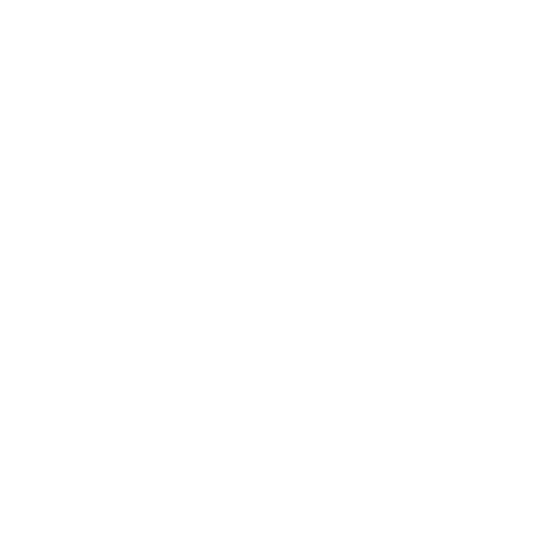
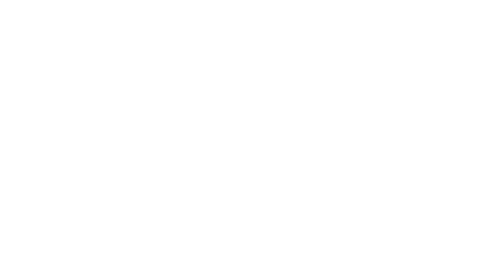
 تقييم المقال
تقييم المقال

