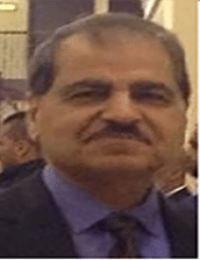الدستور العراقي 2005.. خطوة مفصلية وثمرة حوار وطني في بناء الدولة الجديدة
في مشهدٍ شهير من مسرحية "شاهد ما شافش حاجة"، حوّل عادل إمام نكتة عابرة عن محل عصير إلى دعاية مجانية لصاحبه، فارتفعت مبيعاته بدل أن تتضرر، هذه المفارقة الساخرة تصلح اليوم لتفسير ظاهرة أكثر خطورة الا وهي، تحوّل التفاهة والسخرية إلى صناعة ضخمة تدر الأرباح وتُنتج "نجوماً" بلا موهبة، في عالم تحكمه الشاشات الصغيرة ومنصات التواصل الاجتماعي.
قبل عقود، كان الطريق إلى النجومية معبّداً بالجهد والموهبة والدراسة؛ الممثل لا يظهر على الشاشة إلا بعد سنوات من التدريب، والكاتب لا ينشر إلا بعد مراجعة طويلة، أما اليوم، فقد صار الهاتف الذكي مسرحاً ودار نشر واستوديو في آن واحد، يكفي أن يمتلك شخص اتصالاً بالإنترنت ليبث ما يشاء بلا معايير ولا ضوابط، والنتيجة، فضاء يعجّ بالضجيج والسطحية ومحتوى يملأ العقول من دون أن يضيف إليها قيمة.
الإنسان بطبيعته ينجذب إلى المثير والمختلف، حتى لو كان سخيفاً، ومع ضغط زر الإعجاب أو المشاركة تتسع الدائرة مثل كرة ثلج، أما المنصات الرقمية فتعتمد على خوارزميات لا تبحث عن القيمة بل عن التفاعل، فتمنح الشهرة حتى لمن يقدّم محتوى مضراً أو فارغاً، يضاف إلى ذلك، فراغ ثقافي تعانيه مجتمعاتنا وضعف مؤسسات التربية والتعليم، ما يجعل الشباب والأطفال صيداً سهلاً لنجوم زائفين يتصدّرون الشاشات.
إحصاءات حديثة تكشف حجم الظاهرة وخطورتها، وفق تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات ITU لعام 2025، فإن 70٪ من سكان الدول العربية يستخدمون الإنترنت، بينما تصل النسبة بين الشباب (15–24 سنة) إلى 86٪، ما يجعل هذه الفئة الأكثر عرضة للتأثر بالمحتوى الرقمي سواء كان هادفاً أو تافهاً. وفي الإمارات، على سبيل المثال، وصل عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مطلع 2025 إلى ما يقارب 100٪ من عدد السكان، ما يعني أن التأثير الرقمي بات شاملاً ومباشراً. غير أن المشكلة لا تكمن في الوصول، بل في نوعية المحتوى وضعف المهارات الرقمية التي تسمح بتمييز الغث من السمين.
هذا الانفلات لا يمر بلا ثمن، فالمتابعة المستمرة للمحتوى الفارغ تعيد تشكيل الذوق العام وتزرع في الأجيال اعتقاداً بأن الشهرة ممكنة بلا جهد، وأن الربح يمكن أن يتحقق من التهريج لا من العمل والإبداع، وهكذا تتكرس قيم سلبية مثل السخرية من الآخرين، الاستهانة بالعلم، والاحتفاء بالجهل على أنه مادة للتسلية، والمجتمع الذي يحتفي بالجهل لا يمكن أن يبني حضارة أو يحقق اقتصاداً مزدهراً.
الأضرار النفسية كذلك عميقة؛ المراهق الذي يقضي ساعات يومه بين فيديوهات الصراخ والمقالب والعبارات المبتذلة يفقد تدريجياً قدرته على التركيز وعلى التعامل مع القضايا الجادة، ويصبح أسيراً للمتعة السريعة، ومع الوقت تضعف لغته، يتقزم خياله، وتتمزق هويته الثقافية بين تقليد سطحي لما يراه وبين فقدان الصلة بالتراث والمعرفة الرصينة.
الخطورة تتضاعف حين نعرف أن مؤسسات التربية والتعليم، بحسب تقارير اليونسكو والإسكوا، ما زالت عاجزة عن مواكبة هذا الطوفان الرقمي، فبينما تحقق الدول العربية تقدماً في نسب الالتحاق بالتعليم وتقليص الفجوة بين الجنسين، فإن جودة التعليم ومناهجه تبقى متأخرة، وهو ما يفسّر هشاشة المناعة الفكرية لدى الشباب أمام التفاهة الملمعة.
مواجهة الظاهرة لا تكون باللعن والشتم، بل بحلول عملية تبدأ من الأسرة، البيت هو المدرسة الأولى، وعلى الآباء أن ينتبهوا إلى ما يشاهده أبناؤهم، ويضعوا حدوداً زمنية للمحتوى، ويقدموا بدائل نافعة كالكتب والألعاب التعليمية والأنشطة الرياضية والفنية، هنا أيضاً يبرز دور الجد والجدة في رواية القصص الشعبية والحكايات التاريخية التي تنمّي الخيال وتزرع القيم.
ثم تأتي المدرسة، التي ينبغي أن تدرّب التلاميذ على التفكير النقدي، وتمكّنهم من تقييم المحتوى بعيون ناقدة لا مبهورة. الإعلام التقليدي بدوره يمكن أن يستعيد جمهوره إن قدّم محتوى عصرياً جذاباً لا يخلو من قيمة، أما الدولة فعليها سنّ قوانين تشجّع المحتوى المفيد وتحدّ من التافه من دون أن تقع في فخ الرقابة القمعية، بينما يبقى على النخب الثقافية والمجتمع المدني ابتكار بدائل شبابية ذكية تمزج بين المتعة والفائدة.
لقد منحتنا التكنولوجيا إمكانات هائلة للتواصل، لكن سوء استخدامها أغرقنا في فوضى معرفية تتساوى فيها الكلمة العميقة مع العبارة السوقية، والجهد الإبداعي مع التفاهة المصنوعة، أخطر ما يهدد مجتمعاتنا اليوم ليس الفقر أو البطالة فقط، بل هذا الانحدار الثقافي الذي يخلق جيلاً يستهلك ولا ينتج، يضحك ولا يفكر، يتابع ولا يشارك، وإذا لم ننتبه، فقد نصحو بعد سنوات على مجتمع كامل يعيش في فراغ معرفي وروحي، يكتفي بترديد ما يقوله نجوم زائفون صنعناهم نحن بأيدينا، بإعجاباتنا ومشاركاتنا.
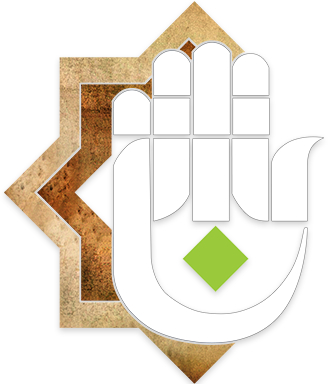


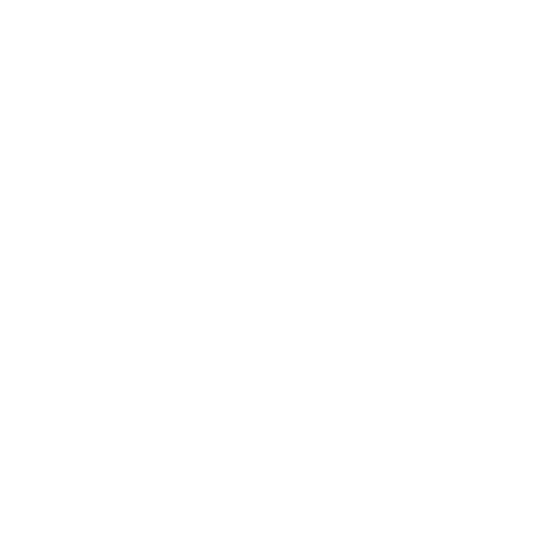
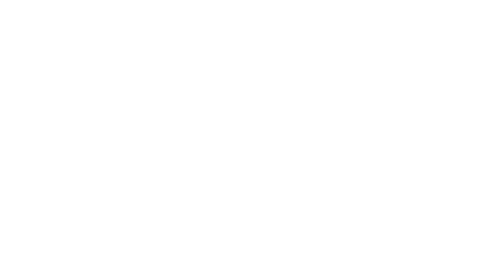
 تقييم المقال
تقييم المقال