(أم المصائب) هل تصح هذه العبارة أن تُطلق على السيدة زينب (عليها السلام)؟
وردت الصورة القرآنية في كثير من قصائد الشعر العربي الحديث؛ لما تحمله تلك الصورة من منحى أدبي خلاق، يأخذ بالألباب، ويأسر القلوب، فالصورة القرآنية لها من التكثيف الدلالي ما يغني الشعراء عن الإسهاب في توضيح المعنى، بأبيات عدة، تختصرها الصورة القرآنية بأبهى صورها الكاشفة عن القصد بإيحاء بديع. فمفهوم الصورة يتسم بالجدة والحداثة، ويحفل بآليات جديدة، تشكل الركيزة الأساس للعمل الأدبي؛ فـ«الصورة القرآنية في الشعر العربي الحديث من الموضوعات المهمة التي تعكس تأثير القرآن الكريم على الشعراء وتصوراتهم الإبداعية؛ فكثرة تداول الصور القرآنية لدى الشعراء أكسبها بعدا رمزيا، فلا تذكر حتى يتوارد على المتلقي فيض من الدلالات والإيحاءات»(1). ولا ننسى أن «استلهام الصورة القرآنية في الخيال الشعري كان له أكثر من بعد إيجابي، فبالإضافة إلى البعد الحضاري، الذي يشد الأمة إلى رافدها العظيم، وصانع تراثها ومستقبلها، فإنّ البعد الفني لا يقل عن ذلك أهمية؛ اذ يستمد الشاعر فيه من الفيض الإلهي في التصوير، ويفيد من خصائص التجسيم، والحركية والدقة والإيجاز، والإيحاء في الصورة القرآنية، ويوظف ذلك كله في تجربته الشعرية، فيكسبها من عناصر العمق والتأثير الشيء الكثير»(2).
أمثلة الصورة القرآنية في الشعر العربي الحديث:
صورة الشخصية القرآنية:
ومن القصائد التي جمعت أكثر من شخصية قرآنية، هي قصيدة (حوار لا يخلو من الحزن)(3) للشاعر نوفل الحمداني(4):
عمر مضى
والهوى حملٌ
تنوء به
تكبو فتنسى
وانقضى وَطًر
فمرة في بطن حوتٍ
ثم ثانية
في جوف نارٍ
تلظى عندها الشررُ
أخرج عصاك
وشُقّ الليلَ أجمعَه
فالصورة الأولى (فمرةً في بطن حوتٍ) تحيلنا إلى النبي يونس (عليه السلام) ومكوثه في بطن الحوت، قال تعالى: «فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ {142} فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ {143} لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ»(سورة الصافات: 142-144)، ثم ضمّ هذه الصورة إلى صورة نبي الله إبراهيم (عليه السلام) بعد إلقائه في نار النمرود، فأنجاه الله سبحانه: «قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ»(سورة الأنبياء: 69)، ثم جاءت الصورة القرآنية لعصا موسى وهي تلقف ما يأفكون في قول الشاعر (أخرج عصاك)، وهي مستوحاة من قوله تعالى: «وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ»(سورة الأعراف: 117). أمّا قول الشاعر (شقّ الليلَ أجمعَهُ) ففيها صورتان قرآنيتان، إحداهما، قوله تعالى: «وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ»(سورة النمل: 12). وهذا البياض هو الذي سيشق عتمة الليل، والظلام الجاثم على صدور بني إسرائيل من قبل ظلم فرعون وزبانيته، ثم الصورة القرآنية الأخرى تتمثل في شقّ العصا للبحر، حتى صار كل فرق كالطود العظيم(5)، قال تعالى: «فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ»(سورة الشعراء: 63).
صورة الاستنهاض:
حفل القرآن الكريم بكثير من صور الاستنهاض، والحث على تغيير الواقع المؤلم إلى واقع مشرق مليء بالتفاؤل، وهذا ما نراه جليا في توظيف الشاعر (علي الفتال)(6) لتلك الصورة في قصيدته (تجليات الفتى يوسف)(7):
يوسفُ...
يا صدّيق استنهض جبَّكَ
حتى يرقى الماءْ
فالناسُ ظماء
حتى مَ تظلُّ بجبِّك تسترضي القاع
وما في القاع سوى رملٍ
لا يقوى أن يحمل غير كليلٍ
من بعض هواء؟
فالرمل بقاع الجب خواء
انظر لقميصك قد جاؤوا بدمٍ كذب
والذئب براء من ذاك
براء
والخطاب وإن كان موجها ليوسف (عليه السلام)، إلا أنه قد يكون خطابا عاما موجها لسائر الناس، في سبيل الاستنهاض، ومقارعة الظلم، خاصة وأن الشاعر قد عاصر حقبة الطغاة البعثيين المظلمة، فكان هذا التشفير مهمّا لإيصال فحوى رسالة سماوية أبطالها الأنبياء (عليهم السلام) في حاجة الناس إليهم في كل حين لتخليصهم من بلاءات شتى، منها ما حصل من رؤيا الملك في قوله تعالى: «وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ»(سورة يوسف: 43)، فكان يوسف (عليه السلام) هو المفسر لتلك الرؤيا، وهو المخلص لشعب مصر وما جاورها من القحط والجوع، بعد أن خطط لهم سبل التدبير(8).
صورة الصبر السلبي:
حثّ القرآن الكريم على الصبر الإيجابي، ذلك الصبر المنتج للعاقبة الحسنى، وليس صبر الاستكانة والمهانة، قال الجواهري(9):
سلامٌ على حاقد ثائر && على لاحبٍ من دمٍ سائر
يخـبُّ ويعـلمُ أن الطريـق && لابـدّ مـفـضٍ إلـى آخـــــر
وليس على خاشع خانع && مقيمٍ على ذُلّةٍ صابرِ
عفا الصبر من طَلَل داثرِ && ومن متجرٍ كاسدٍ بائرِ
يغلُّ يدَ الشعبِ من أن تُمَدَّ && لكسرِ يدِ الحاكمِ الجائرِ
فصورة الصبر السلبي والتقاعس عن طلب الحق، وتقويض عرى الباطل، هي صورة قرآنية حثت المؤمنين على الابتعاد عن توظيفها في الحياة الدنيا، قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا»(سورة النساء: 97).
صورة القيامة:
تناول الشعراء كثيرا من صور القيامة وهولها في أشعارهم، خاصة تلك المتعلقة بالحرب ولأوائها، قد استعان الرصافي بتلك الصورة القرآنية في وصف الحرب الإيطالية الطرابلسية، بقوله:
سوف نكسو الحرب ثوبا && لونه أحمرُ قانِ
فتكون الأرض منها && وردة مثل الدهانِ
قد أظلتْها سماءٌ && من شواظٍ ودخانِ(10)
إذ جعل آثار الحرب، وما خلفته على الأرض من دماء، شبيها بشكل السماء يوم القيامة، حين تكون حمراء مذابة كدهن الزيت(11)، كما ورد في القرآن الكريم: «فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ»(سورة الرحمن: 37).
أمّا شاعر النيل حافظ إبراهيم، الذي امتاز في شعره بالبساطة والوضوح والثقافة الإسلاميَّة العميقة، فقد نهل من معين القصص القرآني وظهر ذلك جليًّا في (قصيدة الشمس) التي سرَد فيها جوانب من قصَّة سيدنا إبراهيم (عليْه السَّلام) مستلهمًا النَّصَّ القرآني الكريم في قوله تعالى: «فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُّ الآفِلِينَ * فَلَمَّا رَأَى القَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ القَوْمِ الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ»(سورة الأنعام: 76 – 78).
وقد مهَّد شاعر النيل لهذه الصورة القرآنية ببيْتين من الشعر، صوَّر فيهما ظهور الشَّمس، ثمَّ كيف أنَّ النَّاس قد انبهروا بها عند بزوغِها في كلّ صباح، فتطرَّق بعضهم إلى عبادتها وتفضليها على القمر الذي لا يفوقها شعاعًا وضياءً، فيقول:
لاحَ مِنْهَا حَاجِبٌ لِلنَّاظِرِينْ && فَنَسُوا بِاللَّيْلِ وَضَّاحَ الجَبِينْ
وَمَحَتْ آيَتُهَا آيَتَهُ && وَتَبَدَّتْ فِتْنَةً لِلعَالَمِينْ
ثمَّ انتقل بعد ذلك إلى جوهر القصيدة مصوِّرًا صراع سيدنا إبراهيم (عليه السلام) بين الشَّكّ واليقين والحيرة والتردّد وصولاً إلى الخالق (عزَّ وجلَّ) فيقول:
جَالَ إِبْرَاهِيمُ فِيهَا نَظْرَةً && فَأُرِي الشَّكَّ وَمَا ضَلَّ اليَقِينْ
قَالَ: ذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَتْ && قَالَ: "إِنِّي لا أُحِبُّ الآفِلِينْ"
وَدَعَا القَوْمَ إِلَى خَالِقِهَا && وَأَتَى القَوْمَ بِسُلْطَانٍ مُبِينْ
رَبِّ إِنَّ النَّاسَ ضَلُّوا وَغَوَوْا && وَرَأَوْا فِي الشَّمْسِ رَأْيَ الخَاسِرِينْ
خَشَعَتْ أَبْصَارُهُمْ لَمَّا بَدَتْ && وَإِلَى الأَذْقَانِ خَرُّوا سَاجِدِينْ
نَظَرُوا آيَاتِهَا مُبْصِرَةً && فَعَصَوْا فِيهَا كَلامَ المُرْسَلِينْ(12)
صورة الظلمات:
وعن هذه الصورة تقول غادة السمان في قصيدتها (وها أنا أنساك)(13):
مرة.. كان حبك
وكان حبك شراع مركب الفرح العتيق
ورحيلا من نهر ظلمات البحر والدم
إلى جزر الدهشة وصحو مطر النجوم
وهي صورة قرآنية وردت في قوله تعالى: «أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ»(سورة النور: 40).
نلحظ من تجليات الصورة القرآنية في النصّ الأدبي لا سيما الشعري منه، أنها جاءت على مستويات شتى من المفردة إلى التركيب إلى التضمين والاقتباس بكل أنواعه لخدمة المعنى الشعري ودلالته وتقويته، في صورة حُبلى بالانسجام والتناغم بين النص والتلقي التائق إلى ترجمة الصورة ترجمات عدة متخيلة عبر المحسوسات المدركة، وهذا يدلّ على قدرة الشاعر على هضم النصّ القرآني، وتجسيده حيا متقدا في بنية القصيدة.
إنّ استحضار الصورة القرآنية بما تضمّ من قصص وشخصيات وملامح عقائدية كان لها الأثر البليغ في تنمية الشعر على استنهاض التلقي الحيّ، وإعادة ترجمته إنسانيا بما ينسجم مع الروح القرآنية الداعية إلى الحب، والإنسانية، والمثل العليا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أثر القرآن في الشعر العربي الحديث، شلتاغ عبود شرّاد، ط1، 1408هـ-1987م، دار المعرفة، دمشق-سوريا، ص187.
(2) المصدر نفسه: ص188.
(3) في الطريق إلى القلب، نوفل الحمداني، دار الشؤون الثاقافية العامة، بغداد – العراق، ط2، 2014م، ص105.
(4) نوفل هادي محمد الحمداني، شاعر عراقي، ولد في مدينة الحلة عام 1974م، درس البكلوريوس في اللغة العربية في الجامعة المستنصرية، ويعمل مشرفا تربويا.
(5) يُنظر: الشخصية القرآنية في الشعر العراقي المعاصر، غفران علي كاظم (رسالة ماجستير)، جامعة كربلاء، كلية العلوم الإسلامية، قسم اللغة العربية، ص10.
(6) علي كاظم حسن الفتال، شاعر عراقي من مواليد 1935م، ولد في كربلاء، وتوفي عام 2020م.
(7) الأعمال الشعرية، علي الفتال: ج3، ص227-234.
(8) يُنظر: الشخصية القرآنية في الشعر العراقي المعاصر، ص10.
(9) أثر القرآن في الشعر العربي الحديث: 43، ويُنظر: الديوان: 4/ 91.
(10) ينظر: الديوان، مج2، ص481، والشواظ: اللهب الخاص.
(11) أثر القرآن في الشعر العربي الحديث: 121.
(12) قصيدة الشمس، لشاعر النيل/ حافظ إبراهيم، مجلة العربي، العدد 425، أبريل عام 1994، ص 176.
(13) ديوان: (أعلنت عليك الحب): 77.
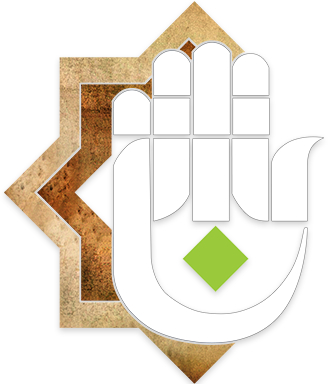


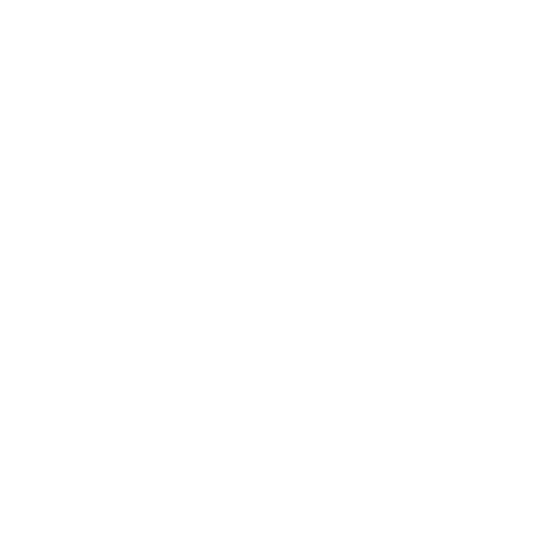
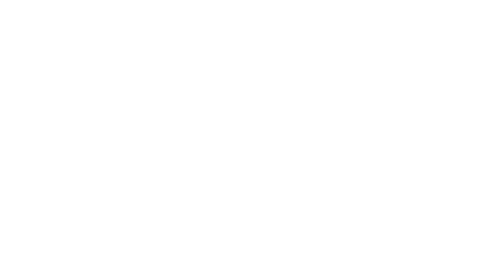
 تقييم المقال
تقييم المقال



