في مشهدٍ دولي يعيد ترتيب قواعد الأمن والسياسة، تبرز تجربة أوكرانيا كدرسٍ قاسٍ في هشاشة الضمانات الدولية حين تغيب عنها أدوات الردع. ففي ديسمبر عام 1994، قررت كييف، بموجب مذكرة بودابست، التخلي عن ترسانتها النووية مقابل ضماناتٍ على سيادتها وسلامتها الإقليمية من قِبَل روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. كان ذلك آنذاك امتحانًا للثقة في الدبلوماسية الدولية، غير أنّ الوقائع اللاحقة كشفت أن العهود التي لا تستند إلى قوة تنفيذية تتحوّل سريعًا إلى وعودٍ ورقية تُطوى عند أول اختبار حقيقي.
الأمن في السياسة الدولية لا يُقاس بعدد الاتفاقيات، بل بقدرة الدولة على فرض احترام إرادتها وحماية مصالحها. وحين تخلّت أوكرانيا عن رصيدها النووي، خسرت أحد أهم عناصر الردع التي كانت توازن بها القوى الكبرى. وما تلا ذلك من ضمٍّ للقرم وتصاعدٍ للتدخلات العسكرية لم يكن نتيجة إخفاق القانون الدولي فحسب، بل ثمرة مباشرة لغياب أدوات الردع التي تفرض كلفةً حقيقية على من يخرق الالتزامات.
في هذا السياق، تتضح أدوار الفاعلين الدوليين. روسيا تحركت من منطلق استعادة أدوات النفوذ الكلاسيكية لحماية مجالها الحيوي، بينما الغرب، ممثلاً بالولايات المتحدة وأوروبا، اكتفى بإداناتٍ ودعمٍ محدودٍ لم يرتقِ إلى مستوى الحماية الفعلية. المسألة هنا ليست مؤامرةً بقدر ما هي واقع السياسة الدولية التي تُدار بمنطق المصلحة، إذ تتحدد المواقف بناءً على كلفة التدخل ومردوده، لا على الالتزامات الأخلاقية أو القانونية.
قصة صفقة “التوماهوك” التي أُثيرت في أوساط النقاش العسكري تعكس جانبًا آخر من السطحية في معالجة قضايا الأمن. فصواريخ “توماهوك” ليست مجرد منظومة تسليحٍ يمكن تسليمها وتشغيلها فورًا، بل تتطلب منظومات إطلاق بحرية وغواصات ومنصات وبنية تحتية متكاملة وتدريبًا طويل المدى. أي أنّ إدخالها إلى ساحة قتالٍ جديدة يعني إشراك الجهة المزوِّدة في صراعٍ مباشرٍ سياسيًا وعسكريًا. لذا، فإن أي عرضٍ لتبادل تكنولوجيا الطائرات المسيّرة أو منظومات تسليحٍ متقدمة بمثل هذه الصواريخ يتجاهل الحسابات الواقعية ويقفز فوق منطق الردع المتوازن الذي تحكمه اعتباراتٌ تتجاوز الرغبة في الدعم.
التردد الأميركي في تسليم هذه المنظومة يعكس تلك الحسابات الدقيقة؛ فالمخاطرة بسمعة سلاحٍ استراتيجي بُنيت سمعته على عقودٍ من التجارب مقابل اختباره أمام منظومات دفاع روسية متقدمة مثل S-400 وS-500، قد يترتب عليها خسائر سياسية واقتصادية في سوق السلاح العالمي. وعليه، لم يكن الحذر الأميركي مجرد تحفظٍ سياسي، بل كان قرارًا مدروسًا لتجنّب مواجهةٍ قد تُضعف الردع الأميركي ذاته وتفتح الباب أمام منافسين جدد في سوق التسلّح.
هذه المعطيات تُعيدنا إلى جوهر الفكرة: الضمانات التي لا تستند إلى قوة تنفيذية ولا إلى توازن ردعٍ واقعي تظل عرضةً للانتهاك. فحين تُوقّع المعاهدات لحماية الدول الصغيرة، لكنها لا تمتلك وسائل الردع اللازمة، يصبح القانون الدولي إطارًا رمزيًا أكثر من كونه آليةً فعّالة لحماية السيادة. وهنا تتجلّى الرسالة الأوكرانية للعالم: الثقة بالضمانات الخارجية دون امتلاك قدرة دفاعٍ ذاتية قد تكلّف الدولة استقلالها السياسي وموقعها الاستراتيجي.
صورة الرئيس زيلينسكي في هذا السياق تُقدَّم كرمزٍ لتجربة سياسية معقدة أكثر منها شخصية. وُصف أحيانًا بأنه متسرّع أو سطحي في تعاطيه مع الملفات الأمنية، لكن قراءةً متأنية تضع تحركاته في سياق ضغوطٍ هائلة داخلية وخارجية، حيث تفرض عليه ظروف الحرب موازنةً صعبة بين الحاجة الملحّة للدعم الخارجي وبين تجنّب تصعيدٍ غير محسوب قد يقود إلى مواجهةٍ شاملة.
تجربة أوكرانيا، بكل ما تحمله من دلالات، تُقدّم للعالم دروسًا في ضرورة بناء الردع الذاتي بدل الركون إلى وعود الخارج. فالاعتماد على القوى الكبرى قد يوفر دعمًا سياسيًا وتقنيًا مرحليًا، لكنه لا يمنح ضمانًا دائمًا أمام تبدّل موازين المصالح. في النهاية، تبقى القدرة الوطنية على الردع، واستقلال القرار في التسليح والتحالف، هي ما يحدد موقع الدولة في خريطة النفوذ. ومن لا يمتلك أدوات القوة، يتحول مع الوقت إلى ورقةٍ في لعبة الآخرين، مهما كانت الضمانات التي يحملها موقَّعة ومختومة.
إن خلاصة الدرس الأوكراني لا تحتاج إلى تكرار: العالم لا يحترم الضعف، والمعاهدات بلا ردعٍ تُنسى سريعًا، ومن يراهن على حمايةٍ من الخارج قد يجد نفسه يومًا في مواجهة المصير ذاته الذي واجهته كييف. وحتى في ظل الصراع الدائر اليوم، تبقى الحقيقة واحدة: السيادة لا تُمنح، بل تُصان بالقوة، والعلاقات الدولية ليست سوى موازين نفوذٍ تُكتب بلغات المصالح لا الوعود.
أما ما نراه من تجاربٍ متكررة في مناطق أخرى، ومنها ما شهده المجال الجوي للكيان الصهيوني من اختراقاتٍ عبر مسيّراتٍ مجهولة المصدر، فيذكّر بأنّ الردع الحقيقي لا يتحقق بالشعارات ولا بالتحالفات، بل بامتلاك الإرادة والتقنية والقدرة. ومن لا يملك هذه الثلاثة، سيبقى محكومًا بإيقاع الآخرين مهما علت شعاراته السياسية.




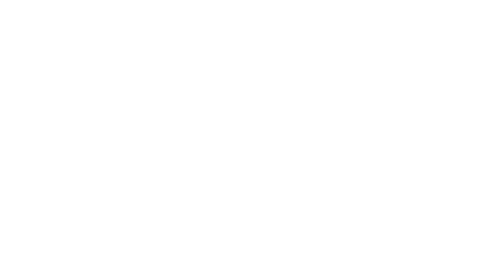
 تقييم المقال
تقييم المقال


