ليست السيدة زينب بنت عليّ شخصيةً عابرة في التاريخ الإسلامي، ولا مجرد اسم يُستحضر في مواسم الحزن والذكرى، بل هي مدرسة قائمة بذاتها في الوعي، والثبات، وقوة الكلمة. إنها المرأة التي وقفت في قلب العاصفة، وحملت الرسالة حين ظنّ الظالمون أنهم دفنوها مع الأجساد.
وُلدت السيدة زينب في بيت النبوّة، وترعرعت في مدرسة الأخلاق التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله، فنهلت من علمه، وتشربت من خُلقه، وتكوّن وعيها على يد علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء. لذلك لم تكن مواقفها في كربلاء وما بعدها وليدة لحظة انفعال، بل ثمرة تربية عميقة وإيمان راسخ.
في كربلاء، سقط الرجال واحدًا تلو الآخر، وبدا المشهد وكأن الباطل قد انتصر بالقوة والسيف، لكن زينب كانت تدرك أن المعركة لم تنتهِ هناك، وأن السيوف قد تُسقط الأجساد، لكنها لا تُسقط القيم، فحين أُريد للحق أن يُسبى، وقفت زينب لتُحرّره بالكلمة، وحين أُريد للصمت أن يسود، جعلت من خطابها زلزالًا هزّ عروش الطغاة.
لم تكن خطبتها في الكوفة ولا في مجلس يزيد صرخة غضب فقط، بل بيانًا سياسيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا، أعاد تعريف النصر والهزيمة، علّمت الناس أن النصر ليس في الغلبة العسكرية، بل في بقاء المبدأ، وأن الهزيمة الحقيقية هي خسارة الضمير. قالت، بوعي الواثق: “ما رأيتُ إلا جميلًا”، جملة تختصر فلسفة الإيمان حين يواجه أقسى الابتلاءات.
السيدة زينب ليست رمزًا للحزن وحده، بل رمزًا للمسؤولية، فهي لم تكتفِ بالبكاء على المأساة، بل حوّلت الألم إلى مشروع وعي، والدمعة إلى موقف، والمصيبة إلى رسالة خالدة. من هنا، فإن استذكارها لا يجب أن يكون طقسًا عاطفيًا فقط، بل مراجعة صادقة لمواقفنا: أين نقف حين يُظلم إنسان؟ وماذا نفعل حين يُحرّف الحق؟ وهل نملك شجاعة الكلمة كما امتلكتها زينب؟
في زمننا المعاصر، حيث تتعدد أشكال الظلم، وتتنوع أدوات التضليل، تبدو السيدة زينب أكثر حضورًا من أي وقت مضى، حضورها ليس في التاريخ فقط، بل في كل امرأة ترفض الصمت عن الحق، وفي كل إنسان يختار الكرامة طريقًا مهما كان الثمن.
إن زينب لم تكن بطلة لحظة، بل ضمير أمة. ومن يفهم زينب، يفهم أن كربلاء لم تكن نهاية قصة، بل بدايتها.




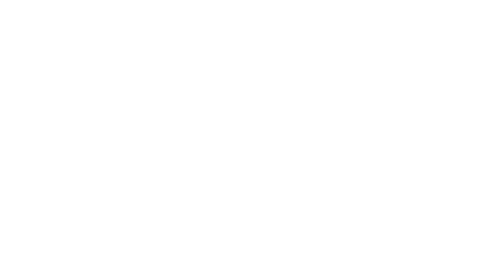
 تقييم المقال
تقييم المقال


