هل يمكن للقلوب أن تنسى من كُتِب لها حبّهم في اللوح قبل أن تُخلق؟
إنّ حبّ أهل البيت (عليهم السلام) ليس دعوى تُقال، ولا شعارًا يُرفع، بل هو سرّ قديم يسكن الفطرة، ويَظهر في لحظة صدق، حين تُزاح طبقات الغفلة والغبار عن القلب، ليس عجيبًا أن نجد هذا الحبّ متأصلًا حتى في أفئدة من لم يعرفوا تاريخهم، لأنّ العلاقة ليست بين أسماء وأتباع، بل بين أنوارٍ ومصابيح قُدِّر لها أن تضيء الدرب لمن يريد الوصول، لقد نزل الوحي على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بأمرٍ واضح: (قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودّة في القربى)، وليس من عادة الأنبياء أن يسألوا الناس أجرًا، لكنّ الله هنا أراد أن تكون المحبّة في القربى هي صمّام الأمان، وبوصلة الهداية بعد ختم الرسالة.
إنّ حبّهم لا يحتاج إلى تبرير، ولا يخضع لمبدأ (لماذا)؛ لأنه من فطرة الله التي فطر الناس عليها، كيف يُسأل عن حبّ عليٍّ من رأى شجاعته وعدله؟ وكيف يُستغرب التعلّق بالحسين وقد رأيت دمه يسقي كربلاء من أجل أن تبقى الصلاة ويبقى الدين؟
بل إنّ المرء ليتحيّر: إن لم نحبّهم… فمن نحبّ إذن؟ من أحقّ بالاتباع من زهدهم وصبرهم وعلمهم؟ من أقدر على لمس جراحنا مثل من ذاق كل الجراح ولم يتخلّ عن الله طرفة عين؟!
لقد حفظت لنا الأحاديث أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يقول: (حسينٌ منّي وأنا من حسين)، ولم يكن هذا الكلام مجرّد عاطفة جدّ لحفيده، بل إعلان صريح أن بقاء الرسالة مرهون ببقاء ذلك الدم الشريف، الذي لم يُسفك عبثًا بل كان الموجة التي أيقظت ضمير الأمة من بعد سُبات طويل.
حبّ أهل البيت ليس موقفًا عاطفيًا فقط، بل هوية وجودية، من أحبّهم صار شبيهًا بهم في فعله، في كرمه، في حيائه، في رفضه للظلم. وإنّ من أكبر البلايا أن يتحوّل هذا الحب إلى مناسبة موسمية، أو تذكار يُذكر ثم يُنسى، بينما حقيقته أكبر من الزمان والمكان، إنّهم لم يكونوا رجال تاريخ، بل أعمدة نور حيّة، تستنير بها القلوب، وتشتد بها العزائم، ويثبت بها المؤمن حين تزل الأقدام.
فليُسائل كلّ واحد منا نفسه بصدق: ماذا يعني أن أحبّ عليًا؟ هل يعني أن أمدحه؟ أم أن أسير على بصيرته؟ وماذا يعني أن أعشق الحسين؟ هل هو البكاء عليه فقط؟ أم هو الوقوف حيث وقف، والصمت حيث سكت، والصراخ حين سكت الناس؟ إنّ الحبّ الحقيقي لا يقف عند الشعور، بل يتحوّل إلى تربية، إلى منهج، إلى سلوك، إلى أمانة نُحملها أمام الله.
ولعلّ أعجب ما في هذا الحبّ، أنّه كلّما زاد، زاد معه العطش لا يُشبع ولا يُملّ، لأنّه ببساطة: حبّ من لا تنتهي فضائلهم، ولا يُحدّ كمالهم، ولا يُضاهى نقاؤهم من ذاقه عرف، ومن عرفه لم يطلب غيره، ومن لم يعرفه… عاش قلبه ناقصًا وإن ملك الدنيا بأسرها.
فالسؤال الذي يُطرح في آخر هذا المقام، ليس (لماذا نحبّهم؟)، بل السؤال الذي لا بدّ أن يُقال: كيف للمرء أن يعرفهم… ثم لا يحبّهم؟




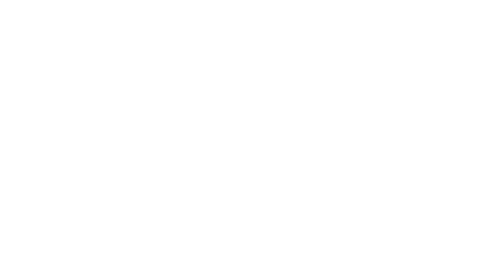
 تقييم المقال
تقييم المقال


