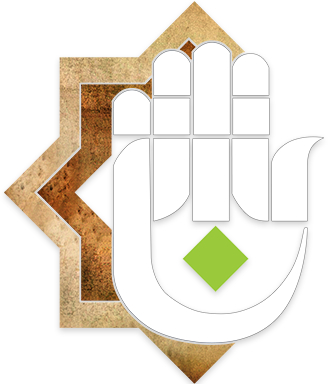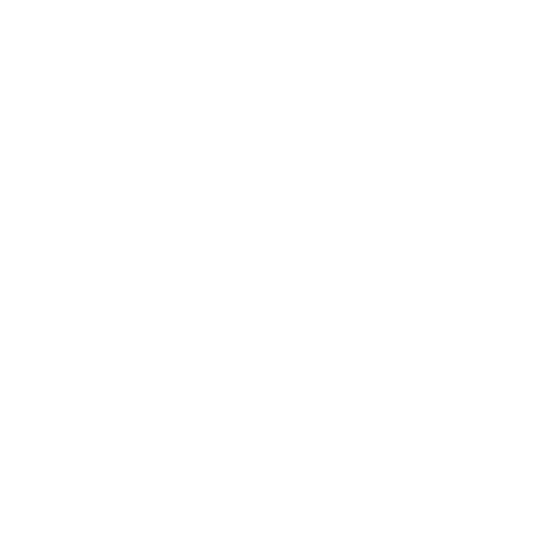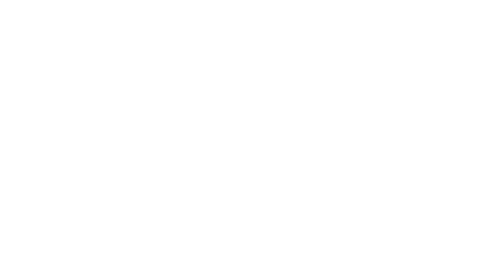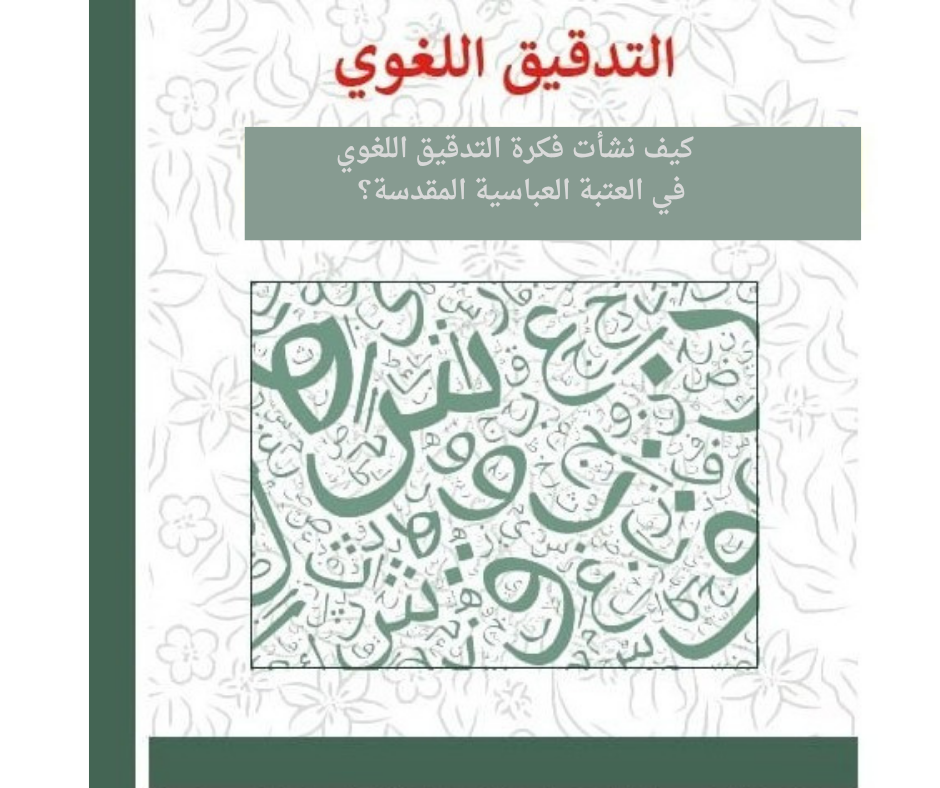يعدّ النهوض باللغة العربية الفصحى، والحفاظ على مكانتها الفكرية والثقافية والتاريخية والحضارية، أمنية كل مثقف ودارس ومهتم بقضايا أمته، وشؤون علوّها وسموها، فهي حلقة الوصل بين تاريخنا العريق وموروثنا الحضاري، والأجيال اللاحقة التي بات يُخشى عليها الانفلات من معين هذا المسار الخضل؛ جراء تزاحم اللغة العامية المحكية، وتزايد اللهجات داخل اللغة الأم، وصعوبة تعلم قواعد النحو والصرف والإملاء العربي، من قبل شبابنا وأجيالنا المعاصرة؛ نتيجة غزو الأجهزة الحديثة، ومواقع التواصل بكثير من المفردات والمصطلحات الهجينة التي لا تقيم للفصحى وزنا.
ويتسم دور المختصّ باللغة العربية بأهمية بالغة في الوسط الإعلامي والأكاديمي؛ باعتباره مجالاً ناطقاً بلسان الأمة ومدى تحضرها، وارتباطها الوثيق بهويتها وانتمائها، الأمر الذي أضاف مسؤوليات مضاعفة على المصحّحين اللغويين على مستوى النتاج (المقروء والمرئي والمسموع)، وبات إعلامنا العربي بحاجة إلى دورات مكثفة في مهارة التدقيق اللغوي؛ نظراً لكثرة الأخطاء المنتشرة سواء كتابياً أو شفهياً، والأخطاء تتنامى كلما تساهلنا في نشر أو إذاعة نصوصنا الأدبية والاخبارية دون مراجعة وتمحيص، حتى ينشأ جيل بعيد عن الجيل الأول من حماة اللغة العربية الفصحى ورعاتها الأفذاذ، لذا صار لزاماً وأمراً حتمياً علينا كعرب ومسلمين ومهتمين بكل متعلقات ديننا ونصوصنا الإبداعية منذ فجر التاريخ العربي، أن نسعى للحفاظ على لغتنا من كل شائبة وتداخل للمفردات الأجنبية والاصطلاحية معها، ومن كل ما يشوبها من لحن ولهجات عامية دخيلة، فكان لنا هذا الحوار مع الأستاذ هاشم الصفار(1) المدقق الأول في العتبة العباسية المقدسة؛ ليستعرض لنا كل ما يتعلق بالتدقيق اللغوي، ومدى تأثيره على إصداراتنا الإعلامية والثقافية.
س_ ما هو مفهوم التدقيق اللغوي؟
التدقيق اللغوي هو التفكر وإعمال الذهن في النصوص الخبرية والثقافية والأدبية، ورصد الأخطاء الصرفية على مستوى بنية الكلمة، والنحوية على مستوى التركيب، فضلًا عن اختيار اللفظ الموافق للمعنى السياقي، ورفض ما هو شاذ وغير مأنوس، والعمل على منع استعمال المفردات العامية أو المستهجنة، وهي حالة طيبة أن نستشعر الخطأ، فلا تتقبله ذائقتنا اللغوية والبلاغية والجمالية، فنعمد إلى تصحيحه وتغييره قدر الإمكان، حتى وإن لم نكن مصحّحين مختصين، وهي مَلَكة يتحلى بها كثير من القرّاء والأدباء بمختلف مستوياتهم الثقافية. وكم لاحظنا انهيار موضوعية النصّ وفكرته وأسلوبيته؛ جراء كثرة أخطاء النصّ التي باتت تشكل هاجساً مقلقاً مُغيّباً لمعالم النص وجماليته، وحتى أهدافه التوصيلية.
نعم، هناك من المصحّحين من يكتفي بتدقيق اللغة إملاء وصرفاً ونحواً، وهناك من يرى أن من واجبه الإسهام - فضلاً عن التدقيق - في أن يأخذ النصّ منحىً جمالياً أبهى وأروع، فلا ضير إن تدخل المدقق في وضع بعض اللمسات التي تزيد النصّ إضاءة، خاصة في تعديل العنوان (ثريا النصّ)، أو كتابة مقدمة أدبية، أو استخلاص بعض (المانشيتات) المهمة. ويبقى مفهوم التدقيق اللغوي واسعًا وموسوعيًّا، ويدخل في كثير من محاور اهتماماتنا الفكرية والثقافية والدراسية، فضلًا عن مساعيه للحفاظ على اللغة العربية الفصحى، وحرصه عليها، وعلى كونها أداة ربط بين تاريخنا وحاضرنا، وهذا يلخص أهمية التدقيق اللغوي ودوره الفاعل في حياتنا الثقافية عموماً، فهو يشذّب خياراتنا التدوينية، وينقّح أفكارنا وأسلوبنا؛ فاللغة وعاء الفكر، وعلينا العناية بذلك الوعاء ذائقة وجمالاً، بحيث يخرج نصّنا ونتاجنا المعرفي مُعافى إلى درجة ما من الخلل الصرفي والنحوي وحتى البلاغي في مراحل متقدمة.
س_ ما هي أفضل طريقة لممارسة رصد الأخطاء اللغوية من قبل الكتاب والصحفيين؟
أفضل طريقة هي عرض مجموعة من النصوص المغلوطة، ثم تصويبها؛ فالمناهج اللغوية ركزت على القواعد (صرفه ونحوه) دون التركيز على المطالعة التي تعدّ البوابة الأفضل لتمكين الطالب من القراءة الصحيحة، ومعرفة مكامن الخطأ من الصواب، ونلاحظ في الأسئلة الامتحانية كثيراً ما يرد سؤال: اعرب ما يأتي؟ الطالب لا يتجاوب مع هذا النوع من الأسئلة بنسبة كبيرة، ربما التشويق الأكثر تحبيباً لنفسه هو السؤال عن: اضبط النصّ الآتي بالشكل، أو أعد صياغة العبارات التالية مصحّحاً ما فيها من أخطاء، أو أكمل النصّ بما يناسبه من بين الأقواس، وتدريجياً سيمتلك الطالب حتى بعد تخرجه مَلكة التصحيح اللغوي الجيد، والصياغة الأدبية الرصينة.
س_ هل تقلّل الأخطاء اللغوية من قيمة النصّ؟
تتهاوى قيمة النصّ إن كثرت فيه الأخطاء، وانحرف المعنى المقصود عن مبتغاه، فلا سبيل لنشر النصوص إلا بعد مراجعتها وتنقيحها لغوياً، فكثرة النشر مع ما فيه من أخطاء لا يصبّ في مصلحة الإصدار، ولا في مصلحة الكاتب أبداً، بل مع الوقت يعزف عنه القراء؛ فالنفوس جُبلت على الجمال والكمال، والأخطاء نقص، وهي تمارس لعبة الغواية لصرف المتلقي عن غاية النصّ، وفكرته الرئيسة البنّاءة؛ فالأخطاء اللغوية، والصياغة الضعيفة، تسلبُ النصوصَ بريقَها وروعتها، وتشغل القارئ عن مضمونها الجمالي، ورصانة فكرتها، وتصرفه للوقوف على ركة التعبير، وغياب الربط بين التراكيب المسهمة في وحدة النص وجزالته.
س_ كيف نشأت فكرة التدقيق اللغوي في العتبة العباسية المقدسة؟
نشأت فكرة التدقيق اللغوي في شعبة الإعلام، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، وحدة جريدة صدى الروضتين، عام 2007م، برعاية وتوصية من سماحة العلامة السيد أحمد الصافي (دام عزه)، وبإشراف السيد ليث الموسوي (دام تأييده)؛ وذلك بعد إنتاج فيلم العرين للكاتب الأديب علي الخباز، ومن إنتاج الأستاذ دريد سلمان داود، وكانت فيه أخطاء لغوية بعد قراءته الأولى، فارتأى سماحته مسألة الرقابة اللغوية للخروج بأفلامنا الوثائقية وإصدارتنا المباركة عمومًا بأبهى صورة على مستوى ضبط النص، والصياغة، والإخراج الفني، والطباعة الراقية، فعملنا على ضبط نص فيلم العرين لغويًّا، ثم الاستماع إليه في استوديو المهندس أحمد العويدي، والحمد لله خرج العمل موفقًا ببركة المولى الواهب حامي عرين الطفوف أبي الفضل العباس (عليه السلام)، وبفضل تشجيع العتبة المقدسة للطاقات الشبابية الواعدة لبناء إعلام هادف ورصين، وتوفير كل إمكانات النجاح. ثم توالى العمل في صدى الروضتين الغراء منذ العدد (62) وإلى الآن ونحن على مشارف العدد (520)، تخلله الاحتفال بالأعداد الخاصة على رأس كل مئة عدد، وفيها قراءة وتحليل لكل صفحات الصدى، وما جاء فيها من مواضيع، مثل: صفحة أخبار وتقارير، وصفحة رؤى، والمديات الأدبية، والآفاق التربوية، وقراءة في الصفحة الأخيرة، وغيرها.
حمد الصافي
س_ ما هي صلاحيات المدقق في معالجة النصوص، رؤية النصوص، ضعف الأسلوب، إخفاقات الكاتب من حيث الحذف والإضافة، أم أن عليه العناية باللغة فقط؟
يجب أن لا ننسى أن اللغة أداة توصيلية، وذائقة جميلة، وأسلوب حياة، نعبّئ فيها أفكارنا وآراءنا، ونتواصل عبرها مع مَنْ هم على شاكلتنا أدباً وثقافة وعقيدة، وكذلك مع من يخالفوننا، فتختلف لغة الطرح مع كل تنوع في نوع التلقي وجنسه وميوله، وهذه الأداة كيف نراها، وكيف نحب أن تظهر بالشكل اللائق؛ فاللغة إن كانت غير جيدة، يكون التوصيل غير جيد وبطيء، وبه محاذير كثيرة. أما كيفية استعمال المفردات المناسبة لما نريد أن نصل إليه ونوصله للمتلقي، يكون بحسب مطابقتها لمقتضى الحال، فلكل مقام مقال. أمّا صلاحية المدقق في معالجة النصوص تكمن في إيجاد التخريج المناسب لكل حالة لغوية تعترضه؛ فالبوصلة التدقيقة تعمل على إيجاد التأويلات والمبررات والتقديرات المناسبة التي تحوّل النص الإعلامي أو الأدبيو الأدبي إلى مادة مقبولة مأنوسة للمتلقي، فضلًا عن عملها بما أوتيت من صلاحية وثقة من المؤسسة أو الجهة التي تنتمي إليها على تغيير ما تراه مناسباً، نعم قد يكون الكاتب معنيًّا على المستوى الشخصي بتغيير ما يكتب، وإعادة ضبطه من الناحية اللغوية (صرفاً ونحواً)، من باب السعي للتكامل المعرفي، خاصة في حالات النشر الإلكتروني ومواقع التواصل التي لا يتسنى معها الكاتب دائما إلى استشارة المدقق اللغوي، ولكن في حالات النشر في الصحف والمجلات تكون الجهة الإعلامية هي المختصة بتخريج المقال خاليًا من الأخطاء اللغوية، فمن المفترض أن يكون التدقيق شاملاً للمناحي اللغوية، الصرفية منها والنحوية، وكذلك للمنظور الجمالي والبلاغي للنصّ، فلا يمكن أن يكون التدقيق مُضعِفاً للنصّ، بل تهذيب للنصّ وتطويره، وهي مرحلة يبلغها الرقيب اللغوي إن أتيحت له الحاضنة الإبداعية التي ترعاه، وتوجّهه نحو سلّم النجاح في ميدان التدقيق، وميدان الإسهام التدويني الفاعل والمؤثر.
س_ هل هناك فرق بين تدقيق المنشور الثقافي للعتبة المقدسة والتدقيق الأكاديمي للبحوث الأكاديمية من حيث المرونة، ومن حيث وحدة الموضوع، ومتطلبات النشر؟
بطبيعة الحال هناك سمات أساسية ينبغي أن يتحلى بها من يلج مضمار الإعلام مدققاً ومنقحاً ورقيباً لغوياً، منها: امتلاك صلاحيات التغيير المناسب وليس المزاجي، ولا ضرورة لأخذ رأي الكاتب حول كل تغيير، أما الكاتب، فهو يرمي إلى نشر آرائه وأفكاره وثقافته للناس، بطريقة لا يرى فيها أن نصّه مقدس لا يقبل التصحيح والتعديل، بل يرى أن المؤسسة الإعلامية لها من الأدوات المهنية والفنية بحيث يطمئن معها إلى مرور نتاجه إلى المتلقي بشكل جميل ومتسق ومنمّق.
أما الأحاديث والمرويات والتحقق من مصادرها، فهي تقع على عاتق الكاتب الذي يكون بحاجة لترصين موضوعه؛ لكيلا يُتهم بأنه يتحدث جزافًا بخلاف المتعارف من المصادر والروايات الصحيحة، وبعدها على المدقق أن يتأكد - تبعاً لذلك - من بعض الروايات والأحاديث الشريفة الواردة في المقالات - إنْ راوده الشك في بعض مضامينها لغة وتفسيراً - وليس له إرجاع النصّ للكاتب إن ظهر أن نصّ الحديث أو الرواية غير موجود، بل عليه حذف الحديث أو الإتيان بما يناظره بنفس المضمون، وتبقى العملية توافقية تصاعدية بنّاءة بين الكاتب والمدقق، ومن خلال علاقتهما الايجابية يزدهر المنشور والنتاج الخاص بالمؤسسات الإعلامية.
ولكن يمكننا القول: إن تدقيق المنشور الثقافي في إصدارات عتباتنا المقدسة، أو في عموم دور النشر والصحف والمجلات، فيه نوع من المرونة، فلا مطالبة بقائمة للمصادر إلا في حالات قليلة، خاصة في المقالات ذات الطابع الديني التي تكون بحاجة لبعض المصادر الإقناعية لتدعيم حديث ما، أو رواية منقولة، كذلك من حيث القيود المنهجية، والأخذ والإحالات، فلا يُطالب الكاتب دائمًا بتبرير أو حجة أو مصدر لما يقول ويرتأي. أما من حيث وحدة الموضوع ومتطلبات النشر، فقد يكون للمؤسسة الإعلامية وسياستها رأي خاص في نشر بعض المواضيع ورفض أخرى، وهذا يعد خارج إرادة المدقق، وحتى خارج إرادة هيئة التحرير أحيانًا، فقد تُقبل نصوص في فترة ما، وتُرفض أخرى في فترة أخرى، حسب سياسة القائمين على الإصدار، وحسب طبيعة الموضوع، ومدى فائدته للمجتمع، فلا تُنشر المواضيع ذات التماس المباشر بالسياسة، والأحزاب، والطائفية، وغيرها من المواضيع التي ترى المؤسسة الثقافية أو الدينية أنها في غنى عن دخول معتركاتها، وأن توجهاتها العامّة تصب في التثقيف المجتمعي، وتوجيه الناس نحو التحلّي بالعقيدة والأخلاق الفاضلة، وبناء أسرة ومجتمع محصن فكرياً وعقائدياً.
ولا ننسى السمة الأبرز لمدققي الإعلام، هي الاشتراك مع زملائهم في الكتابة والتدوين، فنراهم يؤلفون ويكتبون، وهذه الشراكة تخلق جواً من الألفة المهنية والمعرفية والنفسية، بحيث تسهم إيجابياً في نجاح المنشور.
أما التدقيق الأكاديمي للبحوث الأكاديمية، فهو يخضع لضوابط صارمة من حيث السلامة الفكرية لتلك البحوث، وعدم خروجها عن النسق الذي تصطبغ به الكلية، فإن كانت بحوث الترقية في المجلات الأكاديمية، أو الرسائل والأطاريح المهيأة للمناقشة في كلية إسلامية – على سبيل المثال - يؤخذ بنظر الاعتبار عدم خروجها عن المدونات القرآنية والحديثية ونهج البلاغة وسائر المرويات والمأثورات الإسلامية، وأن تكون منصفة وحيادية، وبطرح علمي لا يسيء لرموز أو مكونات بعينها، وكذا الحال مع ضوابط السلامة اللغوية، والمعايير المنهجية من حيث الإحالة إلى مصادر موثوقة، وعدم سرقة جهود الآخرين من الكتاب والباحثين عن طريق الأخذ المباشر من مؤلفاتهم من دون الإشارة في الهامش إلى المصدر المنقول عنه بالجزء والصفحة والطبعة ودار النشر وبلده وتاريخه؛ فالتنوع الثقافي الذي نراه في الصحف والمجلات، والمساحة الكبيرة من حرية النشر والتعبير التي يتحلى بها الصحفيون والكتاب والأدباء، لا نجده في البحوث الأكاديمية، فهناك مقاييس صارمة تقيد الباحث، وتحيد من عملية الطرح العشوائي، أو تبني الآراء والأفكار من دون الاتكاء على قائلها أو مصدرها الأول.
س_ كيفية إحراز جمالية النصوص الفنية واللغوية؟
لابد من وجود خزين كبير من المفردات اللغوية والتراكيب البلاغية، يمتلكها الكاتب؛ ليكون نتاجه في كل مرة جميلاً ومتنوعاً ومحلى بـ(أل) الجمال والمسحة الأدبية، وكل الأفكار الجميلة والمفردات الساحرة مطروحة في الأسواق -كما يعبّرون- وهي ليست حكراً على أحد؛ فالناس تتواصل عن طريق اللغة، وهي حاضنة المعاني والأفكار، واللبيب المهذب بإحساسه المرهف، يستطيع رسم لوحة فنية جميلة باستعمال لغة مأنوسة ليست بالقديمة الصعبة، وكذلك ليست بالمحكية الدارجة، أو البسيطة السهلة الى حدّ التفريط بجزالة المفردات، وقوة التراكيب، والأبنية اللغوية الرصينة.
س_ هل توجد طرائق محددة للصياغة الصحيحة؟
للصياغة الأدبية والخبرية طرائق متعددة ومتنوعة، وكلٌّ حسب ثقافته وذائقته وأسلوبه، وكلٌّ أيضاً حسب مدخله للنص، والزاوية التي يرى فيها أنها الأفضل في طرح فكرته. وعموماً تعد كل الأساليب جيدة ومطلوبة في حدّ ذاتها، باختلاف شرائح المجتمع وذائقتهم، ولكن تبقى العبارات الأدبية المنمّقة العالية الجودة، المكتوبة بلغة متألقة، خالدة في الذاكرة عبر الأجيال لمدى طويل. وهذه الأساليب لا يمكن تعليمها عن طريق دورات أو ورشات عمل، بل الملكات والمواهب شرط أساسي يتم صقلها بالمتابعة والاهتمام من قبل الأديب أو الصحفي، فورشات طرائق الصياغة الصحيحة للنصّ تُقام لغرض الصقل والتطوير، وليس التعليم، والفرق واضح مع أدنى تأمل؛ فالكاتب يطوّر نفسه عن طريق الدورات وورشات العمل والجلسات النقاشية والأدبية، ولكن لا يمكن تعليم الكاتب كيف يكتب إذا لم يكن كاتباً أصلاً، ولا يمتلك حسّاً كتابياً إبداعياً في قرارة نفسه وروحه. الكتابة حاجة فكرية ملحّة على الفرد، وخلق داخلي يعيشه الكاتب عبر مخاضات وصراعات نفسية وروحية، ومن لا يحسّ ويستشعر معنى الكتابة فلسفياً في نفسه، وذهنه، وطريقة تفكيره، لا يستطيع ولوج هذا العالم المترامي الأطراف، فلكل كاتب رؤية ومسحة جمالية ومنظور يختلف عن الآخر، ولا يمكن قسر تجربة على أخرى، فكلٌّ له طريقته وأسلوبه الخاص.
س_ بما أنك كنت المدقق الأول في العتبة المقدسة، فما هو المنجز أو المساحات التي كنت تعمل بها؟
الانطلاقة الأولى كانت من مجلة صدى الروضتين، فهي الحاضنة الإبداعية التي وفرت لكثير من الكتاب والصحفيين والمخرجين والمصورين فرصة الظهور، وتفجير الطاقات والمواهب، فكانت صدى الروضتين بحق صوتًا رساليًّا هادفًا يسعى لرأب الصدع الذي خلفه الطغاة على مرور العصور، فعملت على تنوع النشر بطرائق تقترب من ذهنية المجتمع، وتجعله ممارسًا حقيقيًّا في عملية البناء الفكري والثقافي. وعلى سبيل التعاونات، حصل التعاون مع ملاكات الانترنت في كثير من مفاصل عملهم الالكتروني، ثم إسهام الصدى في المسرحية الخاصة بالنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) من تأليف وتمثيل الأستاذ علي الخباز، وكانت على خشبة قاعة تابعة للصحن الشريف التي تحولت في ما بعد إلى متحف الكفيل، ثم تدقيق وتقييم النصوص المسرحية في مسابقات المسرح الحسيني، فكانت بحق أيامًا حافلة برؤية ذلك الفتح الذي طال انتظاره، ونحن نرى النهضة الحسينية تُسطر في نصوص حية متقدة بتحليل الخطب والنصوص الحسينية، لا سيما تلك التي ارتقت خشبات المسرح تجسيدًا حقيقيًّا لمفاصل تلك النهضة على مستوى الدمعة والشعيرة والطقس العاشورائي، وقد حضرت مسرحية (الكون كله شجرة)، وأشرفت على سلامتها اللغوية عبر الاستماع لأداء الممثلين فيها، وكان عملًا ناجحًا فيه تطور كبير على كل المستويات يدل على جهود العتبة المقدسة المباركة في هذا المسعى الوضاء، فضلًا عن مستوى القراءات والإضاءات التي أسهمت في تناول الطف من زوايا أعمق وأدق، وكانت مسرحية (على ظلال الطف) من تأليف بارعة مهدي، وإخراج علي الشيباني، العمل الأقرب إلى الورش الإبداعية للصدى ولقسم الشؤون الفكرية والثقافية على نحو عام؛ من حيث الحضور المستمر، ومتابعة العمل، ومن حيث الإنتاج والتداول في تعديل النص، وإضفاء لمسات جديدة، واستمرت البروفات ثلاثة أشهر، فكانت محكًّا حقيقيًّا للشباب الذين مثلوا المسرحية بشكل لافت ومبهر للجميع. ثم جاء الإسهام في تدقيق الإصدارات الخاصة بمسابقة الجود العالمية للقصيدة العمودية بحق أبي الفضل العباس (عليه السلام)، وصدى عاشوراء، وصدى الأربعين، وصدى الرسالة، وصدى النصرة، وكثير من الصديات الخاصة بالمناسبات الدينية، ثم الأفلام الوثائقية التي أنتجتها العتبة المقدسة، مثل: العرين والسرداب ونداء النصرة، وشباك أبي الفضل العباس، وغيرها كثير، والمهرجانات والمسابقات ومجلة رياض الزهراء، والخميس والكفيل، والثغور، وعطاء الشباب، وغيرها، وحتى في الأعمال الخاصة ببقية الأقسام، مثل: المشاركة في التدقيق الأولي على نص التفسير وضبطه بالشكل، ثم الرقابة اللغوية في الاستوديو على التسجيل الصوتي لتفسير القرآن الكريم للسيد عبد الله شبر، وهو من أعمال معهد القرآن الكريم التابع للعتبة العباسية المقدسة، وليس هذا فحسب، بل كانت الصدى حاضرة في متابعة نشاطات العتبات الأخرى، فكانت لدينا صفحة صدى العتبات، وفيها كل ما يخص عتبات العراق المقدسة من فعاليات ومهرجانات ومشاريع التنمية والإعمار.
س_ كيف استطعت التوفيق بين عملك في مجلة صدى الروضتين والمهام التدقيقية الأخرى لسائر الأقسام على مستوى الكتب والبحوث والمجلات والاستوديو والمسرح؟
عملنا في قسم الشؤون الفكرية والثقافية وفي قسم الإعلام يتميز بروح التعاون والعمل الجماعي، فليس هناك توان أو تقاعس عن أداء مهمات تحال على واحد من المنتسبين ويدعي أنه غير موكل بهذا الأمر، فالكل معنيون بتدقيق الإصدارات، وهكذا مع التحرير والإخراج الفني والتصميم والتصوير وكل ما يمت لعملنا الإعلامي بصلة، فقد عملت على تدقيق إصدارات وحدة الطفولة والناشئين، من القصص المنوعة، ومجلة الرياحين في بعض الأحيان، ومجلة حيدرة، كذلك أنشطة وفعاليات الكشافة، وكنت حاضرًا مع الأخوة في شعبة البحوث والدراسات مدققًا لإصداراتهم الدينية، وأيضًا تدقيق عطاء الشباب ورياض الزهراء حين يستدعي الأمر، ولله الحمد اليوم نشهد اكتفاء ذاتيًّا في كل إصداراتنا المباركة من حيث اكتمال الملاكات الفنية فيها.
وقد كنت في خدمة الإخوة في مجلة صدى الروضتين، والأخوات في مجلة رياض الزهراء، في إعطاء الدورات اللغوية، كما أثمرت ورشة العمل الثانية الخاصة بمنتدى القراءة على قسم المكتبة النسوية/ منتدى الكفيل العالمي تحت عنوان (التدقيق اللغوي وأهميته في صياغة النص)؛ إذ صدر لي على إثرها كتاب حمل العنوان نفسه، تضمن كل ما جاء في الورشة من تساؤلات لغوية، ونصائح كتابية، مع بعض الأمثلة في نهاية الكتاب عن الأخطاء اللغوية الشائعة التي يقع فيها الكتاب والصحفيون.
وقد اشتركت بمعية الأخوة في الصدى في اختبار كثير من الصحفيين، والمدققين الذين ولله الحمد تسنموا مهام أعمالهم التدقيقية في أقسام العتبة المقدسة على نحو يليق بمكانة العتبة المقدسة التي أولتهم كل الرعاية والاهتمام، ومنهم الأستاذ لؤي عبد الرزاق الأسدي، والدكتور علي حبيب، والدكتور موفق هاشم، والأستاذ مصطفى كامل، والأستاذ إحسان عدنان، والأستاذ عمار السلامي، والأستاذ محمد جاسم، وغيرهم كثير، فضلًا عن اختبار الأخوات الزينبيات في المكتبة النسوية وإذاعة الكفيل، وكل ذلك بفضل منه سبحانه وبركة أهل البيت (عليهم السلام) أن أتيحت لنا فرصة العمل في هذا المكان الطاهر جنة الله في أرضه، ومن ثم الأخذ بيد الآخرين لينالوا الحظوة عينها؛ لأن سفرة الواهب الهاشمي حامل راية الطفوف لا تقف عند حد معين.
س_ هل كانت هناك أعداد خاصة بالمناسبات؟
أسهمنا في صدى الروضتين في إصدار كثير من الأعداد الخاصة بالمناسبات، مثل: صدى عاشوراء، وصدى الأربعين، وصدى الرسالة، وغيرها كثير، كما لا ننسى صدى النصرة، وكانت عقب الأحداث التي تعرضت لها عتباتنا المقدسة، فكانت صدى الروضتين حاضرة في تنوير المجتمع، وتبصرتهم بما يجري من مؤامرات لا تريد الخير لمقدساتنا، ولا لعراقنا الحبيب، كما أصدرت صدى الروضتين منشورًا خاصًّا عقب تفجيرات المراقد المشرفة في سامراء، حمل عنوان محطات في فاجعة سامراء، من تصميم المرحوم رائد الأسدي، والسيد حيدر ماميثة، وهي مجموعة من المحطات عن تلك الفاجعة الأليمة كانت تُنشر في الصفحة الأخيرة من المجلة جمعت كلها في هذا الكتاب. كما أسهمت صدى الروضتين في سائر المنشورات الفتية الأخرى في بواكير عملها ودعمها بالكتابة والتدقيق والمشورات الفنية، مثل: الخميس، والكفيل، وذكرى، ومجلة رياض الزهراء، والرياحين، وحيدرة، وعطاء الشباب، وغيرها كثير؛ لأن صدى الروضتين أول إصدار لعتباتنا المقدسة خط للأجيال قلادة نور، وأخذت على عاتقها هذه المهمة الرسالية في كونها مؤسسة إعلامية داعمة ومحتضنة لكل المشاريع الفكرية والإعلامية التي تطورت فيما بعد، وأخذت استقلالها التام، مستمدة من إيثار القمر الهاشمي (عليه السلام) تلك الروح المضحية المتفانية في سبيل خدمة أهل البيت (عليهم السلام) وحمل رايتهم التثقيفية عبر الآفاق.
س_ مشاركاتكم في لجان التحكيم وغيرها؟
لم تكن في بداية عمل قسم الشؤون الفكرية والثقافية لجان أكاديمية متخصصة بالمعنى الحرفي، تعمل على تقييم النصوص المشاركة في المسابقات الأدبية التي تنظمها العتبة المقدسة، بل ملاك صدى الروضتين أخذ على عاتقه هذه المهمة، وأشرف على مسابقات عدة، مثل: مسابقة الجود العالمية للقصيدة العمودية في حق أبي الفضل العباس (عليه السلام) في ذكرى وفاة السيدة الطاهرة أم البنين (عليها السلام)، ومسابقة المسرح الحسيني، والقصة القصيرة، والمقالات، وكثير من المسابقات البحثية في مناسبات الأئمة (عليهم السلام).
س_ كلمة أخيرة؟
لقد تشرف العشرات من الصحفيين والكتاب والمصورين والمصممين على مدى عشرين عامًا بالعمل في صدى الروضتين الغراء، وشربوا من معينها الإبداعي، فكانت لهم في ما بعد بصمتهم الواضحة الموفقة في تسنمهم لمهام إعلامية كثيرة، وخدمتهم لمشاريع تطويرية عدة؛ فصدى الروضتين ولادة للإبداع، وانبثقت منها مدارس عدة على مستوى اللغة والأسلوب والقراءات والتصوير والتصميم والإخراج وغيرها. كما شهدت الصدى على مرور سنوات عطائها أقلامًا مبدعة وواعية، وقامت بدورها التثقيفي على أكمل وجه، واذكر استقبال ملاك الصدى لوفود إعلامية كثيرة، منها وفد مركز النور في السويد، ووفد من العتبة الكاظمية المقدسة، حضر للاطلاع على واقع عملنا الصحفي في مجلة صدى الروضتين، وفي قسم الشؤون الفكرية والثقافية، وانبهروا لما شاهدوه من تطور في مفاصل العمل، والحرية التي يتمتع بها المنتسبون في طرحهم ومقترحاتهم وإبراز مواهبهم؛ نتيجة الثقة الكبيرة التي أولاهم إياها القائمون على إدارة العتبة المقدسة، وما لمسوه من حرص وتفان أتى أكله وثماره سنوات من العطاء الذي لم ولن ينضب؛ لأنه معجون بطينة وبركات المولى ساقي عطاشى كربلاء.
شكرًا لمجلة صدى الروضتين على هذه الحوار، وأتمنى لملاكها والقائمين عليها مزيدًا من التقدم والازدهار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هاشم علي كريم الصفار - مواليد مدينة كربلاء المقدسة – العباسية الشرقية – 1972.
- بكالوريوس تربية/ لغة عربية/ الجامعة المستنصرية.
- ماجستير علوم إسلامية/ لغة القرآن وآدابها/ جامعة كربلاء.
- طالب في مرحلة الدكتوراه/ فلسفة في لغة القرآن وآدابها/ كلية العلوم الإسلامية/ جامعة كربلاء.
- كاتب ومدقق لغوي وعضو في كثير من اللجان التحكيمية الخاصة بتقييم البحوث والمقالات والمسابقات الأدبية.
- مدير تحرير مجلة صدى الروضتين لسنوات عدة.
- عضو في نقابة الصحفيين العراقيين.
البريد الالكتروني/ alsaffarhashim4@gmail.com