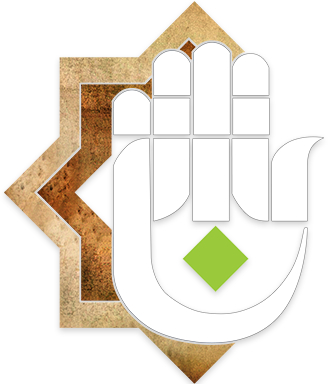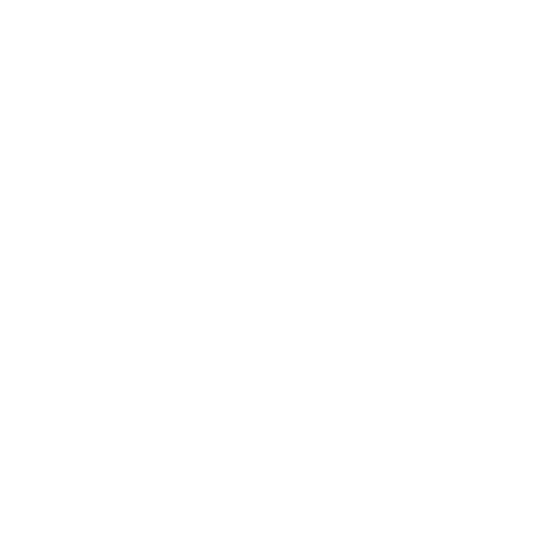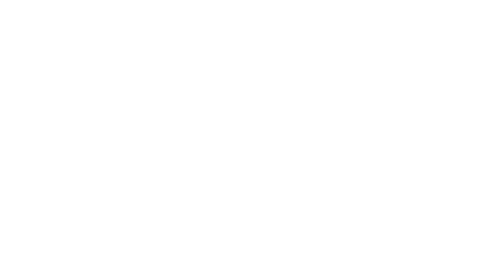عُرف السيد السيستاني (دام ظله) منذ طفولته بحبه للعلم والمعرفة، وتميّز برغبته الكبيرة في قضاء معظم أوقاته مختليا بالكتب والقراءة، لا يُعنى ولا يهتم بالأسفار الترفيهية ولا العلائق والارتباطات الاجتماعية، التي تستهلك الوقت، وتؤثر في الدراسة والتدريس، وتزاحم اشتغالاته المعرفية؛ فهو قليل زيارة المجالس المختلفة، وقليل المزاح، وهمه في أن مجلسه يعمر بالبحث العلمي التحليلي دون شيء آخر، وهذا ما شكل عاملاً مهماً في بناء شخصيته الثقافية، حتى أصبح موسوعة متنوعة المعارف، متعددة الثقافات، ومكتبة متجسدة في شخصه المبارك[1].
ينقل أن السيد السيستاني كان طالبا متميّزا منذ أن بدأ سيرته في طلب العلم، وكما ذُكر سابقا فإنه في مدّة إقامته في مدينة قم قام السيد السيستاني بمراسلة عالم الأهواز الشهير السيد علي البهبهاني (قدس سره)، وحصل تبعا لذلك إعجابا كبيرا من هذا العالم الكبير بنبوغ السيد وعلميته، حتى وصفه بـ (عمدة العلماء المحققين ونخبة الفقهاء المدققين)!
وبعد أن وفد السيد إلى النجف الأشرف وبدأ يحضر في دروس الأعلام كالسيد الخوئي والشيخ حسين الحلي (قدس الله سريهما) برز متفوقا على أقرانه، ولاسيما في درس السيد الخوئي أستاذه الأكبر، فكان ذو قوة في الإشكال وسرعة البديهة وكثرة التحقيق والتتبع ومواصلة النشاط العلمي، وكان كثير الإلمام بالنظريات في مختلف الحقول العلمية الحوزوية، ومما يشهد على ذلك أنه منح من بين زملائه وأقرانه في عام 1380هـ الموافق 1960م من الميلاد، وهو في الحادية والثلاثين من عمره (شهادة الاجتهاد المطلق) من لدن أستاذيه السيد الخوئي (قدّس سرّه) والشيخ الحلي (قدّس سرّه)، ولم يمنح السيد الخوئي شهادة الاجتهاد إلّا لنادرٍ من تلامذته، منهم السيد السيستاني وآية الله الشيخ علي الفلسفي من مشاهير علماء مشهد المقدسة، كذلك لم يمنح الشيخ الحلي إجازة الاجتهاد المطلق لغيره (دام ظلّه)! وقد كتب له أيضاً شيخ محدّثي عصره العلاّمة الشيخ آغا برزك الطهراني (قدّس سرّه) شهادة يطري فيها على مهارته في علمي الرجال والحديث وهي مؤرخة كذلك في عام 1380 هـ.
وكان للعلمين العظيمين: السيد الخوئي والشيخ حسين الحلي أثر كبير في سيرة السيد السيستاني العلمية، فقد تأثر كثيرا بأستاذه الأكبر السيد الخوئي (قدس سره)، الذي عُرف بمنهجه العلمي الرصين، ونقوده الجريئة في مجال الرواية عن أهل البيت (عليهم السلام) ورجال الحديث، ومن المناسب نقل كلام السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) في بيان منهج الإمام الخوئي وأهميته، إذ قال: "إن في الثامن من شهر صفر، مرت الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لرحيل السيد الأستاذ الإمام الخوئي (قدس سره) إلى الرفيق الأعلى وانطفاء تلك الشعلة الوهاجة التي طالما استضاء بنورها رواد الحوزات العلمية. إن من أهم ما تميز به الإمام الخوئي رضوان الله عليه هو منهجه العلمي الرصين في التعامل مع الأخبار المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، والتزامه الصارم بنقدها من حيث مصادرها وأسانيدها ومتونها وعدم التعويل إلا على المعتبر منها من جميع الجهات، وكذلك إبرازه لدور علم الرجال وأهميته الفائقة في استنباط الأحكام الشرعية والوصول إلى المعارف الإسلامية الأصيلة.
إن أهمية ما قام به الإمام الخوئي (قدس سره) تتجلى في هذا المجال بملاحظة المحاولات التي يقوم بها بعضهم في هذه الأيام لإرجاع عجلة الفكر إلى الوراء بالترويج لنمط من الأفكار المبنية على الأخذ بروايات الوضّاعين والضعفاء وما بحكمها مما ورد في المصادر غير المعتبرة وعدّ ذلك كله من علوم الأئمة الطاهرين عليهم السلام والبناء عليه في تحديد معالم مدرستهم الفكرية العظيمة.
إنّ التمسك بمنهج الإمام الخوئي (أعلى الله مقامه) في نقد الأحاديث وتمحيصها والتدقيق فيها كفيل بإفشال هذه المحاولات الغريبة التي لو قُدِر لها شيء من النجاح فإنّها ستؤثر سلباً على المسيرة الفكرية لأتباع أئمة أهل البيت عليهم السلام ولن يحدث ذلك إن شاء الله تعإلى. لقد مضى على فراق السيد الأستاذ الإمام الخوئي (قدس سره) ربع قرن من الزمن، وما زلت أتذكّره بهيأته وهيبته، بهيأته وهو يرقى منبر التدريس فيُبهر الحضور ببيانه الجميل ومنطقه المحكم، وبهيبته وهي هيبة العلم والتقوى والمرجعية العليا التي تبوأها عن جدارة مطلقة، ما زلت أتذكر عنايته ورعايته لطلابه حتى الأحداث منهم من أمثالي على الرغم من عِظم شأنه وكِبر سنِّه وتكاثر الهموم على قلبه الشريف في ظِل النظام الجائر السابق، ما زلتُ أتذكّر كل ذلك فأتواضع لمقامه وأخشع لجلاله. وأسأل الله تبارك وتعإلى أن يرفع درجته في عليين ويلحقه بآبائه الطيبين الطاهرين ويجزيه عن العلم وأهله أفضل جزاء المحسنين"[2].
أما الشيخ حسين الحلي (قدس سره) فهو الأستاذ الثاني بعد الإمام الخوئي أثر في سيرة السيد السيستاني العلمية، ولبيان أهميته العلمية نذكر ما قاله فيه بعض الأعلام، إذ نقل آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره عن آية الله الشيخ علي النائيني أن والده المحقق النائيني كان يرى الشيخ حسين الحلي أفضل تلامذته. كما نقل آية الله السيد حسين الشمس الخراساني دام ظله أن أحد الطلاب في مشهد أراد الهجرة إلى النجف الأشرف فاستشار المرجع الكبير آية الله العظمى السيد الميلاني قدس سره عن حضوره عند أساتذة النجف الأشرف، فما أشار عليه إلا باثنين وهما السيد الخوئي والشيخ حسين الحلي. وقال فيه الحجة المتتبع الشيخ آغا بزرك الطهراني: وقد عرف بالتحقيق، والتبحُّر، والتُّقى، والعِفَّة، وشرف النفس، وحُسن الأخلاق، وكثرة التواضع، وهو من الذين يخدمون العلم للعلم، ولم يطلب الرياسة، ولم يتهالك في سبيل الدنيا، وهو من أجل ذلك محبوب مقدَّر بين الجميع.[3]
وفي عام 1381ه – 1961م قام السيد السيستاني (دام ظله) بإلقاء محاضراته (البحث الخارج) في الفقه في ضوء مكاسب الشيخ الأعظم الأنصاري، وأعقبه بشرح العروة الوثقى، فتمّ له منه شرح كتاب الطهارة وأكثر كتاب الصلاة وقسم من كتاب الخمس وتمام كتاب الصوم والاعتكاف ثم شرع في شرح كتاب الزكاة.
وكانت له محاضرات فقهية أخرى خلال هذه السنوات تناولت كتاب القضاء وابحاث الربا وقاعدة الإلزام وقاعدة التقية وغيرهما من القواعد الفقهية، كذلك كانت له محاضرات رجالية شملت حجية مراسيل ابن ابي عمير وشرح مشيخة التهذيبين وغيرهما.
وفي الصورة أدناه من اليمين السيد بحر العلوم، والسيد السيستاني، والسيد الخوئي، والسيد محمد رضا الخلخالي،و السيد محمد علي الشيرازي، والشيخ أحمدي شاهرودي:

وابتدأ آية الله العظمى السيد السيستاني بإلقاء محاضراته في علم الأصول من شعبان عام (1384هـ - 1964م) وقد أكمل دورته الثالثة في شعبان عام (1411ه - 1990م)، ويوجد تسجيل صوتي لجميع محاضراته الفقهية والأصولية من عام 1397هـ المصادف 1977م وإلى عام 1997م.
وأدناه صورة تبيّن إمامة السيد السيستاني (دام ظله) لصلاة الميت على جنازة السيد الخوئي (قدس سره) في مرقد الإمام علي (ع):

وقد تخرّج من دوراته البحثية عدد من الفضلاء المبرزين وبعضهم من أساتذة البحث الخارج، كالعلاّمة الشيخ مهدي مرواريد، والعلاّمة السيد مرتضى المهري، والعلاّمة المرحوم السيد حبيب حسينيان، والعلاّمة السيد أحمد المددي، والعلاّمة الشيخ مصطفى الهرندي، والعلاّمة السيد هاشم الهاشمي، وغيرهم من أفاضل أساتذة الحوزات العلمية.
وضمن اشتغال سماحته (دام ظلّه) بالدرس والبحث في هذه المدّة كان مهتمّاً بتأليف كتب مهمّة، وجملة من الرسائل بالإضافة إلى ما كتبه من تقريرات بحوث أساتذته في الفقه والأصول، وسيأتي ذكر جملة منها لاحقا.
ومن أهم ما تميّزت به شخصيته العلمية الروح القرآنية، فانطلاقا من عمق علاقته بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا وتفسيرا على مدى سنين طوال، يمتلك السيد المرجع خبرة قرآنية واسعة الآفاق، ومن مظاهر هذه العلاقة القرآنية أن السيد السيستاني (دام ظله) في بحوثه الأصولية والفقهية تنعكس علاقته القرآنية في حسن فهمه للآيات وجودة تطبيقه لها في مواردها، وهنا نستشهد بشاهدين: شاهد فقهي وشاهد أصولي، على هذه العلاقة القرآنية الوثيقة.
فلو جئنا إلى الشاهد الفقهي نجد أن السيد السيستاني (دام ظله) عندما يأتي إلى آية الخمس وهي قوله عز وجل ((وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ))، فإننا نعلم أن هنالك إشكالا ذكره بعض علماء المذاهب الإسلامية وهو إن هذه الآية تتحدث عن خمس غنائم الحرب، لأن الآية وردت في سياق آيات القتال، وقد أجاب كثير من علمائنا على هذ الإشكال بأن خصوص المورد لا يخصص الوارد، أي أن الآية وإن وردت في سياق آيات القتال إلّا أن مدلولها عام لجميع موارد الاغتنام، على اعتبار أن الغنيمة لغة هي ما يفوز به الإنسان من أرباح ومكاسب، سواء كانت في الحرب أم في غيرها، كما في قوله تعالى ((فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ))، فالسيد السيستاني من طريق خبرته القرآنية قرأ سورة الأنفال التي وردت فيها آية الخمس قراءة سياقية استكثف منها انسجام آية الخمس مع سورة الأنفال، فعندما نقرأ سور الأنفال نجد أن هذه السورة الشريفة لا تتحدث عن القتال بما هو قتال، وإنما تتحدث السورة الشريفة عن دعم الكيان الإسلامي، إذ إن هذا الكيان في عصر النبي المصطفى (ص) المكون من دولة وجيش ومجتمع كان محتاجا إلى الدعم، فجاءت سورة الأنفال لتحشد أنواع الدعم لتأسيس الكيان الإسلامي وبقائه وضمان استمراره.
ومعنى الأنفال في قوله تعالى ((الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ)) المعادن والكنوز والأراضي الاستراتيجية، فإن كل هذه الأموال والثروات يجب أن تتحول إلى الله والرسول، أي يجب أن تتحول إلى بيت مال الدولة؛ لتكون دعما للدولة الإسلامية، ثم تحدثت سورة الأنفال عن الإنفاق في بعض آياتها، إذ تأمر المسلمين بالإنفاق على المجتمع الإسلامي، فإن هذا الإنفاق يشكل دعما آخر للكيان الإسلامي، وجاءت آية الخمس في هذا الصراط لتقول أن ما تغنمونه من الحرب أو من غيرها ضريبته التي جعلها الله في أرباحكم عشرون بالمئة، أي هي الخمس لتكون دعما للكيان الإسلامي.
فآية الخمس وإن وردت في سياق القتال إلا أننا ينبغي أن نقرأ السياق العام لسورة الأنفال وهو سياق دعم الكيان الإسلام، ودعم الدولة الإسلامية، لأجل ذلك فإن المنسجم مع دعم الكيان ودعم الدولة الاسلامية أن يكون المقصود بالغنيمة مطلق ما يربحه ويكتسبه الإنسان لا خصوص غنيمة القتال.
وأما الشاهد الأصولي: فإننا نرى أن السيد السيستاني (دام ظله) يرى أن من شرائط حجية خبر الثقة ألا يكون مخالفا للكتاب مخالفة روحية.
وجميع علمائنا يقولون: "لا يؤخذ خبر الثقة أو الرواية التي رواها الثقة على إطلاقها، إنما بشرط ألا تكون الرواية مخالفة للكتاب"، ولكن ما هو المقصود بمخالفة الكتاب؟ ويرى السيد السيستاني أن المقصود من مخالفة الكتاب المخالفة الروحية له، وتعني ألّا يكون مضمون الخبر منافيا للمبادئ العامة المستفادة من القرآن الكريم، كما لو جاءنا خبر مثلا نستفيد منه تحليل الربا فإن هذا يتنافى مع مبدأ عام في القران الكريم ((َأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا))، أو عندما نطبق هذا المقصد على الرواية الواردة عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ((لا تزوجوا الأكراد فإنهم حي من الجن كُشف عنهم الغطاء)) يقال بأن هذه الرواية منافية لروح الكتاب، فالمستفاد من الكتاب أن هناك مبدأ وهو تساوي الإنسانية في الحقوق واللوازم كما في قوله تعالى ((وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْر)) وكما في قوله تعالى ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُم))، فانطلاقا من الروح القرآنية للسيد السيستاني (دام ظله) نقول ينبغي أن يكون من الخطوات العملية للمؤسسات العاملة سواء كانت تحت مظلة السيد السيستاني أم غيرها أن يكون للقرآن دور في برامجها، وأن يكون لتعليم القرآن وتفسيره ونشر علومه دور واضح في برامجها؛ تجلية وإظهارا لهذه الروح التي ورثها وجسدها السيد المرجع امتدادا للأئمة الطاهرين عليهم السلام.
السيد السيستاني فكر يتسم بالمرونة والحركية، في كل يوم يجلس مع أبنائه يتداولون القواعد الفقهية والأصولية والرجالية في مسائل متنوعة، فهو في حركة دائمة مع أدوات الاستنباط ومع عالم الاستنباط ومع عالم التحقيق والتدقيق، بناء الكبريات وتطبيق الكبريات على الصغريات، وهذا شأن فقهائنا ومراجعنا أدام الله ظلالهم الشريفة، لكن هناك تميز في المسيرة العلمية للسيد السيستاني (دام ظله) وهو إن السيد المرجع أدخل أبحاثا أكاديمية حديثة في فكره الأصولي؛ فعندما يأتي السيد السيستاني مثلا إلى مبحث الوضع عند الأصوليين يدخل في بحث عن اللغة ونشأتها وتنوعها وتطورها، وهذا مبحث أكاديمي يُستفاد منه في علم الأصول في تحديد الدلالات، ودرجات الظهور، ومدى حاكمية ظهور على آخر وقرينية ظهور على آخر، وعندما يأتي السيد السيستاني إلى بحث حجية خبر الثقة الذي تناوله كل العلماء من زمان الشيخ الطوسي إلى يومنا هذا، يضيف إليه بحثا عن تدوين السنة المحمدية، تعرفون أن هنالك كتابا للشيخ أبي زهرة وهو كتاب (أضواء على السنة المحمدية) تناول فيه تاريخ تدوين الحديث النبوي لدى المسلمين والمراحل التي مرّ بها، وهذا البحث لم يدرجه علماء الأصول في الكتب الأصولية، فالسيد السيستاني أدخل هذا البحث وقال من المناسب عند البحث عن حجية الرواية والحديث أن نبحث متى بدأ تدوين الحديث عند السنة وعند الشيعة، وأثبت من طريق هذا البحث أن الشيعة هم أول المذاهب التي كتبت في الرواية والحديث، وأن نبحث عن ما قامت به الخلاقة الأموية في تحريف كثير من الأحاديث، وأن نبحث عن كتب الحديث والرجال لدى عامة المسلمين وتاريخها ومراحلها وتقويمها، فإن كل هذه الأبحاث الأكاديمية العلمية تدعم المنهج العلمي في تقويم أية رواية ترد علينا، ومن الأمور التي أضافها السيد السيستاني (دام ظله) إلى بحث تعارض الأدلة بحث علل اختلاف الحديث، أي لماذا تختلف الروايات؟ فنرى بعض الروايات تختلف مضامينها عن البعض الآخر، ما الأسباب في ذلك؟ فإن اكتشاف أسباب اختلاف الحديث يوفّر للباحث والفقيه مؤونة التأويل والتكلف في الجمع بين مدلولات الروايات الشريفة، وأضاف أيضا إلى بحوثه الفقهية بحث تاريخ النص والأجواء المحيطة به، فإن كل رواية ترد إلينا لا يكفي أن نقرأها قراءة لغوية منفصلة عن التاريخ، بل لابد من قراءة الرواية متصلة بتاريخها، في أي عصر صدرت، وما هي البيئة الثقافية التي صدرت فيها، وما الأفكار التي كانت مطروحة في ذلك العصر، لنعرف ارتباط حروف الرواية ورموزها بتلك البيئة الثقافية.
والغرض من الاستشهاد بهذه المميزات الفكرية للقول إن السيد السيستاني يعنى بفكر الشباب والباحثين، ويريد أن يكون شبابنا وباحثونا أكثر دقة وعمقا وتأصيلا في بحوثهم العلمية المرتبطة بالدين والثقافة الدينية، لذلك على المؤسسات العاملة أن تستفيد من أبحاث السيد السيستاني وتنشرها، وتنشر هذه المميزات من هذه الأبحاث لأنها أبحاث أكاديمية تنفع كل باحث حوزوي أو غيره، وأن تقوم بنشرها وترويجها، وأن تنعكس هذه الأبحاث على ما يصدر من هذه المؤسسات وعما تقوم به من برامج فكرية وثقافية.
وكان منهجه (دام ظله) العلمي في البحث والتدريس منهجا متميّزا عن مناهج كثير من الأساتذة وأرباب البحث الخارج، فعلى صعيد الأصول يتجلّى منهجه بخصائص عدّة، هي:
أولا: الرؤية الشمولية في الحقل الأصولي، فالسيد السيستاني قبل أن يشرع في بحث أي مسألة أصولية وعرض تفاصيلها، يقرأ المسألة قراءة شمولية، من أجل اقتناص النكات العامة، المؤثرة في بناء المسألة قبولاً أو رفضاً، وفرزها عن النكات الثانوية والجزئية، مما يعطي بصيرة لكل باحث يتناول المسألة، وهذا يختلف عن منهج كثير من الأساتذة الذين يتناولون كل مسألة بمنهج تجزيئي، والانتقال من فقرة إلى أخرى بنحوٍ تختلط فيه النكات العامة بالنكات الخاصة.[4]
ثانيا: التحدث عن تأريخ البحث ومعرفة جذوره والعوامل المؤثرة في مجرياته، مثال ذلك تطرقه إلى مسألة بساطة المشتق وتركيبه، وهي مسألة فلسفية، أو حديثه على بحث التعادل والتراجح، الذي أوضح فيه أن قضية اختلاف الأحاديث فرضتها الصراعات الفكرية العقدي آنذاك والظروف السياسية التي أحاطت بالأئمة (عليهم السلام)، ومن الواضح أن الإطّلاع على تأريخ البحث يكشف عن زوايا المسألة ويوصلنا إلى واقع الآراء المطروحة فيها.
ثالثا: وظف السيد المرجع التنوع الثقافي لديه في مباحثه العلمية، فهو قد دأب على قراءة بعض العلوم الإنسانية: كعلم النفس، وعلم الاجتماع، وعلم القانون، ودقق النظر في القانون المصري، والعراقي، والفرنسي، وأن له اطلاع وافر بالتاريخ، وخصوصاً التاريخ السياسي للدول العربية، والإسلامية، وهذا التنوع الثقافي تجلى أثره حتى في بحوثه الأصولية، فقد استفاد من علم الألسنيات في: تقسيم الدلالة في باب المفاهيم، وتقسيم الحكومة، وتنوع السنة التنزيل في النصوص، كما استعرض ذلك في بحثه في قاعدة لا ضرر. واستفاد من دليل حساب الاحتمالات الرياضي في: تحليل حجية الإجماع، والخبر المتواتر، كذلك أفاد من علم القانون: في نظرية الاستيطان التي طرحها في تفسير حقيقة الحكم الوضعي وعلاقته بالحكم التكليفي، كما استفاد أيضاً من علم النفس في: تحليل المحركية العقلية للتكليف الشرعي، عبر موازنة النفس بين حجم الاحتمال وأهمية المحتمل ومؤونة العمل. ومازالت روحه الوثابة نحو معرفة كل جديد متجددة ومتوقدة ومسيطرة على مجامع فكره الخلاق، مع تجاوزه التسعين من عمره، فهو لا يفتأ أن يقرأ أي كتاب يصل إليه وفي أي مجال[5].
رابعا: الربط بين الفكر الحوزوي والثقافات المعاصرة ففي بحثه في المعنى الحرفي في بيان الفارق بينه وبين المعنى الاسمي وهل هو فارق ذاتي ام لحاظي؟ اختار اتجاه صاحب الكفاية في أن الفرق باللحاظ لكن بناه على النظرية الفلسفية الحديثة وهي نظرية التكثر الادراكي في فعالية الذهن البشري، وتعني النظرية أن الذهن البشري ليس صندوقا أمينا في استقبال المعلومات الخارجية كما كان يذكر قدماء الفلاسفة بأن الذهن البشري كصفحة المرآة يرتسم فيها صور المحسوسات بلا تغيير ولا تبديل، بل الذهن قد يتلقى بعض الصور بعدة وجوه وأشكال لحكومة العوامل الخارجية والنفسية على الذهن أثناء تصوره كما تتحرك القوة المتخيلة لإدراك الشيء على عدة أنحاء، فقد نتصور الانسان بصورة إجمالية بسيطة ونعبر عنها بالإنسان أو البشر وقد نتصوره بصورة تفصيلية مركبة ونعبر عنه بالحيوان الناطق مع أنه حقيقة واحدة، وهذا دليل على الفعالية الذهنية في كثرة مدركاتها. فيمكن للذهن تصور مطلب واحد بصورتين: تارة بصورة الاستقلال والوضوح فيعبر عنه بالاسم وتارة بالآلية والانكماش ويعبر عنه بالحرف.
وعندما دخل في بحث المشتق في النزاع الدائر بين العلماء حول اسم الزمان، تحدّث عن الزمان بنظرة فلسفية جديدة وهي انتزاع الزمان من المكان (زمكان) بلحاظ تعاقب النور والظلام، وفي بحثه حول مدلول صيغة الأمر ومادته وبحثه في التجري طرح نظرية بعض علماء الاجتماع من أن تقسيم الطلب بأمر والتماس وسؤال نتيجة لتدخل صفة الطالب في حقيقة طلبه من كونه عالياً أو مساوياً أو سافلاً.
وكذلك جعل ضابط استحقاق العقوبة عنوان تمرد العبد وطغيانه على المولى مبنيا على التقسيم الطبقي للمجتمعات البشرية القديمة من وجود موالٍ وعبيد وعالٍ وسافل وما أشبه ذلك. فهذه نظرة من رواسب الثقافات السالفة التي تتحدث باللغة الطبقية لا باللغة القانونية المبنية على المصالح الانسانية العامة.
خامسا: تميّز بحثه الأصولي بالتجديد، فلم يكن عرضه تقريراً لكلمات الآخرين، ولا عرضاً تقليدياً لما قيل في شروح الكفاية وحواشيها، وإنما تجده يتميز في كل بحث، إما في: صياغة البحث، أو إضافة بعض النكات له، أو اختيار مبنى لم يسبق إليه، فمن ذلك ما يأتي:
- نظرية الهوهوية التصورية في تفسيره للعلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى.
- ما طرحه من نظرية متمم الجعل التطبيقي في بحث الحقيقة الشرعية.
- ما أفاده في مراتب ظهور المشتق في الفعلية تبعاً لتنوع المبادئ: من مبدأ جلي، ومبدأ خفي، وتحليله لبساطة المشتق على مستوى المعقول الأولي الذي لا يتنافى مع تركيبه بحسب المعقول الثانوي.
ومما تميز به تحليله لحقيقة الحكم التكليفي، والأمر المولوي، ببنائه على عنصرين: عنصر البعث، والعنصر الجزائي من وعد أو وعيد، وما اختاره من نظرية الوجوب الاندماجي، في باب مقدمة الواجب، وقوله باختلاف مراتب القدرة، من حيث الدخالة في الحكم التكليفي، إذ ذهب إلى أن أصل القدرة دخيل في مرحلة الفعلية، والقدرة التامة دخيلة في مرحلة الفاعلية والتنجز.
وكذلك ذهب لعدم عقلائية الترتب بين المتزاحمين المتساويين، وأن متعلق التكليف في مثل هذا المورد هو الجامع الانتزاعي المعبر عنه بعنوان الأحد. وقد أفاد من نظرية آقا على مدرس، القائلة بأن العرض ليس وجوداً وراء وجود الجوهر، بل هو نحو ولون من ألوان الوجود الجوهري في تمييز التركيب الانضمامي عن التركيب الاتحادي، في بحث اجتماع الأمر والنهي.
كما بلور في بحت المطلق والمقيد الفرق بين الإطلاق الوارد في مقام التعليم، والوارد في مقام الإفتاء، ورتب عليه عدة آثار، ومن ذلك: إن القدر المتيقن في مقام التخاطب مضر بالإطلاق الوارد في مقام الإفتاء، دون الوارد في مقام التعليم، مضافاً إلى أن الجمع بين المطلق والمقيد ـ بتمام صوره جمع عرفي في الخطاب الوارد في مقام التعليم، بينما الإطلاق الوارد في مقام الإفتاء؛ إذا كان ترخيصياً وكان المقيد المنفصل إلزامياً وارداً. بعد حضور وقت العمل كان الجمع بينهما بالتقييد ـ كما هو المتداول في علم الأصول تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة وهو مستهجن عرفاً.
ومن نظرياته؛ ما سلكه في بحث حجية القطع، من ان حجيته بمعنى المعذرية ليست ذاتية، بل هي عقلائية، فإن موضوعها القطع الناشئ عن منشأ عقلائی وما سلكه في بحث التجري، من أن ملاك المحركية واستحقاق العقوبة لدى المخالفة هو إدراك العقل النظري استبطان الحكم المولوي لعنصر الوعيد، لا حكم العقل العملي بحق الطاعة، وقبح التمرد على المولى والاستخفاف به.
وكذك اختار في بحث منجزية العلم الإجمالي؛ أن منجزيته للجامع عقلية، بينما منجزيته للواقع في كل طرف عقلائية.
واختار في مسألة البراءة العقلية؛ أن موضوعها ليس مطلق الشك في التكليف، وإنما الشك المجرد عن قوة الاحتمال، أو إحراز أهمية المحتمل.
وكذلك ذهب لجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية بملاك عدم المعارضة وأن استصحاب عدم سعة الجعل أصل مثبت، لأنه لا ينقح ما هو المجعول نفياً أو إثباتاً، كما هو رأي المحقق النائيني.
وأبدع باباً جديداً في بحث التعارض، وهو باب مناشئ اختلاف الحديث وهو بحث مؤثر في علاج تعارض النصوص.
واختار في تحليل الروايات المتضمنة لعلاج التعارض بين الأدلة، أنها ليست في مقام الترجيح التعبدي، وإنما هي في مقام الإرشاد، للمائز بين الحجة واللاحجة، وأرجع الترجيح فيها إلى التنبيه على مرتكز عقلائي قائم على الأخذ بكل مزية تصرف الريب من الطرف الواجد لها إلى الطرف الآخر[6].
سادسا: الاهتمام بالأصول المرتبطة بالفقه: إن الطالب الحوزوي يلاحظ في كثير من العلماء اغراقهم واسهابهم في بحوث اصولية لا يعدّ الاسهاب فيها إلّا ترفاً فكريّاً لا ينتج ثمرةً علميةً للفقيه في مسيرته الفقهية كبحثه في الوضع وكونه امراً اعتبارياً أو تكوينياً وأنّه تعهد أو تخصص، وبحثهم في بيان موضوع العلم وبعض العوارض الذاتية في تعريف الفلاسفة لموضوع العلم وما شاكل ذلك.
ولكن الملاحظ في دروس السيد السيستاني (دام ظلّه) هو الاغراق وبذل الجهد الشاق في الخروج بمبنى علمي رصين في البحوث الأصولية المرتبطة بعملية الاستنباط كمباحث الاصول العملية والتعادل والتراجح والعام والخاص، وأمّا البحوث الأخرى التي أشرنا لبعض مسمياتها، فبحثه فيها إنما هو بمقدار الثمرة العلمية في بحوث أخرى أو الثمرة العملية في الفقه.
سابعا: الإبداع والتجديد: هناك كثير من الأساتذة الماهرين في الحوزة لا يملك روح التجديد بل يصب اهتمامه على التعليق فقط والتركيز على جماليات البحث لا على جوهره فيطرح الآراء الموجودة ويعلّق على بعضها ويختار الأقوى في نظره، إلّا أن السيد السيستاني (دام ظله) يختلف في هذا النهج فيحاول الابداع والتجديد إما بصياغة المطلب بصياغة جديدة تتناسب مع الحاجة للبحث كما صنع ذلك عندما دخل بحث استعمال اللفظ في عدة معانٍ حيث بحثه الأصوليون من زاوية الإمكان والاستحالة كبحث عقلي فلسفي لا ثمرة عملية تترتب عليه وبحثه السيد السيستاني (دام ظله) من حيث الوقوع وعدمه لأنه أقوى دليل على الإمكان، وبحثه كذلك من حيث الاستظهار وعدمه.
وعندما دخل بحث التعادل والتراجح رأى أن سرّ البحث يكمن في علّة اختلاف الأحاديث فإذا بحثنا وحدّدنا أسباب اختلاف النصوص الشرعية انحلّت المشكلة العويصة التي تعترض الفقيه والباحث والمستفيد من نصوص أهل البيت (عليهم السلام) وذلك يغنينا عن روايات الترجيح والتخيير كما حملها صاحب الكفاية على الاستحباب.
وهذا البحث تناوله غيره ولكنه بشكل عقلي صرف، أما السيد السيستاني (دام ظله) فإنه حشد فيه الشواهد التاريخية والحديثية وخرج منه بقواعد مهمّة لحلّ الاختلافات وقام بتطبيقها في دروسه الفقهية أيضاً.
ثامنا: استيعاب المدارس الأصولية، فمسيرة بحثه ترتكز على عرض المدارس الأصولية الست: مدرسة الشيخ الأعظم، ومدرسة صاحب الكفاية، ومدرسة المحقق الطهراني، ومدرسة المحقق النائيني، والعراقي، والأصفهاني، والمحاكمة بينها، ومقدار ما أضافته كل مدرسة من نكات جوهرية في المسألة. وسمة الرؤية العقلانية البارزة في بحثه الأصولي، فصل المباني الفلسفية المبنية على البراهين العقلية المجردة بعد مناقشتها عن تحقيق المسألة الأصولية، والإصرار على ربطها بالمرتكزات العقلائية القانونية. وهذا ما استفاد منه في بحث الواجب المشروط، وبحث الترتب وغيرها من الموارد[7].
تاسعا: المقارنة بين المدارس المختلفة: ان المعروف عن الكثير من الأساتذة حصر البحث في مدرسة معينة أو اتجاه خاص ولكن السيد السيستاني يقارن بحثه بين فكر مدرسة مشهد وفكر مدرسة قم وفكر مدرسة النجف الأشرف فهو يطرح آراء الميرزا مهدي الاصفهاني (قدّس سرّه) من علماء مشهد وآراء السيد البروجردي (قدّس سرّه) كتعبير عن فكر مدرسة قم وآراء المحققين الثلاثة (الشيخ النائيني والشيخ العراقي والشيخ الاصفهاني) والسيد الخوئي (قدّس سرّه) والشيخ حسين الحلّي (قدّس سرّه) كمثال لمدرسة النجف الأشرف.
أمّا المنهج الفقهي للسيد المرجع فهو منهج خاص أيضا، يتميز في تدريس الفقه وطرحه، ولهذا المنهج سمات كثيرة وملامح عديدة:
أولا: استعراض تاريخ المسألة الفقهية منذ بداية طرحها في أول كتاب فقهي وصل إلينا، من كتب الخاصة أو العامة، ولا شك أن قراءة سير المسألة ونموها دخيل في تحقيق الأقوال، ومعرفة مدى ارتباطها أو بعدها عن لب المسألة وكنهها.
ثانيا: التركيز في بحثه على مراجعة كتب القدماء في المسألة، والتدقيق في عباراتهم عند تناول المسألة له صلة وثيقة باستكشاف القرائن الارتكازية المعاشة عندهم، والتي لم تصل إلينا بلحاظ أنهم أول من تلقى النصوص، وهم أقرب لزمان صدورها، وأكثر إحاطة بقرائتها الحالية والارتكازية. كما أن ذلك دخيل في معرفة حجم الحكم، وأنه بدرجة الشهرة، أو الإجماع، أو التسالم، أو الضرورة.
ثالثا: من الركائز الأساسية في بحث السيد السيستاني معرفة أجواء النص بقراءة الكتب الفقهية والحديثية للعامة في كل مسألة، بلحاظ أن كثيراً من الروايات ما هي إلا تعليق على رأي الجمهور، لتخطئة، أو إضافة. فقراءة كلمات العامة في المسألة كاشف عن الأجواء المعاصرة للرواية الصادرة عن المعصوم، وقرينة من قرائن مفادها، كما تعرض لذلك جمع من الأعلام في وجوب الخمس في الأرض المشتراة من الذمي.
رابعا: من مميزات وسمات البحث الفقهي لدى السيد المرجع وفرة القرائن، إذ إن مسلك السيد هو أن موضوع الحجية الوثوق لا خبر الثقة، فإنه يدأب على جمع القرائن المختلفة الموجبة للوثوق بالرواية. ومن تلك القرائن شهرة العمل بالرواية، وموافقة مضمونها للمبادئ والملاكات العامة، المستفادة من الكتاب، والسنة الشريفة، حيث إن مبناه قائم على أن المقصود بالمرجح -المعبر عنه في روايات الترجيح بموافقة الكتاب هو الموافقة الروحية، وهو ما عبرت عنه بعض النصوص بقوله عليه: نقشه على كتاب الله وأخبارنا، ومنها شهرة مضمون الرواية في كتب الحديث واللغة والأدب.
خامسا: الخبرة بكتب الحديث، إذ إن بحثه الفقهي يشتمل على مخزون وافر من الخبرة بالنسخ الخطية للكتب الأربعة، وغيرها من كتب الحديث، والدقة في التتبع والمقارنة بين موارد الاختلاف فيها، والقدرة البارعة على ترجيح بعض النسخ على الأخرى، وهذا ما لا تجده في كثير من البحوث الحوزوية. كما أن ما اشتهر من أن الكافي أشد ضبطاً من التهذيبين لترجيح مصادر الكافي على مصادر غيره هو مما لا شاهد عليه، بل الشواهد المتوفرة على عدمه بحسب نظره الشريف.
سادسا: يتبنّى السيد المرجع في بحث حجية الظهور في علم الأصول أن موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي العرفي لا الظهور الذاتي. ومن مصاديق الظهور الموضوعي الظهور الخاص، حيث إن لكل مقنن لغة خاصة، ومصطلحات يتميز بها، فلا يصح لدى المرتكز العربي أن يقتنص المراد الجدي من أي قانون بعرضه على الفهم العرفي العام، مع الالتفات إلى أن لمؤسس هذا القانون لغة خاصة في صياغة قوانينه.
ومن أمثلة ذلك؛ الأحاديث الواردة عن أهل البيت (عليه السلام)، فإن الخبير بها يجد أن لها لغة، ولحناً خاصاً، ومعاريض متداولة في السنة الأئمة إليه، وهذا ما ركزت عليه كثير من النصوص حيث صرح في بعضها: «لا يكون الرجل منكم فقيهاً حتى يعرف لحن كلامنا فإن لكلامنا وجوها لنا من جميعها المخرج»، وورد في بعضها: «إن لكلامنا ظهراً وبطنا»، وهذا ما يقتضي أن يكون للفقيه خبرة طويلة الأمد بمزاولة فقه رواياتهم إليه، لتحقيق موضوع الحجية فيها وهو الظهور الاستنباطي؛ أي المقتنص من الجمع بين مواردها المختلفة.
سابعا: ومن سمات البحث الفقهي لدى السيد السيستاني (دام ظله) يتوقف على الإلمام بفقه اللغة العربية، ولا يمكن تحديد المراد منها بمجرد مراجعة كتاب من كتب اللغة، ككتاب المنجد، أو الرائد، بل لابد من الاطلاع على أمهات كتب اللغة، كالصحاح، والقاموس، ولسان العرب، وتمييز ما هو السابق واللاحق منها، لمعرفة الكتب القريبة من زمان صدور النص، كما يقتضي ذلك التأمل في كتب فقه اللغة، كمفردات الراغب، وأساس البلاغة، وفقه اللغة، وغيرها، مع مراجعة كتب الأدب، لتتبع النصوص الصادرة من العرب المعاصرين لزمان النص القرآني، أو النبوي، أو العلوي[8].
ثامنا: المقارنة بين فقه الشيعة وفقه غيرهم من المذاهب الاسلامية الأخرى، فإنّ الإطّلاع على الفكر الفقهي السني المعاصر لزمان النص كالاطلاع على موطأ مالك واخراج أبي يوسف وآراء الفقهاء الآخرين يوضّح أمامنا مقاصد الأئمة (عليهم السلام) ونظرهم حين طرح النصوص.
تاسعا: الاستفادة من علم القانون الحديث في بعض المواضع الفقهية كمراجعته للقانون العراقي والمصري والفرنسي عند بحثه في كتاب البيع والخيارات، والاحاطة بالفكر القانوني المعاصر تزوّد الإنسان خبرة قانونية يستعين بها على تحليل القواعد الفقهية وتوسعة مداركها وموارد تطبيقها.
عاشرا: التجديد في الأطروحة: إنّ معظم علمائنا الأعلام يتلقون بعض القواعد الفقهية بنفس الصياغة التي طرحها السابقون ولا يزيدون في البحث فيها إلّا عن صلاحية المدرك لها أو عدمه ووجود مدرك آخر وعدمه، أما السيد السيستاني فإنّه يحاول الاهتمام في بعض القواعد الفقهية بتغيير الصياغة، مثلاً بالنسبة لقاعدة الإلزام التي يفهمها بعض الفقهاء من الزاوية المصلحية بمعنى أنّ للمسلم المؤمن الاستفادة في تحقيق بعض رغباته الشخصية من بعض القوانين للمذاهب الأخرى وإن كان مذهبه لا يقرّه، يطرحه السيد السيستاني على أساس الاحترام ويسميّها بقاعدة الاحترام أي احترام آراء الآخرين وقوانينهم، وانطلاقه من حريّة الرأي وهي على سياق (لكلّ قوم نكاح) و (نكاح أهل الشرك جائز) وكذلك بالنسبة إلى قاعدة التزاحم التي يطرحها الفقهاء والأصوليون كقاعدة عقلية أو عقلائية صرفة يدخلها السيد المرجع (دام ظله) تحت قاعدة الاضطرار التي هي قاعدة شرعية اشارت لها النصوص نحو (ما من شيء حرّمه الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطر إليه) فإنّ مؤدى قاعدة الاضطرار هو مؤدى قاعدة التزاحم بضميمة متمم الجعل التطبيقي.
وأحياناً يقوم بتوسعة القاعدة كما في قاعدة (لا تعاد) حيث خصّها الفقهاء بالصلاة لورود النص في ذلك بينما السيد السيستاني جعل صدر الرواية المتضمن لقوله (ع): (لا تعاد الصلاة إلا ّمن خمسة) مصداقاً لكبرى أخرى تعمّ الصلاة وغيرها من الواجبات، وهذه الكبرى موجودة في ذيل النص (ولا تنقض السنّة الفريضة)، فالمناط هو تقديم الفريضة على السنّة في الصلاة وغيرها، ومن مصاديق هذا التقديم هو تقديم الوقت والقبلة.. الخ على غيرها من أجزاء الصلاة وشرائطها لأنّ الوقت والقبلة من الفرائض لا من السنن.
إحدى عشر: النظرة الاجتماعية للنص: إنّ من الفقهاء من هو حرفي الفهم بمعنى أنّه جامد على حدود حروف النص من دون محاولة التصرف في سعة دلالات النص وهناك من الفقهاء من يقرأ أجواء النص والظروف المحيطة به ليتعرف على سائر الملابسات التي تؤثر على دلالته، فمثلاً في ما ورد من أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرّم أكل لحم الحمر الأهلية يوم خيبر ، أخذنا بالفهم الحرفي لقلنا بالحرمة أو الكراهة لأكل لحم الحمر الاهلية ولو اتبعنا الفهم الاجتماعي لرأينا أنّ النص ناظر لظروف حرجة وهي ظروف الحرب مع اليهود في خيبر والحرب تحتاج لنقل السلاح والمؤنة ولم تكن هناك وسائل نقل إلاّ الدواب ومنها الحمير، فالنهي في الواقع نهي إداري لمصلحة موضوعية اقتضتها الظروف آنذاك ولا يستفاد منه تشريع الحرمة ولا الكراهة، والسيد السيستاني (دام ظله) من النمط الثاني من العلماء في التعامل مع النص.
اثنا عشر: توفير الخبرة بمواد الاستنباط: إنّ السيد السيستاني يركّز دائماً على أنّ الفقيه لا يكون فقيهاً بالمعنى الأتم حتى يتوفر لديه خبرة وافية بكلام العرب وخطبهم وأشعارهم ومجازاتهم؛ كي يكون قادراً على تشخيص ظهور النص تشخيصاً موضوعيّا لا ذاتيا، وأن يكون على اطلاع تام بكتب اللغة وأحوال مؤلفيها ومناهج الكتابة فيها، فإنّ ذلك دخيل في الاعتماد على قول اللغوي أو عدم الاعتماد عليه وأن يكون على إحاطة بأحاديث أهل البيت (عليهم السلام) ورواتها بالتفصيل، فإنّ علم الرجال فن ضروري للمجتهد لتحصيل الوثوق الموضوعي التام بصلاحية المدرك، وله آراء خاصّة يخالف بها المشهور في هذا العصر مثلاً ما اشتهر من عدم الاعتداد بقدح أبن الغضائري أما لكثرة قدحه أو لعدم ثبوت نسبة الكتاب إليه مما لا يرتضيه السيد المرجع، بل يرى ثبوت الكتاب وإن ابن الغضائري هو المعتمد في مقام الجرح والتعديل أكثر من النجاشي والشيخ وأمثالهما، ويرى الاعتماد على منهج الطبقات في تعيين الراوي وتوثيقه ومعرفة كون الحديث مسنداً أو مرسلاً على ما قرّره السيد البروجردي (قدّس سرّه).
ويرى أيضاً ضرورة الإلمام بكتب الحديث واختلاف النسخ ومعرفة حال المؤلف من حيث الضبط والتثبت ومنهج التأليف، وأما ما يشاع في هذا المجال من كون الصدوق أضبط من الشيخ فلا يرتضيه، بل يرى الشيخ ناقلاً أميناً لما وجده من الكتب الحاضرة عنده بقرائن يستند اليها.
فهذه الجهات الخبرية قد لا يعتمد عليها كثير من الفقهاء في مقام الاستنباط بل يكتفي بعضهم بالظهور الشخصي من دون أن يجمع القرائن المختلفة لتحقيق الظهور الموضوعي بل قد يعتمد على كلام بعض اللغويين بدون التحقيق في المؤلف ومنهج التأليف ولا يكون لبعض آخر أي رصيد في علم الرجال والخبرة بكتب الحديث.
أما في الحقل الرجالي فكان السيد المرجع فارسا فيه؛ لوضوح مهارته، وبراعته الفائقة، في عدة جهات من هذا العلم:
أولا: خبرته بمختلف الكتب الرجالية، لدى الخاصة والعامة، وتحديده للغرض من تدوين كل كتاب منها، لدخالة ذلك في قيمة التوثيق والتضعيف فيها.
ثانيا: تمييز السابق من اللاحق، لتحديد كون الجرح أو التعديل تأسيساً، أو موروثاً.
ثالثا: التركيز على ألسنة التوثيق المتنوعة، من المدح، أو الترضي، أو التوثيق الصريح، أو النعت، بأنه صحيح الحديث، أو صالح الرواية، أو أن حديثه لا ينكر، فإن اختلاف العبارات ليس مجرد تفنن، وإنما هو دخيل في تقويم درجة الوثوق بالراوي، وقيمة الاعتماد على الرواية في إثبات حكم مخالف للقواعد. بل إن لكل رجالي مصطلحات خاصة به لا تعرف إلا بالخبرة بكتابه.
رابعا: جمع القرائن: لقد ذهب السيد السيستاني أمد الله في عمره المبارك إلى أن قول الرجالي توثيقاً، أو تضعيفاً، ليس شهادة وإنما هو رأي حدسي، فكلمات الرجاليين إحدى قرائن الوثوق، ومقتضى ذلك جمع القرائن المختلفة المتصيدة من كتب الحديث، والفقه، وكتب الأدب، كشهرة الراوي، أو كونه من مشائخ الإجازة، أو استحسان العامة له، أو رفضهم إياه، فإن كل ذلك دخيل في تحديد وثاقته لدى الخاصة.
خامسا: فن الترجيح: إن تقديم كلمات النجاشي على الشيخ، أو تقديم كلمات الكشي عليهما، يتقوم بالخبرة الاستقرائية لكتب الثلاثة، ومعرفة مدى الدقة والمهارة لكل منها في مقام الجرح والتعديل ومدى قيمة المصادر المعتمدة لدى مؤلفي هذه الكتب.
سادسا: ثقافة الراوي: إن من جملة قرائن الوثوق بالراوي؛ استقراء رواياته المختلفة، الشهادة مضامينها بثقافته، وتحديد أن المتعارف في رواياته رواية ما هو مخالف للقواعد، أو ما هو منكر في علم الكلام، أو أن سنخ أحاديثه موافق للمضامين العامة للدين الحنيف والشرع المطهر.
سابعا: صفة الراوي: إن تحديد صفة الراوي وتمييز كونه من المجتهدين، أو من الرواة، دخيل أيضاً في قيمة الوثوق بالمتن المروي من قبله عن المعصوم سلام الله عليه[9].
وهذه المكانة العلمية للسيد السيستاني أهلته لأن يرشحه أستاذه السيد الخوئي (قدس سره) ليخلفه في أمور زعامة الحوزة العلمية، إذ إنه في السنوات الاخيرة من حياة الإمام الخوئي (رضوان الله عليه) كان هاجس كثير من الفضلاء في النجف الأشرف وخارجها البحث عمن يصلح أن يخلفه (قدّس سرّه) في مرجعيته للطائفة الإمامية؛ ليحافظ على كيان الحوزة العلمية واستقلالية المرجعية الدينية ويتحلى بما يلزم توفره في شخص المرجع من مؤهلات علمية وورع وتقوى وحكمة وتدبير.
وقد توجّهت أنظار الكثير من الفضلاء إلى السيد السيستاني (دام ظلّه) واختاره الإمام الخوئي (قدّس سرّه) للصلاة في محرابه في جامع الخضراء كما تقدّم فبدأ ينتشر صيته في أوساط العامة بعد ان كان محصوراً في الأوساط العلمية والحوزوية التي عرفته أستاذاً قديراً في البحث الخارج طوال ربع قرن من الزمن.
وعندما التحق الإمام الخوئي بالرفيق الأعلى في (8/ صفر / 1413 هـ) أرجع إليه في التقليد جمع من العلماء الأعلام، يأتي في مقدمتهم سماحة آية الله السيد علي البهشتي (قدّس سرّه) وسماحة آية الله الشيخ مرتضى البروجردي (قدّس سرّه)، فقلّده كثير من المؤمنين في العراق وإيران وبلاد الخليج وباكستان والهند، وبعد وفاة آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري في (27/ صفر /1414 هـ) رجع إليه معظم مقلديه في العراق وقسم في خارجه، وعندما توفي آية الله العظمى السيد محمد رضا الكلبايكاني (قدّس سرّه) في (24 / جمادي الآخرة / 1414 هـ) عمّ تقليد السيد السيستاني (دام ظلّه) وبشكل سريع مختلف الأقطار الإسلامية، ورجع إليه معظم المؤمنين في العراق والاحساء والقطيف وايران ولبنان ودول الخليج وباكستان والهند والمغتربين في أوربا والامريكيتين واستراليا وغيرهم، وقد توسع الرجوع إليه أكثر فأكثر بعد وفاة آية الله العظمى الشيخ محمد علي الأراكي (قدّس سرّه) وآية الله العظمى السيد محمد الروحاني (قدّس سرّه)، فالسيد السيستاني اليوم هو المرجع الأعلى للطائفة الإمامية، دام ظلّه السامي ونفع بوجوده الإسلام والمسلمين .
وكان السيد السيستاني غزير الإنتاج، إذ كتب عشرات الرسائل والشروح والبحوث والتقريرات، منها ما طُبع ومنها ما زالت مخطوطات لم تُطبع حتى الآن، وهي:
1ـ شرح العروة الوثقى في شرح معظم كتاب الطهارة وقسم من كتاب الصلاة والخمس.
2ـ البحوث الأصولية وهي عدّة مجلدات دورة أصولية كاملة.
3ـ كتاب القضاء
4ـ كتاب البيع والخيارات
5ـ رسالة في لباس المصلي (تقرير السيد مرتضى المهري)
6ـ رسالة في مكان المصلي (تقرير السيد مرتضى المهري)
7ـ رسالة في خمس الفوائد والأرباح
8ـ رسالة في صلاة المسافر
9ـ رسالة في القبلة
10ـ رسالة في قاعدة اليد
11ـ رسالة في قاعدة التجاوز والفراغ
12ـ رسالة في قاعدة لا ضرر ولا ضرار
13ـ رسالة في التقية
14ـ رسالة في قاعدة الإلزام
15ـ رسالة في قاعدة القرعة
16ـ رسالة في الاجتهاد والتقليد
17ـ رسالة في صيانة الكتاب العزيز عن التحريف
18ـ رسالة في حجيّة مراسيل ابن أبي عمير
19ـ رسالة في تاريخ تدوين الحديث في الإسلام
20ـ شرح مشيخة التهذيبين
21ـ نقد رسالة تصحيح الأسانيد للأردبيلي
22ـ رسالة في مسالك القدماء في حجيّة الأخبار
23ـ الفوائد الغروية
24ـ الفوائد الفقهية
25ـ شرح مشيخة الفقيه
26ـ رسالة في تحقيق نسبة كتاب العلل إلى الفضل بن شاذان
27ـ رسالة في اختلاف الآفاق في رؤية الهلال
28ـ رسالة في حكم ما إذا اختلف المجتهدان المتساويان في الفتوى
29ـ تعارض الأدلة واختلاف الحديث (تقرير السيد هاشم الهاشمي)
30ـ الاستصحاب (تقرير السيد مرتضى المهري)
31ـ كتاب الصلاة (تقرير السيد مرتضى المهري)
32ـ مباحث الألفاظ (تقرير السيد حسن المرعشي)
33ـ كتاب الصوم (تقرير السيد حسن المرعشي)
34ـ الاجتهاد والتقليد والاحتياط (تقريرات السيد محمد علي الرباني)
35ـ قاعدة الإلزام (تقرير السيد محمد علي الرباني)
36ـ قاعدة لا ضرر ولا ضرار
37ـ الرافد في علم الأصول (تقرير السيد منير الخبّاز)
38ـ الاستصحاب (تقرير السيد محمد علي الرباني)
39ـ مباحث الحج (تقرير السيد محمد علي الرباني)
40ـ زواج البكر الرشيدة بغير إذن الولي (تقرير السيد محمد رضا السيستاني)
41ـ مباحث رجالية (تقرير السيد مرتضى المهري)
42ـ رسالة في تدوين الحديث (تقرير السيد محمد علي الرباني)
43ـ الأذان والإقامة (تقرير السيد مرتضى المهري)
44ـ رسالة في الربا (تقرير السيد هاشم الهاشمي)
45ـ رسالة في مسجد الجبهة (تقرير السيد مرتضى المهري)
أما الكتب الفتوائية للسيد السيستاني (دام ظله) فأبرزها ما يأتي:
1ـ منهاج الصالحين. 3 مجلدات
2ـ تعليقة على العروة الوثقى. 2 مجلد
3ـ المسائل المنتخبة.
4ـ مناسك الحج وملحقاتها.
5ـ الوجيز في احكام العبادات.
6ـ الفتاوى الميسرة.
7ـ الفقه للمغتربين.
8ـ الميسر في الحج والعمرة.
9ـ أسئلة حول رؤية الهلال مع أجوبتها.
أبرز تلامذة السيد السيستاني
حضر درس السيد السيستاني (دام ظله) نخبة من الفضلاء والمجتهدين الذين يعدون اليوم من المشتغلين على الساحة والفاعلين في ميدان العمل، سواء في التأليف أو التدريس أو التبليغ أو نشاطات أخرى، في مختلف البلدان الاسلامية كالعراق وإيران والسعودية والبحرين ولبنان، أبرزهم:
1ـ السيد محمد رضا السيستاني
هو ابن المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله)، ولد في النجف الأشرف في17 ربيع الأول 1382 هـ الموافق 1962، وتخرج على يد أعلام حوزة النجف، ومن أبرزهم كان أبو القاسم الخوئي والسيد علي السيستاني وعلي البهشتي. يقوم بإدارة مكتب السيد السيستاني في النجف.
نشأ السيد محمد رضا وترعرع في ظل والده، نشأ في جو من الإيمان والتقوى والأخلاق الحميدة، ترعرع في بيت علم ومعرفة وحكمة وسداد، دخل الحوزة العلمية في سن مبكرة.
متزوج ولديه أربعة أبناء، هم:
ـ حسن السيستاني
ـ حسين السيستاني
ـ محسن السيستاني
ـ محمد السيستاني
وللسيد محمد رضا السيستاني مؤلفات وبحوث عديدة، أهمها:
ـ بحوث في مناسك الحج، 21 مجلدًا، وهي تقريرات أبحاثه الفقهية.
ـ وسائل المنع من الإنجاب ويليه بحث حول جنابة المرأة بغير المقاربة.
ـ وسائل الإنجاب الصناعية.
ـ قبسات من علم الرجال، ثلاث مجلدات، وهي تقرير لأبحاثه الرجالية.
ـ الذبح بغير الحديد والزي والتجمل ومسائل أخرى.
ـ التظليل للمحرم.
ـ التكفير في الصلاة.
ـ اتّحاد الآفاق واختلافها في بداية الأشهر القمرية، وهو تقرير لأبحاثه.
ـ زواج البكر الرشيدة بغير إذن الولي، وهو تقرير لبحثه
ـ كتاب العلل للفضل بن شاذان، وهو تقرير لبحثه.
2ـ السيد محمد باقر السيستاني
هو آية الله محمد باقر ابن المرجع الأعلى السيد السيستاني، أستاذ في البحث الخارج في الفقه والأصول والتفسير والعقائد في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، له كثير من المحاضرات في الأخلاق كذلك.
ولد السيد محمد باقر في النجف ونشأ وترعرع في ظل والده، نشأ في جو من الإيمان والتقوى والأخلاق الحميدة، ترعرع في بيت علم ومعرفة وحكمة وسداد، دخل المدرسة الأكاديمية ثم التحق بالحوزة في سن مبكرة.
أهم أساتذته هم السيد الخوئي ووالده السيد السيستاني، والسيد محمد رضا أخوه الأكبر، والشيخ الإيرواني أيضا، وكان يدرّس في الحوزة آنذاك المقدمات للطلبة، وبعد الانتفاضة الشعبانية بدأ يدرّس السطوح والسطوح العليا، وكانت حلقة درسه من الحلقات الأكبر حضورا في تلك الفترة العصيبة، فقد كانت إلى جانب حلقات عدد من أساتذة الحوزة العلمية وفضلائها من أكبر حلقات الدرس آنذاك، التي خرّجت قامات علمية في أحنك الظروف وأعصب المراحل التي تخللها المضايقات والمطاردات والسجن والتعذيب.
أهم مؤلفاته:
ـ كتاب مباني الأصول
ـ كتاب منجزية العلم الإجمالي
ـ كتاب منهج التثبت في الدين
ـ كتاب إرث الزوجة
ـ كتاب أصول تزكية النفس وتوعيتها
ـ كتاب محاضرة في العقيدة
ـ كتاب سلسلة محاضرات فكرية
ـ كتاب سلسلة محاضرات تربوية
3ـ السيد محسن الهاشمي الكلبيكاني
4ـ الشهيد السيد حبيب حسينيان
5ـ الشيخ مهدي حسن عيسى المصلي
6ـ السيد محمد علي الرباني
7ـ السيد رياض الحكيم
8ـ السيد مرتضى المهري
9ـ السيد حسن المرعشي
10ـ السيد منير الخباز
11ـ الشيخ مهدي مراويد
12ـ الشيخ باقر الإيرواني
13ـ السيد حميد المقدس الغريفي
14ـ السيد صالح الخرسان
15ـ الشيخ القائيني
16ـ السيد مرتضى الاصفهاني
17ـ الشيخ مصطفى الهرندي
18ـ السيد احمد المددي
19ـ السيد هاشم الهاشمي
20ـ الشيخ جواد احمد البهادلي
[1] ـ ينظر: معالم المرجعية الرشيدة للسيد منير الخباز: 55.
[2] ـ حديث صرح به آية الله السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) في بداية محاضرة البحث الخارج يوم الأربعاء 22 صفر 1438هـ.
[3] ـ يراجع الرابط: http://www.almohsin.org/?act=gal&action=view&sid=727
[4] ـ معالم المرجعية الرشيدة: 74.
[5] ـ المصدر نفسه: 74 – 75.
[6] ـ ينظر: معالم المرجعية الرشيدة: 75 – 77.
[7] ـ ينظر: المصدر نفسه: 77 – 78.
[8] ـ ينظر: معالم المرجعية الرشيدة: 79 – 81.
[9] ـ المصدر السابق: 81 – 83.