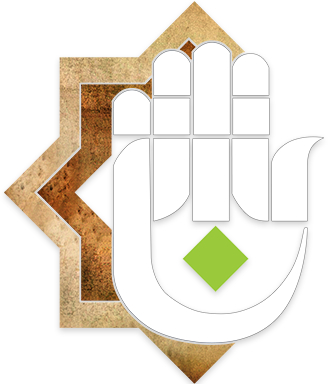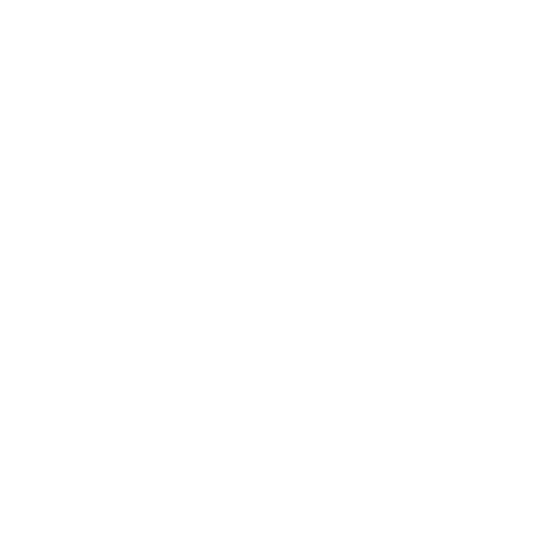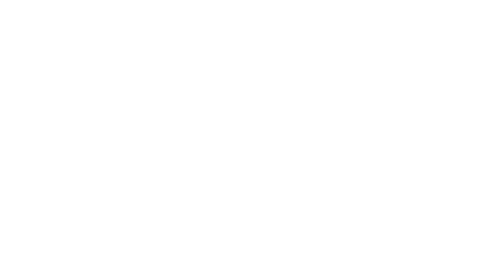المؤلف حسن ملايي
مقدّمة المؤلّف
على الرغم من أنّ دراسة المعارف الدينيّة من منظور معيّن تُظهر بوضوح أنّ القضايا المهدويّة تشكّل جزءاً مؤكّداً من هذه المعارف؛ فإنّه لا بدّ من الإقرار بأنّ المواضيع المهدويّة ليست جميعها بمستوى واحد من الأهمّيّة والأولويّة، بل بعضها يحظى بأهمّيّة أكبر، وهو أولى بالاهتمام والبحث.
تعدّ مسألة ظهور إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) وإقامة حكومته العالميّة؛ أهمّ المواضيع والأبحاث المهدويّة، ذلك للتحوّلات الجذريّة التي ستحدثها في حياة البشر وتكاملهم في شتّى الجوانب، لكن ما يبعث على الأسف أنّ بعضهم، وعوض أن يصبّوا جهدهم على الشروط اللازم تحقّقها للظهور والعمل على تحقيقها، يفرطون في البحث عن علائم الظهور وهي لا تأثير لها في مسألة الظهور، ولا تكليف لنا قبالها. والنتيجة أنّه بدل العمل على إنهاء غربة الغائب الغريب، يساهمون في زيادة غربة الإمام بالغفلة عن تكليفهم ووظيفتهم!
هذا الكتاب هو حاصل جمع أفكار وآراء حجّة الإسلام والمسلمين محسن قراءتي. يجدر بالذكر أنّه تمّ الاعتماد في كتابة هذا الكتاب على «مجموعة الآثار» الإلكترونيّة التي تشتمل على آثار سماحته
المكتوبة، بالإضافة إلى محاضراته على امتداد 30 عاماً ضمن سلسلة «الدروس القرآنيّة».
يسعى هذا الكتاب إلى تقديم رؤية عامّة صحيحة عن الظهور وشروطه، وتصويب التصوّرات الخاطئة في هذا الموضوع، وذلك اعتماداً على أوثق مصادر الدين ألا وهو القرآن الكريم، وبالاستعانة بتراجمة الوحي الحقيقيّين أي المعصومين (عليهم السلام)، ليكون ذلك خطوة على طريق تمهيد الظروف الإنسانيّة للظهور، ما يفتح السبيل لتعلّق إرادة الله تعالى بالإذن في الظهور.
الفصل الأوّل: قضيّة الظهور في القرآن الكريم والأحاديث
تمهيد
الحديث حول مقدّمات الظهور وشروطه، لا سيّما مع لحاظ الآيات القرآنيّة؛ يعدّ من أهمّ مواضيع الأبحاث المهدويّة، والذي يشكّل ضرورة لكلّ منتظري إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه). لكن، وقبل الشروع في البحث، نحتاج إلى ذكر بعض المقدّمات التي سنعتمد عليها في بيان المطالب التي سنتعرّض إليها.
أوّلاً: حتميّة ظهور المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) في القرآن
إنّ مسألة الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) وقيامه العالميّ، بالإضافة إلى الآيات القرآنيّة والروايات الكثيرة عند الشيعة؛ جاءت في أغلب كتب الحديث عند العامّة أيضاً، وهي من المسلّمات الاعتقاديّة عند المسلمين. كما نعلم، فإنّ الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) ولد سنة 255 هـ ق، ليغيب بعد ذلك عن أعين الناس لدواعٍ مختلفة، وكانت غيبته (عجل الله تعالى فرجه) على مرحلتين: غيبة صغرى، وغيبة كبرى. خلال الغيبة الصغرى، التي استمرّت ما يقرب من سبعين عاماً؛ كان النوّاب الأربعة الخاصّون صلة الوصل بين الشيعة وإمام زمانهم (عجل الله تعالى فرجه)،
وكانوا يرجعون إليه من خلالهم لمعرفة وظائفهم الدينيّة، وقد استمرّ الحال على ذلك إلى أن أعلم الإمام (عجل الله تعالى فرجه) نائبه الرابع عليّ بن محمّد السمريّ برحيله عن هذه الدنيا بعد أيّام قليلة، وأنّه ما من سفير خاصّ بعده بين الإمام (عجل الله تعالى فرجه) والناس، وكان ذلك إيذاناً ببدء الغيبة الكبرى.
وقد بيّن (عجل الله تعالى فرجه) للشيعة الطريق إلى معرفة وظائفهم وتكاليفهم، وأمرهم بالرجوع إلى العلماء، فقال:
«أَمَّا اَلْحَوَادِثُ اَلْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ»[1].
ومذ ذاك، بدأت الغيبة الكبرى للإمام (عجل الله تعالى فرجه)، وما زالت مستمرّة حتّى الآن، بحيث سيظهر بعدها الإمام (عجل الله تعالى فرجه) لإقامة حكومة العدل العالميّة كما جاء في مئات الآيات والأحاديث المعتبرة.
وفي ما يأتي بعض الآيات التي تتحدّث عن حتميّة تشكيل الحكومة المهدويّة:
1. الآية الأولى:
﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ ٣٣﴾[2]
بالإضافة إلى هذه السورة، جاءت هذه الآية نفسها في سورتين أخريين: سورة الفتح، الآية 28، وسورة الصفّ، الآية 9. صحيح
أنّ الغلبة دائماً للإسلام من حيث المنطق والاستدلال، إلّا أنّ الآية هنا تتحدّث عن الغلبة الظاهريّة المادّيّة وتعِد بحاكميّة الإسلام على العالم [بأسره]؛ وهذا هو معنى كلمة «ظَهَرَ» التي جاءت في آيات أخرى حيث أتت بمعنى الاستيلاء: قال تعالى: ﴿إِن يَظۡهَرُواْ عَلَيۡكُمۡ يَرۡجُمُوكُمۡ﴾[3].
وفي الحديث عن الكفّار قال تعالى: ﴿إِن يَظۡهَرُواْ عَلَيۡكُمۡ لَا يَرۡقُبُواْ فِيكُمۡ إِلّا وَلَا ذِمَّةۚ﴾[4].
فمن جهة، هذه الآية لم تتحقّق إلى الآن، ومن جهة أخرى، فإنّ الله [تعالى] وعد بحاكميّة الإسلام المطلقة، والله لا يخلف وعده. وعليه، فإنّ هذه الآية– وكما جاء في كثير من الروايات– تشير إلى ظهور الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه).في حديث للإمام الصادق (عليه السلام) يقول: «إذا قَامَ اَلْقَائِمُ (عليه السلام) لاَ يَبْقَى أَرْضٌ إِلّا نُودِيَ فِيهَا بِشَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلّا اَللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ»[5].
وقال (عليه السلام): «إِذَا قَامَ اَلْقَائِمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَكَمَ بِالْعَدْلِ، وَاِرْتَفَعَ فِي أَيَّامِهِ اَلْجَوْرُ، وَأَمِنَتْ بِهِ اَلسُّبُلُ، وأَخْرَجَتِ اَلْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا، ورَدَّ كُلَّ حَقٍّ إِلَى أَهْلِهِ، ولَمْ يَبْقَ أَهْلُ دِينٍ حَتَّى يُظْهِرُوا اَلْإِسْلاَمَ ويَعْتَرِفُوا بِالْإِيمَانِ، أَمَا سَمِعْتَ اَللَّهَ عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَلَهُ أَسلَمَ مَن فِي السماوات والأرض طَوعا وَكَرها وَإِلَيهِ يُرجَعُونَ﴾ (آل عمران: 83)،
وحَكَمَ فِي اَلنَّاسِ بِحُكْمِ دَاوُدَ وحُكْمِ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله)، فَحِينَئِذٍ تُظْهِرُ اَلْأَرْضُ كُنُوزَهَا وتُبْدِي بَرَكَاتِهَا، فَلاَ يَجِدُ اَلرَّجُلُ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ مَوْضِعاً لِصَدَقَتِهِ»[6].
2. الآية الثانية:
﴿وَلَقَدۡ كَتَبۡنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعۡدِ ٱلذِّكۡرِ أَنَّ ٱلۡأَرۡضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّٰلِحُونَ﴾ (الأنبياء: 105)
كلمة الزبور في اللغة العربيّة تعني الكتاب: ﴿وَكُلُّ شَيء فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾ (القمر: 52)، لكن وبقرينة آية: ﴿وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورا﴾ (النساء: 63) يظهر أنّ المراد هنا في الآية الكتاب الخاصّ بالنبيّ داوود (عليه السلام) الذي يشتمل على مجموعة من مناجاته وأدعيته ووصاياه، وقد نزل هذا الكتاب بعد نزول التوراة التي عبّرت عنها هذه الآية بالذكر، وهو ما جاء أيضاً في الآية 84 من السورة نفسها، إذ عبّرت عن التوراة بالذكر أيضاً.
وقال بعضهم إنّ المراد بـ «الزبور» في هذه الآية هو جميع الكتب السماويّة، وإنّ المراد بـ «الذكر» القرآن المجيد، ومعنى «من بعد» أي من بعد كتابته في الذكر، وعلى ذلك يكون معنى الآية: كتبنا في الكتب السماويّة بعد ما كتبنا في القرآن أنّ ورثة الأرض هم عبادنا الصالحون. وقد جاء في روايات متعدّدة أنّ العباد الصالحين الذين سيرثون الأرض هم الإمام المهديّ(عجل الله تعالى فرجه) وأصحابه[7].
في الواقع، إنّ مجيء المخلّص اعتقاد تؤمن به جميع الأديان؛ لذا، جاء في الزيارة المهدويّة: «السَّلَامُ عَلَى مَهْدِيِّ الأُمَم»[8].
من هنا، كان ظهوره (عجل الله تعالى فرجه) أحد المواضيع المهمّة في الدراسات المهدويّة.
ثانياً: علّة الغيبة وارتباطها بقضيّة الظهور
لقد بيّنت أحاديث كثيرة علّة عدم [التشرّف] بحضور إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه)؛ ومن جملة الأسباب التي ذُكرت في هذا السياق، ارتكاب الذنوب، والتي ذكرها الإمام (عجل الله تعالى فرجه) نفسه بحيث قال: «فَمَا يَحْبِسُنَا عَنْهُمْ إِلّا مَا يَتَّصِلُ بِنَا مِمَّا نَكْرَهُهُ»[9]، فهذا النصّ يذكر صراحة أنّ أعمالنا القبيحة هي التي تحول بيننا وبين التوفيق لإدراك الظهور.
كذلك، جاء في [الرواية] عن الإمام الصادق (عليه السلام) حين سُئل عن علّة غيبة إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه): «وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عُنُقِهِ»[10]، أي أنّ الإمام إن يظهر يُقتل. وعليه، نخلص من مجموع الروايات إلى أنّ علّة غيبة الإمام الثاني عشر (عليه السلام) هي أنّ الناس لم يصبحوا مهيّئين بعد لتقبّل قيادة إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه)؛ فقد ادّخر الله تعالى ذلك الإمام للزمان المناسب، يوم يبلغ الناس من الرشد والثقافة ما يمكّنهم من إدراك نوره والتنوّر به.
على سبيل المثال، حينما تقوم إدارة شركة الكهرباء بنصب عمود ومصباح في زقاق ما لإنارته، فيقوم أطفال ذلك الزقاق برمي المصباح بالحجارة وكسره، سيعمد الموظّف المعنيّ إلى استبداله، فإن قام الأطفال بكسره مجدّداً ستقوم إدارة شركة الكهرباء باستبداله مرّة أخرى بمصباح جديد كي لا يعمّ ذلك الزقاق الظلام. أمّا إذا ما قام الأطفال بكسره مرّة أخرى؛ فثمّة احتمال كبير أن تتّجه إدارة الشركة إلى عدم وضع مصباح جديد. نعم، قد تعمد إلى استبداله مجدّداً نزولاً عند رغبة وجهاء الزقاق وطلبهم، وكذلك من أجل راحة المقيمين فيه؛ لكن إلى أيّ مدى ستستمرّ إدارة شركة الكهرباء باستبداله برأيك؟ في ما نحن فيه أيضاً، قام الحكّام الظَلَمة بمواجهة أحد عشر مصباحاً من مصابيح الهداية! فحفظ الله المصباح الثاني عشر إلى زمن تتوفّر فيه لدى الناس اللياقة والاستعداد للاستفادة من مصباح الهداية هذا؛ من هنا، لا بدّ من تهيئة الأرضيّة للظهور وللدولة المهدويّة من خلال تأمين الظروف والأسباب اللازمة لذلك.
ثالثاً: التمهيد للظهور في القرآن
ثمّة آيات في القرآن [الكريم] تتحدّث عن ضرورة وجود الاستعدادات واللياقات الإنسانيّة لنزول الرحمات الإلهيّة وظهورها وتحقّقها؛ يقول تعالى:
﴿وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَٰت مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذۡنَٰهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ﴾ (الأعراف: 196).
إنّ عصر ظهور الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) من مصاديق هذه الآية البارزة، إذ تقول الروايات إنّ السماء والأرض تبديان بركاتهما. جاء عن الإمام الصادق (عليه السلام):
«إِذَا قَامَ اَلْقَائِمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَكَمَ بِالْعَدْلِ، وَاِرْتَفَعَ فِي أَيَّامِهِ اَلْجَوْرُ، وَأَمِنَتْ بِهِ اَلسُّبُلُ، وأَخْرَجَتِ اَلْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا، ورَدَّ كُلَّ حَقٍّ إِلَى أَهْلِهِ[11].
ويقول الإمام الحسن (عليه السلام):
«وتصطلح في ملكه السباع، وتخرج الأرض نبتها، وتنزل السماء بركتها، وتظهر له الكنوز»[12].
ثمّة نكات في الآية تؤكّد أهمّية سعينا في استجلاب الرحمة الإلهيّة:
1. الإيمان وحده لا يكفي، بل لا بدّ من التقوى: ﴿آمنوا وَاتَّقَواْ﴾.
2. الإغلاق والفتح بيد الله [تعالى] ﴿لَفَتَحنَا﴾، لكنّ ذلك تبع لأعمالنا.
3. إنّ سبب الحرمان والمشكلات التي نواجهها إنّما هو أعمالنا نحن: ﴿بِمَا كَانُواْ يَكسِبُونَ﴾.
من هنا، كان لا بدّ لكي يحكم الإسلام العالم، وتعمّ النعمات الإلهيّة البشريّة؛ من تهيئة ظروف ذلك.
رابعاً: القرآن ومكانة السعي في تحقيق الآمال
إن تطلّعات الإنسان تشكّل الدافع له في حياته، ويحيا على أمل تحقيق أمنياته وآماله متحريّاً السبيل للوصول إليها. وللسعي والجدّ سهم كبير في تحقيق الآمال والمنافع، فقد جاء في القرآن الكريم:
﴿وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩ وَأَنَّ سَعۡيَهُۥ سَوۡفَ يُرَىٰ﴾ (النجم: 39-40).
هاتان الآيتان تبيّنان بوضوح:
1. إنّ الحياة هي ميدان السعي والعمل والحصاد: ﴿وَأَن لَّيسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾.
2. نحن مكلّفون بأداء الوظيفة لا بتحقّق النتيجة، وظيفتنا هي السعي والعمل: ﴿إِلَّا مَا سَعَى﴾.
3. إنّ الإيمان ببقاء الأعمال، ومنظومة الثواب والعقاب العادلة؛ يشجّعان الإنسان على العمل من جهة، ويدفعانه إلى الاحتياط والتحلّي بالمسؤوليّة من جهة أخرى: ﴿وَأَنَّ سَعيَهُ سَوفَ يُرَى﴾.
4. ليس هناك انعدام لأيّ عمل من الأعمال: ﴿سَعيَهُ سَوفَ يُرَى﴾.
5. على الصالحين عدم الاستعجال في الحصول على ثواب أعمالهم: ﴿سَوفَ يُرَى﴾.
إنّ أحد الآمال العظيمة والمقدّسة عندنا جميعاً نحن الشيعة؛ هو ظهور إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه)، وقد يقول بعضنا: نحن لسنا على دراية بكثير ممّا يمهّد لظهور الإمام (عجل الله تعالى فرجه)! لكنّ القرآن يرفض اتخاذ ذلك ذريعة لعدم السعي والعمل. ومن أجل مواجهة هذا الفكر الخاطئ، يرى القرآن الكريم أنّ السعي في سبيل الله يمهّد لنيل اللطف الإلهيّ الخاصّ، ويهدي إلى السبل التي كانت حتّى الآن غائبة عن أنظارنا، ولم نكن على علم بها؛ يقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهدِيَنَّهُم سُبُلَنَا﴾ (العنكبوت: 69).
خلاصة القول: لا يمكن بلوغ [الغايات] بالشعارات والآمال، إنّما العمل والجهد والجدّ هي ما يذيق الإنسان حلاوة النجاح. من هنا، لا بدّ للذين يريدون واقعاً أن يدركوا عصر ظهور إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) وحكومته العادلة وأن ينهلوا من بركاتها؛ من أن يعملوا بكلّ ما أوتوا من قوّة من أجل تحقيق مثل هذه الحكومة.
خامساً: العلاقة بين السعي والدعاء في القرآن
إنّ الدعاء [بتعجيل] الفرج والظهور هو واحد من الأعمال التي على منتظري القدوم المبارك لإمام العصر (عجل الله تعالى فرجه) أن يقوموا بها في عصر الغيبة. وإمام العصر (عجل الله تعالى فرجه) نفسه قد دعانا إلى ذلك: «وَأَكْثِرُوا اَلدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ اَلْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ»[13]. وهذا ما دعا بعضهم إلى السؤال عن الحاجة إلى العمل على التمهيد للظهور إذا كان علينا الدعاء لظهور إمام الزمان؟
جواب ذلك أنّ الدعاء إنّما يكون إلى جانب السعي والجدّ وليس بديلاً عنهما. وقد ذكر القرآن الكريم ما كان يدعو به المجاهدون الذين ارتدوا دروعهم وتجهّزوا [للقتال]:
﴿رَبَّنَآ أَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾ (البقرة: 250).
وسرّ ذلك أنّه على الرغم من أنّ الإنسان مكلّف بالتحرّك والسعي؛ إلّا أنّ النصر بيد الله [تعالى]، لذا، كانوا يتوجّهون إلى الله أوّلاً ويسألونه النصر: ﴿رَبَّنَآ... وَٱنصُرۡنَا﴾.
إذاً، لا تنجز كلّ الأمور على أيدينا، المسألة ليست على هذا النحو. قد تقوم، مثلاً، بالضغط على جميع مفاتيح تشغيل الكهرباء؛ في حين أنّ التيّار مفصول عن الشبكة من المصدر. فحينما تفصل شركة الكهرباء التيّار عن الشبكة، لن تتمكّن من إنارة المصابيح حتّى لو ضغطت على جميع مفاتيح الكهرباء، بما أنّ التيّار مفصول من المصدر. إن لم يرد الله [تعالى أمراً]، لن تجني فائدة مهما بالغت في السعي نحوه. لذا، حين تشرع قل: «إنْ شاءَ اللَه».
إذا نظرنا في حياة المعصومين (عليهم السلام)، نجد أنّهم وعلى الرغم من كونهم مظهر الدعاء؛ ما فتئوا يقضون ليلهم ونهارهم في السعي والجدّ. ما كان أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل ساحات الجهاد فحسب، بل كان رجل العمل في المجتمع والمنزل أيضاً؛ كان يجمع العلف، ويصلح نعله، ويحمل قربة الماء إلى الأيتام، أي أنّه كان يؤدّي خدمات اجتماعيّة. وكان الإمام الباقر (عليه السلام) يعمل
في أرضه والمعول بيده في حرّ الحجاز الحارق حينما مرّ به رجل متصوّف فنظر إليه وقال: أصلحك الله، شيخٌ من أشياخ قريش في هذه الساعة في طلب الدنيا. كيف لو جاءك الموت وأنت على هذه الحالة؟!
فقال له الإمام (عليه السلام): «لو جاءني –والله– الموت وأنا على هذه الحال، جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله أكفّ بها نفسي عنك وعن الناس».[14]
لقد ذكرت الروايات أنّ دعاء الداعين بلا عمل ولا سعي غير مجاب. وهذه مسألة لها جذورها القرآنيّة؛ فحينما نرجع إلى هذا الكتاب السماويّ في مسألة شروط استجابة الدعاء؛ نجد أنّه ذكر الإيمان والعمل الصالح كشرطين من شروط الاستجابة، يقول تعالى:
﴿وَيَسۡتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾ (الشورى: 26).
سادساً: مكانة التوكّل في التمهيد للظهور
بالإضافة إلى ما تقدّم ذكره في مسألة التصوّر الخاطئ حول الدعاء [بتعجيل] الفرج، والذي قمنا بتوضيحه ورفع الشبهة عنه؛ فإنّ إحدى المشكلات العقديّة في موضوع التمهيد للظهور هي الفهم الخاطئ لمسألة التوكّل.
صحيح أنّ الإسلام يقدّم الله تعالى على أنّه المتّكل للإنسان، فمن جهة لا حدّ لقدرته [تعالى]، وهو القادر على كلّ شيء، ومنشأ كلّ قدرة، ومن جهة أخرى هو أرحم الراحمين، وجميع الصفات التي لا ينبغي أن يعتريها تزلزل في المتوكّل عليه لا توجد في أحد سواه؛ لكن، لا بدّ من أن نعلم أنّ التوكّل ليس في مقابل الجهد والسعي حتّى يأتي السؤال: أنسعى أم نتوكّل؟ التوكّل يعني أن يمضي الإنسان في طريق الحقّ ويعمل بمقتضاه، متّكلاً على الله في ذلك، فإنّه تعالى الحامي والمدافع عن الذين يدافعون عن الحقّ و[ينصرونه]. التوكّل ضمانة إلهيّة لمن كان دائماً نصيراً وداعماً للحقّ، وقد بنى الله العالم على الدفاع عن الذين يقفون دائماً إلى جانب الحقّ ويدافعون عنه. الحقّ مقرون دائماً بالتأييد المعنويّ.
أساساً، إنّ القعود عن العمل والمسير لا يحتاج إلى ضمانة، والسكون والتوقّف لا يحتاجان إلى تأييد، إنّما يُحتاج إلى التوكّل عند الألم والمشقّات التي تعترض المسير، والتي تضعف الإرادة وتوهن العزيمة. رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوماً لا يزرعون، قال: ما أنتم؟ قالوا: نحن المتوكّلون. قال: «لا، بل أنتم المتّكلون»[15]!
إذاً، ليس معنى التوكّل الخضوع أمام الأحداث، بل أن يستثمر الإنسان كلّ طاقته وقوّته، على أن يعلم في الوقت عينه أنّه ليس لديه شيء من نفسه، وأنّ الذين لا يمتثلون أمر الله ويغفلون عن الأخذ بالأسباب الماديّة والمعنويّة لن يكونوا مشمولين بالمدد الإلهيّ أبداً.
وعليه، ليس ثمّة علاقة بين التوكّل وعدم التمهيد للظهور، بل على العكس، لا بدّ من العمل والسعي من أجل ذلك، غاية الأمر أنّه لا ينبغي لنا أن نغترّ بأعمالنا، كما لا ينبغي لنا أن نتذرّع بالتوكّل للتوقّف عن السعي.
سابعاً: القرآن والإمداد الغيبيّ
المسألة التي يجدر التنبّه لها عند الحديث عن تهيئة مقدّمات الظهور؛ هي مكانة الإمدادات الغيبيّة في ظهور إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه)، ذلك لأنّ بعضهم فهم من الروايات التي تتحدّث عن أحداث الظهور، ووقوع الكرامات المختلفة أنّ ظهور المهديّ الموعود (عجل الله تعالى فرجه) سيكون إعجازاً إلهيّاً محضاً، الأمر الذي لا يبقى معه حاجة لسعي الناس؛ في حين أنّنا لو رجعنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أنّ هذا التصوّر خاطئ، وأنّ منشأه الفهم الخاطئ لمسألة الإمدادات الغيبيّة.
عندما نجلس في محضر القرآن الكريم، نجد أنّ مسألة الإمدادت الغيبيّة والإمدادات الإلهيّة ليست محلّ قبول فحسب، بل إنّ النصرة الحقيقيّة وفقاً للعقائد الإسلاميّة التوحيديّة إنّما هي من عند الله، والإنسان يفتقر إلى المدد الإلهيّ في سائر أحواله، عند ضعفه كما عند قوّته؛ فكما مدّ الله تعالى المسلمين بالنصرة يوم بدر، هو الذي أمدّهم أيضاً بالنصرة يوم حنين:
﴿لَقَدۡ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٖ وَيَوۡمَ حُنَيۡنٍ﴾ (التوبة: 25).
إنّ نصرة المؤمنين من خارج المسارات المعتادة، أو بتعبير آخر من خلال الإمدادات الغيبيّة؛ هي من ضمن بشارات هذا
الكتاب السماويّ للمؤمنين، فلهذه البشارات أثر كبير في زيادة الأمل وتعزيز روحيّتهم. لقد نقل لنا القرآن الكريم في الآية الثالثة عشرة من سورة «آل عمران» ما جرى في معركة بدر ونزول الإمدادات السماويّة لتكون عبرة لنا فقال: ﴿قَدۡ كَانَ لَكُمۡ ءَايَة فِي فِئَتَيۡنِ ٱلۡتَقَتَاۖ فِئَة تُقَٰتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخۡرَىٰ كَافِرَة يَرَوۡنَهُم مِّثۡلَيۡهِمۡ رَأۡيَ ٱلۡعَيۡنِۚ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصۡرِهِۦ مَن يَشَآءُۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبۡرَة لِّأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ﴾ (سورة آل عمران، الآية 13).
لقد كان عدد المسلمين في معركة بدر 313 رجلاً؛ 77 منهم من المهاجرين و236 من الأنصار. وقد كان الإمام عليّ (عليه السلام) حامل لواء المهاجرين، فيما كان حامل لواء الأنصار سعد بن عبادة. وفي حين كان لدى المسلمين في هذه المعركة 70 جملاً وحصانان وستّة أدرع، وثمانية سيوف؛ كان لدى جيش الكفر أكثر من ألف مقاتل، ومئة فارس، ومع ذلك، انتصر المسلمون على أعدائهم من الكفّار بعد أن قدّموا 22 شهيداً: أربعة عشر من المهاجرين وثمانية من الأنصار.
نجد في هذه الآية أنّ الكفّار رأوا المسلمين ضعفيهم: ﴿يَرَوۡنَهُم مِّثۡلَيۡهِمۡ﴾، ولم يكونوا كذلك؛ لكن الله تعالى إذا ما أراد قلّب الأبصار والتصوّرات والأفكار. إنّ معركة بدر أظهرت كيف أنّ إرادة الله [تعالى] غالبة على إرادة الخلق، وأنّ الإمكانات الماديّة لا تشكّل العامل الوحيد في تحقيق النصر. إذاً، ما من شكّ في أصل هذه المسألة.
نحن أيضاً نقبل أنّ للمدد الإلهيّ دوراً في مسألة الظهور
وتشكيل حكومة الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)، لكن ووفقاً للآيات القرآنيّة، فإنّ لتحقّق الإمدادات الغيبيّة شروطاً ومقدّمات على الناس أن يوفّروها. وهذا ما سنبحثه مفصّلاً تحت عنوان: مقدّمات الظهور المرتبطة بالناس، لكن لا بأس هنا من باب المثال أن نذكر إحدى الآيات التي تبيّن هذا الأمر –والتي تشكّل إحدى الآيات المهدويّة أيضاً-، بحيث يذكر القرآن الكريم في الآية 125 من سورة آل عمران:
﴿بَلَىٰٓۚ إِن تَصۡبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأۡتُوكُم مِّن فَوۡرِهِمۡ هَٰذَا يُمۡدِدۡكُمۡ رَبُّكُم بِخَمۡسَةِ ءَالَٰف مِّنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾.
كما تلاحظون، فإنّ هذه الآية الشريفة عدّت الاستقامة والتقوى سبباً في نزول الملائكة والإمدادات الغيبيّة؛ من هنا، صرّحت الأحاديث المرتبطة بأحداث الظهور بحضور المؤمنين الأكفاء المتّصفين بصفات خاصّة -والتي من جملتها هاتان الصفتان- إلى جانب الإمدادات الإلهيّة. جاء في الرواية أنّ الله يؤيّده بثلاثة أجناد: الملائكة، والمؤمنين، وبثّ الرعب في قلوب الأعداء.
وهذا هو الأصل والقاعدة الحاكمة في حياتنا أيضاً؛ فلا يقولنّ أحد: إنّ الله سيعينني في أموري الشخصيّة بالإمدادات الغيبيّة فأُقبل في امتحان الدخول هذا العام من دون الحاجة إلى الدرس، ولا يرجونّ المزارع أن يجني محصولاً جيّداً من خلال الإمدادات الغيبيّة فحسب، ومن دون حرث أو زراعة!
ليس من المفترض أن يعطّل ربّ العالمين النظام القائم في الكون، حينما يتحدّث القرآن الكريم عن القدرة الإلهيّة، فإنّه يقصد
القدرة القائمة على أساس الربوبيّة، والمقرونة بالحكمة. عند ذكر النصرة الغيبيّة الإلهيّة في معركة بدر في سورة الأنفال قال تعالى: ﴿وَمَا ٱلنَّصۡرُ إِلَّا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِيمِ﴾ (الأنفال: 10).
إنّ الله قادر على أن يرزق الأبوين الطفل من دون آلام الولادة؛ لكنّ حكمة الله تعالى تقتضي أن يولد الطفل مصحوباً بآلامها، وأن يجني المزارع ثماره بالزراعة: الحصول على الكنز من غير عمل ليس فيه أمل. مقتضى الحكمة الإلهيّة أن يبلغ الإنسان مناه بالكدّ والسعي والعمل.
ثامناً: شروط نزول الإمدادات الإلهيّة في القرآن
خلاصة ما مرّ أنّ الإمدادات الغيبيّة، وبعد أن نسعى سعينا؛ يمدّ الله بها من يشاء، لكن لذلك المدد شروطه. وفهم هذا الأمر مؤثّر جدّاً في معرفة موقع الإمدادات الغيبيّة من مسألة الظهور وتمكّن الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) من تشكيل حكومة العدل العالميّة. وهذه بعض الشروط للنصرة والإمدادات الإلهيّة:
1. الصبر والاستقامة
إنّ الله يحبّ الصابرين، وهم في حصنه، ومحلٌّ لمدده.
يقول القرآن: ﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (البقرة: 249). ويقول في مكان آخر متحدّثاً عن أولياء الله: ﴿فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمۡ نَصۡرُنَاۚ﴾ (الأنعام: 34)، وقال أيضاً: ﴿إِن تَصۡبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأۡتُوكُم مِّن فَوۡرِهِمۡ هَٰذَا يُمۡدِدۡكُمۡ رَبُّكُم بِخَمۡسَةِ ءَالَٰف مِّنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ (آل عمران: 125).
2. نصرة دين الله
يعدّ القرآن الكريم نصرة دين الله ونصرة وليّ الله من الشروط المهمّة لإنزال المدد الإلهيّ، يقول تعالى: ﴿إِن تَنصُرُواْ الله يَنصُركُم وَيُثَبِّت أَقدَامَكُم﴾ (محمد: 7).
3. الجهاد وقتال الأعداء
في الحقيقة، إنّ جبهات القتال أيضاً تعدّ مهداً لنزول المدد الإلهيّ، يقول سبحانه:
﴿قَاتِلُوهُم يُعَذِّبهُمُ الله بِأَيدِيكُم وَيُخزِهِم وَيَنصُركُم عَلَيهِم﴾ (التوبة: 14).
4. تقوى الله
إنّ أحد آثار تقوى الله التي تحظى بمكانة عظيمة في القرآن؛ أنّها – وبالإضافة إلى الآثار الأخرى التي تترتّب عليها– تستجلب رحمة ربّ العالمين وعونه الخاصّ. يقول الربّ الرؤوف في الآية 125 من سورة آل عمران:
﴿بَلَىٰٓۚ إِن تَصۡبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأۡتُوكُم مِّن فَوۡرِهِمۡ هَٰذَا يُمۡدِدۡكُمۡ رَبُّكُم بِخَمۡسَةِ ءَالَٰف مِّنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾.
5. الجهاد والسعي
إنّ سعي الإنسان في القرآن [الكريم] علامة إخلاصه، وهذا الإخلاص هو الموجب لنزول المدد الغيبيّ، يقول سبحانه:
﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ (العنكبوت: 69).
6. الإيمان بالله
حينما تحدّث القرآن الكريم في سورة الكهف عن أحوال أصحاب الكهف؛ عدّ إيمانهم الأمثل سبباً لشمولهم بالعناية الإلهيّة الخاصّة، بحيث قال:
﴿إِنَّهُمۡ فِتۡيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمۡ وَزِدۡنَٰهُمۡ هُدٗى ١٣ وَرَبَطۡنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ﴾ (الكهف: 13-14).
7. عدم موالاة الكافرين
ثمّة مسألة لافتة جدّاً يدعونا إليها القرآن مكرّراً، وهي أن لا نوالي الكفّار إذا أردنا أن تعمّنا الإمدادات الغيبيّة: ﴿لَا تَتَّخِذُواْ.. يَأۡتِيَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡر مِّنۡ عِندِهِۦ﴾ (المائدة: 52)، وِإلّا فمن والى الكافرين وكله الله إلى نفسه ومنع عنه الإمدادات الغيبيّة: ﴿وَمَن يَفعَل ذَلِكَ فَلَيسَ مِنَ الله فِي شَيءٍ﴾ (آل عمران: 28).
8. أداء التكليف
إنّ وظيفتنا وفقاً لتعاليم القرآن هي أداء التكليف وبعدها نرتقب المدد، وهذا ما أشارت إليه الآية 93 من سورة «هود» التي تناولت قصّة نبيّ الله شعيب (عليه السلام) في قوله تعالى:
﴿وَيَٰقَوۡمِ ٱعۡمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمۡ إِنِّي عَٰمِلۖ سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ مَن يَأۡتِيهِ عَذَاب يُخۡزِيهِ وَمَنۡ هُوَ كَٰذِبۖ وَٱرۡتَقِبُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمۡ رَقِيب﴾.
9. الاستغفار والتوبة
عندما نقف مع القرآن [الكريم]، نجد أنّ الاستغفار يجلب الرزق والإمدادات الغيبيّة. [قال تعالى]: ﴿ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارا... لَّكُمۡ أَنۡهَٰرا﴾ (نوح: 10-12).
وسنتعرّض أكثر لهذه المسألة في فصل «مقدّمات الظهور الإنسانيّة» ونذكر لها موارد أخرى.
تاسعاً: حقيقة الانتظار في العمل على التمهيد
من المسائل التي تعيننا أكثر على بيان موضوع شروط الظهور؛ التعرّف عن كثب على مفهوم انتظار الظهور ولوازمه. فقد اهتمّت الروايات عن المعصومين (عليهم السلام)كثيراً بهذه المسألة. روي عن أبي بصير، أنّ الإمام الصادق (عليه السلام) قال ذات يوم: «ألا أخبركم بما لا يقبل اللّه عزّ وجلّ من العباد عملاً إلّا به؟ فقلت: بلى، فقال: شهادة أن لا إله إلّا اللّه، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، والإقرار بما أمر اللّه، والولاية لنا، والبراءة من أعدائنا -يعني الأئمّة خاصّة- والتسليم لهم، والورع والاجتهاد والطمأنينة، والانتظار للقائم»[16].
كما جاء عن الإمام الرضا (عليه السلام):
«ما أحسن الصبر وانتظار الفرج! أما سمعت قول العبد الصالح ﴿فَانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ المُنتَظِرِينَ﴾» (الأعراف: 71)[17].
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أفضل العبادة انتظار الفرج»[18].
كلّ إنسان، حتّى في حياته المادّيّة، إنّما يحيا بالأمل وانتظار تحقّقه، وإذا ما خمد مصباح الأمل قعد عن المسير. المهمّ في البيان هو أن يعلم هذا الإنسان ما الذي يستحقّ الانتظار.
كلّ الناس لديهم أمنيات وآمال، أمّا العاقل الفطن فهو من ينتظر السلام العالميّ ويهتمّ بأمور جميع الخلق. قدر المرء على قدر ما يطلب؛ فأمنية الطفل لعبة؛ وكلّما سمت روحه سمت آماله وأمنياته. وأعظم الناس من كان في انتظار الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)؛ لأنّ انتظاره هو الأمل للعالم، والخير العالميّ، والعدل العالميّ، والأمنية العالميّة. كلّما كان ما يطلبه الإنسان أحقر كان الإنسان أصغر، وكلّما علا قدر ما يطلب علا شأنه، وانتظار الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)؛ يعني انتظار جميع المحاسن والخيرات، والقضاء على جميع القبائح والمساوئ.
لكن لا بدّ في الوقت نفسه من أن نعلم أنّ الانتظار عمل، فقد جاء في الروايات: «أَفْضَلُ الْأعْمالِ» لا «أفضل الحالات». إذاً، الانتظار عمل، لا حالة سكوت وسكون. إنّ الإنسان الذي ينتظر مسافراً غاب عنه مثلاً، والمزارع الذي ينتظر الثمار، لا يهدأ له بال، ونحن المنتظرين لمولانا؛ لا بدّ من أن يسانخ سلوكنا سلوكه (عجل الله تعالى فرجه)؛ فالمنتظر هو الإنسان العامل المجدّ.
إنّ الانتظار يعني رفض الوضع القائم، والرجاء بفتح أبواب الرحمة والمعرفة. الانتظار يعني أنّنا في انتظار عالَم يملؤه العدل.
نقرأ في دعاء «الافتتاح» المنسوب إلى إمام العصر (عجل الله تعالى فرجه): «اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إليك» أي إلهي! أنا أشكو إليك وأعلن رفضي للنظام الطاغوتيّ الحاكم على الأرض. وإن سأل أحدهم ما الحكومة التي ترضونها؟ فالجواب في تتمّة الدعاء: «إنَّا نرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَة كَرِيْمَة».
إنّ دعاء الندبة أيضاً دعاء الرفض لطواغيت العالم، دعاء الانتظار والأمل بحلول حكومة الحقّ. فحين نجتمع ونقرأ الندبة ونرجو تحقّق حكومة الحقّ؛ علينا أيضاً أن نفكّر ونعمل على التمهيد لتلك الحكومة.
عندما كان الأستاذ الشهيد مطهّري في طهران، وكان يتردّد إلى قمّ للتدريس، كنت ضيفاً عليه في قم مدّة من الزمن، كنت خلالها أطرح عليه أثناء الطريق الكثير من الأسئلة، من جملتها سؤال حول انتظار الظهور، فذكر مثالاً نقله عن المرحوم حجّة الإسلام راشد -الذي كانت كلماته تبثّ عبر الراديو وقد كان رجلاً عالماً- إذ قال: «عندما يحلّ الليل نكون جميعاً في انتظار طلوع الشمس، لكنّ انتظار الشمس لا يعني أن نجلس في الظلمة، فمن جهة ننتظر طلوع الشمس، ومن جهة أخرى لا بدّ من أن ننهض ونعمل ونشعل المصباح».
من كان في انتظار المصلح يجب أن يكون صالحاً. الناس غير المبالين، من لا غيرة لهم، ولا مال ولا قدرة؛ لن يكون بإمكانهم القول للحجّة بن الحسن (عجل الله تعالى فرجه): أقدم إلينا! من لم يكن لهم دور في الثورة والنظام الإسلاميّ ولا دور لهم الآن، عليهم أوّلاً أن يسألوا الله أن يكون لهم دور في ذلك، ثمّ يقرؤوا دعاء الندبة بعد ذلك.
عندما نقول: أقدم يا مهديّ، فعلى ما سيقدم؟ ستقولون حتماً سيأتي للدفاع عن حقوق الناس. حسناً، كم دافعتم عن حقوق الناس خلال مرحلة الحرب المفروضة؟ كم سبحتم في هذه البركة حتّى تتحدّثوا عن قطع المحيط الأطلسيّ! أساساً من لم يكن لهم دور في الثورة، لا يمكن لهم القول: أقدم يا مهديّ!
العديد من الآيات القرآنيّة المهدويّة المرتبطة بمنتظري الظهور، لحظ هذا الاستعداد، يقول القرآن الكريم:
﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَۖ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمۡ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ وَنُورُهُمۡۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَِٔايَٰتِنَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ﴾ (الحديد: 19).
يروي الحارث بن المغيرة عن الإمام الباقر (عليه السلام):
«العارف منكم هذا الأمر، المنتظر له، المحتسب فيه الخير، كمن جاهد والله مع قائم آل محمّد بسيفه، ثمّ قال: بل والله كمن جاهد مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسيفه، ثمّ قال الثالثة: بل والله كمن استشهد مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في فسطاطه، وفيكم آية في كتاب الله. قلت: وأيّ آية جعلت فداك؟ قال: قول الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَۖ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمۡ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ وَنُورُهُمۡۖ﴾ (الحديد: 19)، ثمّ قال: صرتم والله صادقين، شهداء عند ربكم»[19].
إنّ الآية التي تتحدّث عن المنتظرين للظهور؛ تصفهم بالـ، «الصدّيق»، وهذه الصفة تقال لمن كان الصلاح يغشاه من رأسه
إلى أخمص قدميه، ومن كان قوله وعمله واحد، ومن كان الصدق خلقاً من أخلاقه قد جبل به. ومن الواضح أنّ اكتساب هذه الخصلة السامية علامة على الاستعداد لظهور إمام الحقّ.
عاشراً: وظيفتنا في أمر الظهور
في مبحث الظهور، لا أهميّة كبيرة لمعرفة الوقت الذي سيظهر فيه إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه)، أو معرفة المكان الذي يعيش فيه الإمام، إنّما المهمّ أن نعرف ما هي وظيفتنا الآن، وما الذي ينتظره منّا الإمام فنقوم به، لأنّ أداء التكليف هو السبيل الأفضل في التمهيد لظهور وليّ العصر (عجل الله تعالى فرجه). من هنا، كانت معرفة التكليف أهمّ الأمور في زمن غيبة الإمام (عجل الله تعالى فرجه)، وهو ما سنشير إلى بعض عناوينه هنا، أمّا توضيحه فيأتي:
1. معرفة إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) ومعرفة أهدافه، وهو ما جاء في الدعاء: «اللّهم عرّفني حجتك فإن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني»[20].
2. تعريف الآخرين على الإمام (عجل الله تعالى فرجه) وقيامه العالميّ، والتمهيد للظهور.
3. العمل على جلب رضى إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) من خلال القيام بالأعمال الصالحة والارتباط الروحيّ به.
4. انتظار الفرج والدعاء بتعجيل ظهور الإمام (عجل الله تعالى فرجه).
5. التصدّق عن الإمام (عجل الله تعالى فرجه) والدعاء لحفظه.
6. الصلاة، وقراءة دعاء الفرج والندبة والعهد، والسلام الكامل، كدعاء الاستغاثة بالإمام الحجّة(عجل الله تعالى فرجه).
7. دفع الخمس والسهم الخاصّ بإمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه).
8. العمل بالتكليف وأداء الواجبات، والابتعاد عن الذنوب والمحرّمات.
إنّ التاجر الذي يحتال على الناس؛ حتماً لن يكون من المنتظرين لظهور إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه).
أولئك الذين قلّما يعملون ويسعون وراء رزقهم، والذين يسيئون العمل ويقدمون على الخيانة، ليسوا من منتظري إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه).
حادي عشر: لزوم الاهتمام بشروط الظهور لا بعلاماته
إن كان القيام بالتكليف في عصر الغيبة هو محور عملنا؛ فاعلموا أنّ أحد التكاليف التي علينا القيام بها هو التمهيد للظهور. من هنا، يجب علينا الاهتمام بشروط الظهور لا بعلاماته، وهذا ما حصلت الغفلة عنه مع الأسف نتيجة عدم اهتمام الكثير من شيعة الإمام (عجل الله تعالى فرجه) به. وعوضاً عن الاهتمام بمعرفة شروط الظهور وتحقيقه، انصبّ اهتمامهم على علاماته.
إنّ عدم الظهور يدلّ على أنّ الأرض لم تمهّد بعد لذلك؛ فلا بدّ من السعي والعمل على تهيئة الأرضيّة اللازمة. إنّما يظهر وليّ العصر (عجل الله تعالى فرجه) إذا ما وقف الناس على المعارف القرآنيّة والإسلاميّة وأصبحوا مستعدّين لحكومته.
من ينتظر المصلح لا بدّ من أن يكون صالحاً. لا يمكن للمرء أن يكون منتظراً للمصلح ثمّ لا يكون في نفسه صالحاً، ليس من الصحيح أن نجلس وننتظر مجيء إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) ليقوم بعمليّة الإصلاح. نحن ننتظر طلوع الشمس، لكنّنا نشعل المصباح ليلاً، نحن ننتظر الشمس والوقت ليل، فنشعل المصباح بأنفسنا. نحن منتظرون لإمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه)، وفي الوقت نفسه علينا العمل والسعي.
الفصل الثاني: شروط ظهور إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه)
تمهيد
بملاحظة المطالب التي تقدّمت، [نخلص] إلى أنّ ظهور إمام الزمان يستدعي شروطاً ومقدّمات بعضها بيد الله تعالى وبعضها لا بدّ للإنسان من أن يعمل على تحقيقه. وقد بُيّنت هذه الشروط في آيات القرآن كما في الأحاديث. وما نحن بصدده هو تعداد هذه الشروط الإلهيّة والإنسانيّة للظهور وبيانها.
أوّلاً: الشروط الإلهيّة للظهور
تقدّم القول إنّ لظهور إمام العصر (عجل الله تعالى فرجه) مقدّمات وشروطاً لا بدّ من تحقّقها، بعضها بيد الله، وبعضها يرتبط بالإنسان. وسيأتي الحديث عن مقدّمات الظهور الإنسانيّة، أمّا الشروط الإلهيّة للظهور فهي:
1. الإرادة الإلهيّة
من التعاليم القرآنيّة الأصيلة أنّ كلّ الحوادث التي تقع في هذا العالم إنّما تقع بإذن الله وإرادته، وما لم يشأ تعالى لن يكون
من حادث في هذا الوجود، وهذا ما يسمّى بالتوحيد الأفعاليّ. في الواقع، إنّ إرادة الإنسان غير مستقلّة عن إرادة الله، ولا هي غالبة على إرادته، وإنّما يتحقّق مراد الإنسان إذا ما تعلّقت به إرادة الله [تعالى]، يقول تعالى في القرآن الكريم: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ (التكوير: 29).
لمّا كان الله هو ربّ العالمين، وعمّ كلّ شيء سلطانه، كانت إرادة الإنسان مقيّدة بإرادته [تعالى]؛ كما عليه الحال في سيّارات تعليم القيادة بحيث يوجد فيها آليّتان لضخّ الوقود وآليّتان للمكابح، إحداهما يتحكّم بها المتدرّب وأخرى المدرّب. في هذه السيّارة يمكن للمتدرّب أن يستعمل آليّتي ضخّ الوقود والمكابح الخاصّة به، لكن بشرط أن يريد المدرّب ذلك أيضاً، أو كما هو الحال في الصكّ المصرفيّ الذي يحتاج إلى توقيعين؛ بحيث يمكن لكلّ من صاحبي دفتر الصكوك أن يقوم بتوقيع الصكّ، لكنّ الأثر وصرف الصكّ إنّما يحصل إذا قام الآخر بالتوقيع عليه أيضاً.
والحال عينه في تحقّق ظهور وليّ العصر (عجل الله تعالى فرجه)، فحينما نتحدّث عن الظهور، لا نعني بذلك أنّ لنا إرادة مستقلّة بحيث لو تحقّقت الشروط كان لا بدّ لله تعالى من أن يأذن بالظهور، بل المراد أنّ الله تعالى قضى أن يكون تعلّق إرادة الإنسان بتحقيق شروط الظهور مؤثّراً في حصوله، بحيث تكون إرادة الإنسان في طول إرادة الله تعالى، التي من دونها ومن دون إذنه تعالى ومشيئته لا يتحقّق الظهور. وثمّة بين الآيات المهدويّة التي ذكرت الشروط الإلهيّة لظهور إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) موارد تشير إلى هذه المسألة، منها الآية التاسعة من سورة «الصفّ» المباركة بحيث يقول تعالى:
﴿هُوَ الَّذِي أَرسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَو كَرِهَ المُشرِكُونَ﴾.
وجاء في الروايات المتواترة أنّ ظهور الإسلام سيكون في زمان ظهور الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)، يقول الإمام عليّ (عليه السلام): «والذي نفسي بيده، لا تبقى قرية ولا مدينة إلّا ونودي فيها بشهادة أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله، صباحاً ومساءً»[21].
إنّ التاريخ الإسلاميّ يثبت تحقّق هذه الآية، إذ على الرغم من أنّ الأعداء لم يتوانوا عن ممارسة الاستهزاء والأذى والتعذيب، والمحاصرة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وفرض الحروب، والتآمر الداخليّ من قبل المنافقين، وبثّ الفرقة بين المسلمين، وشنّ الحروب الصليبيّة، وترويج الفحشاء والمنكر، والاستعمار العسكريّ والسياسيّ؛ كان الإسلام في توسّع يوماً بعد يوم.
تشير الآية السابقة إلى أنّ الإرادة الإلهيّة هي الأصل، فقد صرّحت من خلال عبارة «هو الذي» أنّ أساس تحقّق حاكميّة دين الحقّ متوقّف على إرادة الحقّ تعالى.
وجود قائد عالميّ معصوم
من الشروط الأخرى لظهور الحقّ على العالم وحاكميّته، والتي تتحقّق بيد الله؛ وجود قائد قادر على إدارة العالم على أساس الأوامر الإلهيّة ودين الحقّ. يجدر بالذكر أنّه لا بدّ للناس من قائد، صالح كان أم طالح، وإلّا حلّ الهرج والمرج في المجتمع. يقول
الإمام عليّ (عليه السلام): «لا بدّ للناس من أمير برّ كان أو فاجر»[22]. لذلك، ينبغي أن يكون ثمّة حكم وسلطة لإنفاذ الأوامر الإلهيّة وحفظ الأحكام، والسلطة والحكم يحتاجان إلى إمام وقائد لائق.
إمّا أن يكون الدين والمذهب منسجمين مع الحاجات الداخليّة والمستجّدات الخارجيّة، متحرّكين ومتكيّفين مع متطلبات الزمن، وإمّا أن يشتملا على قوانين مرحليّة جامدة وجافّة يطويها مرور الزمن، فإن كان للمذهب إمام ذو صفات خاصّة، كان من النوع الأوّل، وإلّا كان من الثاني. من هنا، يقول الإمام الرضا (عليه السلام):
«إنّ الإمامة زمام الدين، ونظام المسلمين، وصلاح الدنيا، وعزّ المؤمنين»[23].
إنّ الإمامة هي فقط التي يمكنها توفير الاحتياجات الفرديّة والاجتماعيّة والماديّة والمعنويّة لقافلة البشريّة، تماماً كما تحتاج السباحة في حوض السباحة إلى مدرّب ومنجٍ، وكما يحتاج قطع البحار إلى سفينة وربّان.
في الخلاصة: كلّ حركة ماديّة أو معنويّة تحتاج إلى أمور عدّة: الجادّة والطريق، والوسيلة، والهدف والمقصد، وأخيراً القائد والدليل، والدليل هو الأهمّ من بينها، لأنّه بغياب الدليل نضلّ عن الطريق ونحيد عن الهدف، وتمضي الوسيلة بنا على غير جهة. إنّ الإمام هو دليل المجتمع في حركته نحو الله [تعالى]. وإذا كان الأمر كذلك، فلا بدّ للإمام والقائد: أوّلاً، من أن يكون عالماً وعارفاً
بجميع القوانين الإلهيّة والمقاصد والسنن الإلهيّة. ثانياً، أن يكون عادلاً لا يميل به الهوى ولا يخضع للميول النفسيّة، كي يتمكّن من إنفاذ الأحكام الإلهيّة.
والسؤال الذي يُطرح هنا هو: كيف يمكن معرفة مثل هذا الشخص وتنصيبه حاكماً على الدولة؟
إنّ الطريق الأفضل لتعيين القائد والمسؤول في مجتمعات اليوم هو الانتخابات، ولا شكّ في أنّ الانتخابات تشكّل حلّاً، لكنّها لا تمثّل دائماً طريق الحقّ. ليس ثمّة من حجّة ودليل علميّ أو عقليّ يثبت أهليّة الشخص المنتخب وصلاحيّته وحقّانيّته، على رغم أنّه من الناحية العمليّة يمثّل رأي الأكثريّة وأفضل الحلول؛ يضاف إلى ذلك أنّ الأخذ برأي الأكثريّة إنّما يكون في المسائل الاجتماعيّة. أمّا في المسائل العقديّة، فما من قيمة لرأي الأكثريّة، وإلّا لكان على الأنبياء (عليهم السلام)أن يتخلّوا عن دعوتهم ويتّبعوا رأي الأكثريّة الذين كانوا من الكفّار أو المشركين. جاء في سورة الأنعام:
﴿وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ﴾ (الأنعام: 115).
إذاً، ليس لرأي الناس وانتخابهم دور في مسألة الإمامة الخطيرة جدّاً والحسّاسة، والتي هي من الأمور الاعتقاديّة، وتعيين الإمام إنّما هو بيد الله [تعالى]. طبعاً، تشكّل بيعة الناس للإمام الأرضيّة لإعمال حاكميّته، لكنّه لا يكون إماماً برأي الناس، ولا تنتهي إمامته بإعراضهم عنه.
حقيقة كيف يمكن للإنسان المحدود الذي لا يطّلع على الغيب، ولا علم له بمستقبل الناس وباطنهم أن يكون له رأي صائب مئة في المئة حول إنسان ما؟!
ألا تتغيّر دوافع الإنسان وحالاته وسلوكه تبعاً لاختلاف الأوضاع والظروف؟ فكيف يمكن له من خلال بعض المعلومات السطحيّة والظاهريّة أن يحدّد مصير قيادة الأمّة من خلال الانتخابات؟ نعم، يمكن أن تشكّل الانتخابات حلّاً، لكنّها ليست الطريقة الحقّة دائماً.
لذا، لمّا بات معلوماً أنّ مسألة الإمامة من أهمّ المسائل العقديّة وسبب لهداية ورشد المجتمع، وأنّه لا غنىً للمجتمع عن القائد لأنّ سقوط المجتمع وتقدّمه مرتبطان بقيادة هذا المجتمع؛ يصبح من اللازم أن يكون تعيين الإمام حصراً بيد الله [تعالى]، لأنّه لا بدّ من أن تتوفّر في الإمام شروط وخصائص لا يمكن أن يطّلع عليها إلّا الله تعالى، ومن جملتها:
1- معرفة الإمام بجميع القوانين الحاكمة على الإنسان والكون.
2- معرفة الإمام بالنتيجة الحتميّة للطريق الذي يختاره ويمضي به.
3- لا ينبغي للإمام في قيادته للمجتمع أن يلحظ منافعه الشخصيّة، أو أن تحرّكه العوامل الباطنيّة أو الخارجيّة.
4- لا بدّ للإمام من أن يتحلّى بالحدّ الأعلى من أسمى الصفات الإنسانيّة الحسنة، ونحن بغنى عن القول إنّ هذه الشروط لا نجدها بين الأشخاص العاديّين، كما أنّ الناس لا علم لهم بتوفّر هذه الشروط فيهم من عدمها.
من هنا، كانت الطريقة الحقّة في تعيين الإمام هي الطريقة نفسها في تعيين النبيّ، لأنّنا نرى أنّ الإمامة كالنبوّة، والإمام كالنبيّ والدليل على الحاجة للإمام هو نفسه الدليل على الحاجة للنبيّ، وعمل الإمام كعمل الأنبياء، أي هداية الناس والعمل على تكاملهم وإرشادهم إلى طريق سعادتهم. فإذا سلّمنا بأنّ الإمامة بالتنصيب لا بالانتخاب، لم يكن للناس اختيار في مقابل التنصيب الإلهيّ.
ومن جهة ثانية، لمّا كان سائر الناس في كلّ زمان يحتاجون إلى مثل هذا الشخص، كان ينبغي وجود شخص فيه هذه الخصوصيّات في كلّ زمان تتحقّق فيه الشروط والمقدّمات العائدة إلى الناس، وهذا الشخص في زماننا هو الإمام الحجّة بن الحسن (عجل الله تعالى فرجه)، والذي ينتظر بدوره الفرج وتشكيل حكومة العدل العالميّة.
بناءً على الأدلّة القرآنيّة والروائيّة والتاريخيّة، جاء إلى هذه الدنيا أحد عشر إماماً استشهدوا جميعاً، لكنّ الله تعالى شاء أن يغيّب الإمام الثاني عشر بعد ولادته عن الأنظار حتّى تقتضي المصلحة ويأتي أمر الله تعالى فيُظهره ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً.
2. امتلاك برنامج وقوانين جامعة للعالم
الشرط الآخر من شروط تشكيل حكومة العدل العالميّ، والذي يشكّل الأرضيّة لرشد الإنسان وتعاليه؛ هو وجود برنامج وقوانين جامعة وكاملة تضمن سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وهو ما عبّرت عنه الآيات القرآنيّة المرتبطة بحكومة إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) بـ ﴿وَدِينِ ٱلۡحَقِّ﴾ (التوبة: 33).
فمن هو الشخص أو الأشخاص الذين يمكنههم كتابة هذا البرنامج الجامع؟ وهل يمكن ذلك عن طريق العلم والعقل فقط؟
في ما يأتي الأسباب التي تحول دون الاكتفاء بالعلم والعقل البشريّين، ودون استغنائنا عن الرسل وتعاليم الوحي التي أتوا بها:
أ. محدوديّة علم الإنسان
نحن نشهد كلّ يوم زيادة في عدد الكليّات التخصّصيّة، وظهور اختراعات واكتشافات جديدة، إلّا أنّ الإنسان إن ترك علمه وعقله يصيّرانه في الحقيقة كمن يمضي في أرض وعرة حيران مضطرباً، ففهم الناس وعلمهم وفكرهم متفاوت؛ بل إنّ أكثر النزاعات والاختلافات الحادّة والخطيرة يكون مصدرها العقلاء والعلماء! العلم والعقل منشأ كلّ هذه النزاعات، وكيف للنزاعات والاختلافات أن تنتهي؟ فما يراه زيد خيراً قد لا يراه عمرو كذلك.
ب. الموانع العديدة للمعرفة
من المسائل التي تُبحث في موضوع المعرفة؛ موانع المعرفة، إنّما يعرف الإنسان الحقّ ما لم يحل مانع دون ذلك. إنّ طغيان الغرائز في الإنسان قد يفقده القدرة على معرفة الواقع على الرغم من امتلاكه العقل والفكر والقدرة على التعلّم.
مع الأسف، إنّ الألوان المتنوّعة للنظّارات التي يضعونها أمام أعيننا تسلبنا القدرة على التشخيص الصحيح! كم من باطل نراه
حقّاً؟ وكم من حقّ نراه باطلاً؟ كم من عدوّ لنا نحبّه؟ وكم من صديق نعدّه في الأعداء؟ لمّا كان الإنسان محكوماً للغرائز، ولا يرى الحقائق على ما هي عليه دائماً، ويكون عمله أحياناً على خلاف ما تقتضيه المعرفة الصحيحة؛ لم يكن لديه حقّ التقنين. يقول القرآن الكريم:﴿إِنِ الحُكمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (الأنعام: 57).
ج. عدم إدراك المسائل في أوانها
أحياناً، يساهم مرور الزمن وتقدّم العلم في إدراك الإنسان للواقع، فعلى عاتق من نضع مسؤوليّة مئات السنين من التأخير؟ ثمّة العشرات من التعاليم الإسلاميّة التي كشف أسرارها مرور الزمن وتقدّم العلم، في حين عمل بها أتباع الأنبياء منذ البداية بينما أدركها العلماء الذين يتّكلون على العلم والتجربة بعد قرون من الزمن.
د. إدراك الأمور المعنويّة
إنّ سير الإنسان وحده واختياره الطريق الصحيح اعتماداً على العقل والعلم والتشاور إنّما هو ممكن في المسائل المحسوسة والماديّة، أمّا في معرفة السعادة الأبديّة والتكامل المعنويّ وتزكية الروح فيده قاصرة، وليس له من سبيل إلى ذلك سوى مدرسة الوحي وطريق الأنبياء، وهذه نماذج من القوانين التي يمكن أن يسنّها الإنسان لنفسه:
- قوانين الاستبداد الفرديّ التي تصدر وفق إرادة شخص مستبدّ، والتي يشوبها الضعف، والنقص، والفرض، والقلق الشديد، وقصر النظر و....
- قوانين الاستبداد الطبقيّ التي تضعها طبقة بعينها، ولا يخفى أنّ هذا النحو من القوانين إنّما يؤمّن مصلحة طبقة معيّنة وفئة خاصّة من الناس، وتكون خاضعة لتأثير تلك الطبقة.
- القوانين الشعبيّة التي تقوم على آراء الناس؛ سواء كانت هذه القوانين قرينة المصلحة والصحّة أم لا. إنّ العالم اليوم يعدّ هذا النوع الثالث أرقى القوانين، في حين أنّه ليس بين القوانين البشريّة ما هو جامع مانع يلحظ جميع الأبعاد الفرديّة والاجتماعيّة في حياة الإنسان. فكيف لواضعي القوانين اعتماداً على علمهم وعقلهم أن يقفوا على جميع أبعاد الإنسان ويعلموا جميع احتياجاته؟ هل كانوا واقعاً يبحثون في تقنينهم عن خير بني البشر؟ كيف يمكن لنا أن نركن إلى عدم وقوعهم في الخطأ؟ لعلّهم لحظوا مصلحة فرد أو جماعة خاصّة، فلعلّهم تبعاً لمحيطهم ونظامهم العائليّ أو القبليّ أو الاقتصاديّ حادوا عن المسار الصحيح، وأثّرت الضغوطات والمحيط في القوانين التي يصدرونها، من أين يُعلم أنّهم لم يخضعوا لتأثير الغرائز الشيطانيّة والطاغوتيّة؟ كيف لنا أن نطمئنّ إلى أنّ هذه القوانين لن تعود عاجلاً أم آجلاً بالضرر على الفرد أو المجتمع؟
خصائص المقنّن
بلحاظ ما تقدّم، نخلص إلى أنّ المشرّع لحياة البشر لا بدّ من أن تتوفّر فيه الشروط والخصائص الآتية:
1. العلم والإحاطة التامّة بجميع الاحتياجات الظاهريّة والباطنيّة للإنسان.
2. الشفقة والرحمة البالغة للإنسان.
3. العدالة التامّة وعدم ترجيح الهوى على المصلحة والواقع.
ومن الواضح أنّه ما من مشرّع تنطبق عليه هذه الصفات سوى الله تعالى، الذي يبلّغ تعاليمه وهديه وشرائعه للإنسان عن طريق الأنبياء الذين يقومون بتلقّي الوحي الإلهيّ وإبلاغه للناس.
ومن بين الأنبياء كان النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله) خاتم الأنبياء، وكان كتابه أي القرآن؛ الوصفة الإلهيّة الأخيرة والخالدة للبشريّة، والتي تشكّل المعيار والأساس الذي ستقوم عليه الحكومة المهدويّة في عصر الظهور.
جاء في الخطبة 138 من نهج البلاغة، التي أشار أمير المؤمنين (عليه السلام) فيها إلى حكومة الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) أنّه (عليه السلام): «يعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي».
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ تعليم القرآن لعموم الناس في عصر ظهور إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) يحظى بأهمّيّة بالغة، يقول أمير المؤمنين(عليه السلام):
«إذا قام قائم آل محمّد ضرب فساطيط لمن يعلِّم الناس القرآن على ما أنزل الله جلّ جلاله»[24].
الإمام الموعود والقرآن لا يفترقان أبداً، ففي خطبة يوم الغدير المعروفة، وبعد أن بيّن رسول الله (صلى الله عليه وآله) للناس أنّ الوصيّ من بعده أمير المؤمنين وأبناؤه المعصومون (عليهم السلام)؛ ذكر أنّهم (عليهم السلام)–
ومن جملتهم الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)– والقرآن معاً لا يفترقان، فقال (صلى الله عليه وآله):
«عليّ أخي ووزيري ووارثي ووصيّي وخليفتي في أمّتي ووليّ كلّ مؤمن بعدي، ثمّ ابني الحسن، ثمّ ابني الحسين، ثمّ تسعة من ولد الحسين واحد بعد واحد، القرآن معهم وهم مع القرآن لا يفارقونه ولا يفارقهم حتّى يردوا عليّ الحوض»[25].
وعن الإمام الباقر (عليه السلام): «إِنَّ اَلْعِلْمَ بِكِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَيَنْبُتُ فِي قَلْبِ مَهْدِيِّنَا كَمَا يَنْبُتُ اَلزَّرْعُ فِي أَحْسَنِ نَبَاتِهِ»[26].
إنّ السبب في هذا الاهتمام البالغ بالقرآن الكريم يعود إلى أنّ:
- القرآن كتاب هداية: ﴿ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدى لِّلۡمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: 2).
- القرآن شفاء ومداو للأسقام: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنَ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحمَة لِّلمُؤمِنِينَ﴾ (الإسراء: 82).
- القرآن كتاب بشارة وإنذار: ﴿لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشرَى لِلمُحسِنِينَ﴾ (الأحقاف: 12).
- القرآن كتاب المحبّة للمحسنين: ﴿إِنَّ الله يُحِبُّ المُحسِنِينَ﴾ (البقرة: 195).
- القرآن كتاب الدعوة إلى المحاسن: ﴿وَبِالوَالِدَينِ إِحسَانا.. وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسنا﴾ (البقرة: 83).
- القرآن كتاب التعقّل والتفكّر: ﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾ (يوسف: 2).
- القرآن كتاب الدعوة إلى العمل: ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ﴾ (سورة الصفّ: 2).
- القرآن كتاب الجهاد والقتال: ﴿إِنَّ الله يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ﴾ (الصف:4).
لقد بيّن هذا الكتاب علاقة الإنسان بالله (العبادات)، وعلاقة الإنسان بالناس (التعليم، والتعلّم، والعفو، والإنفاق، والإيثار، والتعاون، و...)، وعلاقة الإنسان بالطبيعة (التسخير والإعمار، والإحياء، والابتعاد عن الإسراف والتبذير في ما ننال منها).
وبيّن علاقة الإنسان بالمخالفين والمنافقين وأمر بدعوتهم إلى الحقّ بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ودعا إلى مواجهة المفسدين الذين هم كالشوك في الطريق يحولون بين عموم الناس واتّباع الحقّ، وإلى مواجهة الطغاة في المجتمع.
- القرآن كتاب سياسة وحكم: ﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ﴾ (النساء: 105). إنّ لازم كلام من يقول بفصل الدين عن السياسة حذف بعض آيات القرآن!
- القرآن ميزان وملاك ومعيار ومقياس، لقد دعانا [أهل البيت (عليهم السلام)] لاتّخاذ القرآن معياراً، وأن نعرض الروايات التي نقرؤها أو نسمعها على القرآن فنأخذ ما يوافقه ونضرب ما سواه
بعرض الحائط: «فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه»[27].
ليس الأحاديث فقط، بل لا بدّ من عرض سائر أنواع القول والكتابة، يجب عرض كلّ القيم على القرآن.
إنّ القوانين الجامعة التي تشكّل أحد شروط الظهور وتشكيل الحكومة العالميّة، والتي ينبغي أن يجعلها الله ربّ العالمين للبشريّة، هي حاضرة وموجودة.
3. الإمداد الإلهيّ والغيبيّ
إحدى المقدّمات والشروط الأخرى لتحقّق الظهور وانتصار الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)، نزول العون الإلهيّ والمدد الغيبيّ، فمن دون عون الله وعنايته الخاصّة، لا يمكن تحقيق النصر في هذا الميدان الواسع الذي يملك فيه الأعداء كلّ أنواع المكر والتضليل، وهذا الحشد الكبير للقوى من أجل مواجهة الإمام (عجل الله تعالى فرجه) وإلحاق الهزيمة به. لذا، ذكرت العديد من الروايات المهدويّة التي تناولت أحداث الظهور مسألة نزول المدد الإلهيّ بشكل صريح وواضح.
روي عن الإمام الباقر (عليه السلام) قوله: «الملائكة الذين نصروا محمّداً (صلى الله عليه وآله) في يوم بدر، هم في الأرض لم يصعدوا إلى السماء بعد، ولن يصعدوا حتّى ينصروا صاحب هذا الأمر، وهم خمسة آلاف»[28].
وقد بيّنت الأحاديث الأخرى أنّ هذا المدد ينزل بصور مختلفة، كالإلهام الإلهيّ لقلوب المؤمنين، وبثّ الرعب والخوف في قلوب الأعداء، وسكينة القلب في أوج المصيبة والمصاعب و.... ذلك ما جعل إحدى خصائص قائم آل محمّد (عجل الله تعالى فرجه) أنّه «منصور بالرعب». يقول الإمام الباقر (عليه السلام):
«القائم منّا منصور بالرعب، مؤيّد بالنصر، تطوى له الأرض، وتَظهر له الكنوز»[29].
طبعاً، إنّ نزول هذا المدد الغيبيّ لا يكون على خلاف الحكمة وكيفما اتّفق، بل هو متوقّف على تحقّق شروط ومقدّمات ذكرنا أهمّها آنفاً.
ثانياً: المقدّمة الإنسانيّة للظهور
مرّ سابقاً القول إنّ ظهور إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه)، وتبعاً لنظام العلّة والمعلول القائم في الوجود؛ لا يمكن أن يتحقّق ما لم تتحقّق الشروط والمقدمات التي يتوقّف عليها، وبعضها إلهيّ وبعضها إنسانيّ. وقد تحدّثنا في القسم السابق عن الشروط الإلهيّة للظهور، ونتناول هنا الشروط والمقدّمات الإنسانيّة للظهور. ولا بدّ أن نعلم من أنّ الشروط الإنسانيّة تنقسم بدورها إلى قسمين: بعضها يرتبط بالقادة الذين يعملون تحت إمرة الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)، وبعضها يرتبط بعموم الناس.
تهيئة الشروط الإنسانيّة للظهور
إنّ التأمّل في الروايات التي تتحدّث عن الامتحانات والابتلاءات التي تقع في عصر الغيبة يفضي إلى أنّ أحد أسباب هذه الامتحانات الصعبة في عصر الغيبة وحتّى في عصر الظهور هو تهيئة المقدّمات والشروط الإنسانيّة لتشكيل الحكومة المهدويّة بشقّيها: تلك المرتبطة بالعاملين تحت إمرة الإمام (عجل الله تعالى فرجه)، وتلك المرتبطة بعموم الناس، وهي امتحانات لا یمکن تجنّبها.
أمّا العلّة التي تجعل من هذه الامتحانات ضروريّة في زمن غيبة إمام العصر (عجل الله تعالى فرجه) فيمكن أن نقف عليها من معرفة الأهداف التي ذكرها القرآن الكريم للامتحان، وهذه الأهداف هي:
أ- إطلاق العنان للقدرات الكامنة في الإنسان:
﴿وَلِيَبتَلِيَ الله مَا فِي صُدُورِكُم وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُم﴾ (آل عمران: 154).
ب- تمييز الخبيث من الطيّب في الناس:
﴿مَّا كَانَ الله لِيَذَرَ المُؤمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُم عَلَيهِ حَتَّى يَمِيزَ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ (آل عمران: 17).
ج- تمييز صفوف المجاهدين والصابرين عن غيرهم:
﴿وَلَنَبۡلُوَنَّكُمۡ حَتَّىٰ نَعۡلَمَ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰبِرِينَ﴾ (محمد: 31).
د- الإيقاظ من الغفلة:
ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ﴿فَأَخَذنَاهُم بِالبَأسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُم يَتَضَرَّعُونَ﴾ (الأنعام: 42).
وتوضيحه أنّه من المسلّم في القيام المهدويّ أنّ الصالحين هم اللائقون بالالتحاق بركاب قائم آل محمّد (عجل الله تعالى فرجه)، وأنّ الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) سيختار صفوة أنصاره على أساس اللياقة التي يتحلّون بها؛ أمّا أوّلاً فمن أجل تحقيق الانتصار على جميع القوى العالميّة، وثانياً لأنّه لا سبيل آخر لإقامة حكومة العدل في العالم؛ من هنا، يقول الإمام الصادق (عليه السلام): «إنّ أصحاب موسى ابتلوا بنهر،[...] وإنّ أصحاب القائم يبتلون بمثل ذلك»[30]
وعلّة ذلك أنّه لا بدّ لكلّ قائد من تمييز قواه المنتجة من تلك غير المنتجة، حتّى يمكنه إخراج تلك القوى الضعيفة من المجموعة، التي سيؤدّي بقاؤها إلى حصول الضعف في سائر العناصر الأخرى. لذلك، يجب تنصيب الأشخاص في موقع معيّن أو رتبة معيّنة من الامتحان والانتخاب، كما امتحن الله [تعالى] إبراهيم (عليه السلام) قبل أن يجعله إماماً.
كذلك من الناحية التربويّة والاستعداد لدى عموم الناس، فإنّ لنزول البلاء والمصائب تأثيراً كبيراً، فالابتلاءات تذكّر بالله، وتحول دون غفلة الإنسان، وتبعث على التوبة والتوجّه بالدعاء لله تعالى والخضوع لإرادته وأوامره، والذي يمثّل تشكيل حكومة الحقّ على يد وليّ الله أهمّ تلك الأوامر.
جاء في القرآن الكريم:
﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِي قَرۡيَة مِّن نَّبِيٍّ إِلَّآ أَخَذۡنَآ أَهۡلَهَا بِٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمۡ يَضَّرَّعُونَ﴾ (الأعراف: 94).
يتّضح من خلال هذه الآية: أوّلاً، أنّ الصعوبات والمشكلات تشكّل سبيلاً لإيقاظ الفطرة والتوجّه نحو الله [تعالى]: ﴿لَعَلَّهُمۡ يَضَّرَّعُونَ﴾؛ ثانياً، أنّ الصعوبات والمرارات لا تشكّل دوماً غضباً إلهيّاً، أحياناً تكون لطفاً تجلّى على شكل بلاء:﴿لَعَلَّهُمۡ يَضَّرَّعُونَ﴾. فكما أنّ تذويب الحديد في حفرة النار يصيّره ليّناً ليأخذ الشكل المطلوب؛ كذلك الحوادث والشدائد التي يتعرّض لها الإنسان تجعله ليّناً وتدفعه إلى التضرّع والاستكانة، وتدفع الناس إلى رفع أيديهم بالدعاء وطلب تعجيل ظهور المنجّي بصدق؛ فيصبحون عندها محلّاً لرحمة الله، وتجلّي تلك الرحمة بالأمر بظهور إمام الرحمة والعدل. كما يقول الإمام علي(عليه السلام): «وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ حِينَ تَنْزِلُ بِهِمُ النِّقَمُ، وَتَزُولُ عَنْهُمُ النِّعَمُ، فَزِعُوا إِلَى رَبِّهِمْ بِصِدْقٍ مِنْ نِيَّاتِهمْ، وَوَلَهٍ مِنْ قُلُوبِهمْ، لَرَدَّ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَارِدٍ، وَأَصْلَحَ لَـهُمْ كُلَّ فَاسِدٍ»[31]
ثالثاً: الشروط الخاصّة بالخواصّ والعوامّ
وعليه، يمكن بحث الشروط والمقدّمات الإنسانيّة للظهور من جهتين: الخواصّ والعوام:
1. الشروط الخاصّة بالقادة
إنّ نهضة الإمام (عجل الله تعالى فرجه) كسائر النهضات الأخرى تحتاج إلى الصفوة من الأنصار الأكفّاء الذين يمتثلون أوامره حتّى تشكيل الحكومة العالميّة بأبعادها المختلفة؛ من هنا، وكما قدّمنا الذكر: إنّ
الاعتقاد بأنّ الإمام (عجل الله تعالى فرجه) سيفتح العالم وينشر حكم الدين والعدل في العالم بأسره من خلال الكرامات والإمدادات الغيبية فقط، ومن دون الاستفادة من المقدّمات الإنسانيّة؛ خلاف العقل والآيات والروايات. فمثل الإمام وليّ العصر (عجل الله تعالى فرجه) مثل النبيّ الأعظم (صلى الله عليه وآله) الذي استعان في سبيل تحقيق أهدافه المقدّسة بكلا العاملين الماديّ والغيبيّ، قال تعالى:﴿هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصرِهِ وَبِالمُؤمِنِينَ﴾ (الأنفال: 62).
إنّ تأييد الناس للقائد لا ينسجم مع الإرادة الإلهيّة فحسب؛ بل إنّ الناس وفق هذه الآية هم عضد القائد والمدافعون عنه. ولهذا، صرّحت الروايات المرتبطة بأحداث الظهور بحضور المؤمنين الأكفّاء إلى جانب المدد الإلهيّ، فذكرت أنّ الله يؤيّد الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) «بثلاثة أجناد: الملائكة، والمؤمنين، وبثّ الرعب في قلوب الأعداء»[32].
يبدو أنّ هذا القول في سياق واحد مع المفاد القرآنيّ الذي يقول إنّ الإمدادات الإلهيّة شاملة للبعدين الظاهريّ والغيبيّ:
﴿...فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوۡلَىٰهُ وَجِبۡرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ﴾ (التحريم: 4).
ومن اللازم هنا الإشارة إلى هذه النقطة، وهي أنّ قادة جيش الإمام (عجل الله تعالى فرجه) لا ينحصر عددهم بـ 313 شخصاً، لأنّ الروايات تشير إلى لزوم اجتماع عدد أكبر حتّى يخرج الإمام (عجل الله تعالى فرجه).
يقول أبو بصير:
سأل رجل من أهل الكوفة الإمام الصادق (عليه السلام): كم يخرج مع القائم؟ فقال (عليه السلام): «وَما يَخْرُجُ إِلَّا في أُولِي قُوَّةٍ، وَما تَكونُ أُولُو الْقُوَّةِ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ»[33].
إنّ جميع من عُدّوا في أصحاب الإمام (عجل الله تعالى فرجه)؛ لا بدّ من أن يكونوا ذوي قدرة، وبتعبير الرواية: «أولو قوّة». وبطبيعة الحال، سيوكل بالمسؤوليّات الأهمّ إلى الأكثر قوّة منهم، وقد عبّر القرآن الكريم عن هؤلاء بـ: ﴿يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوۡمَةَ لَآئِمۚ﴾ (المائدة: 54).
وفي تفسيره لهذه الآية الشريفة، قال الإمام الصادق (عليه السلام):
«إِنَّ صَاحِبَ هَذَا اَلْأَمْرِ مَحْفُوظَةٌ لَهُ أَصْحَابُهُ لَوْ ذَهَبَ اَلنَّاسُ جَمِيعاً أَتَى اَللَّهُ لَهُ بِأَصْحَابِهِ»، وهم الذين قال الله عزّ وجلّ فيهم: ﴿فَإِن يَكۡفُرۡ بِهَا هَٰٓؤُلَآءِ فَقَدۡ وَكَّلۡنَا بِهَا قَوۡما لَّيۡسُواْ بِهَا بِكَٰفِرِينَ ٨٩﴾ (الأنعام: 89)، و ﴿فَسَوفَ يَأتِي الله بِقَوم يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى المُؤمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرِينَ﴾.
ينبغي أن يُعلم أنّ مفتاح فلاح المجتمع هو بوجود أفراد لائقين على رأسه يحكمون بالعدل، فيما منشأ المشكلات والمصائب في المجتمع هو وصول غيرالجديرين إلى مسند الرئاسة والقيادة؛ من هنا، كانت مراعاة مبدأ اختيار الأكفّاء ضروريّة حتّى على مستوى المرؤوسين، والله تعالى ﴿هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ (الأعراف: 196).
وإليك أهمّ الصفات اللائقة بخواصّ وأصحاب إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) والتي تبعث على افتخار أتباعه قادة وجنوداً:
1.1. الإيمان المستحكم
إنّ الإيمان بالله تعالى، الذي لا يشوبه شكّ، يشكّل إحدى الصفات البارزة في أنصار المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)، بل هو من أهمّ تلك الصفات، قال الإمام الصادق (عليه السلام) في أوصاف أصحاب إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه):
«رِجَالٌ كَأَنَّ قُلُوبَهُمْ زُبَرُ الْحَدِيدِ، لَا يَشُوبُهَا شَكٌّ فِي ذَاتِ اللَّهِ، أَشَدُّ مِنَ الْحَجَرِ»[34].
وكأنّهم المصداق الأبرز لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا إِذَا لَقِيتُم فِئَة فَاثبُتُواْ﴾ (الأنفال: 45). وهذا الثبات في إيمانهم إنّما هو نتاج معرفتهم العالية بالحقّ تعالى. كما أنّ الأعمال الصالحة التي ذكرت روايات المعصومين (عليهم السلام)تساهم في تثبيت الإيمان في قلوبهم.
2.1. العبادة والمناجاة
أن يصل الإنسان إلى مقام العبوديّة لله؛ فذاك لا يحصل دفعة واحدة، بل يحتاج إلى المداومة والخضوع في محضره تعالى. وهذه هي فلسفة العبادة ليس إلّا؛ أن يتعلّم الإنسان التذكّر والمداومة على الخضوع والخشوع لربّ العالمين؛ حتّى يصبح مسلّماً لإرادته تعالى في سائر شؤون حياته، وكلّما كان الامتحان
أصعب برزت أهمّيّة العبادة أكثر. لذا، كانت العبادة والدعاء والمناجاة مع المعبود تعالى؛ صفة أخرى من صفات أصحاب الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)، كما جاء في وصفهم:
«رِجَالٌ لَا يَنَامُونَ اللَّيْلَ، لَهُمْ دَوِيٌّ فِي صَلَاتِهِمْ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، يَبِيتُونَ قِيَاماً عَلَى أَطْرَافِهِمْ، وَيُصْبِحُونَ عَلَى خُيُولِهِمْ، رُهْبَانٌ بِاللَّيْلِ، لُيُوثٌ بِالنَّهَار»[35].
3.1. معرفة الإمام (عجل الله تعالى فرجه)
لا يوجد رأس مال لأصحاب إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) بعد معرفة الله تعالى؛ أهمّ من المعرفة الراسخة بالإمام، هذه المعرفة التي تجعلهم يهيمون به (عجل الله تعالى فرجه) وتصيّرهم طوع أمره. ولا ريب أنّ مثل هذه المعرفة لا تتيسّر بسهولة؛ بل هي معرفة تتراكم في زمن الغيبة حال انتظارهم لظهور الإمام (عجل الله تعالى فرجه). وهذا ما يتّضح جيّداً في كلام الإمام السجّاد (عليه السلام) بحيث يقول:
«إِنَّ أَهْلَ زَمَانِ غَيْبَتِهِ، الْقَائِلِينَ بِإِمَامَتِهِ، وَالْمُنْتَظِرِينَ لِظُهُورِهِ، أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِ كُلِّ زَمَانٍ، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْطَاهُمْ مِنْ العُقُولُ وَالأَفْهَامُ وَالمَعْرِفَةُ مَا صَارَتْ بِهِ الغَيْبَةُ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ المُشَاهَدَةِ»[36].
من هنا، جرى التأكيد على قراءة دعاء «المعرفة» في عصر الغيبة:
«اَللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ.
اَللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ. اَللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي»[37].
جاء في الرواية أيضاً:
«لو أنّ رَجُلًا قامَ لَيْلَهُ، وصامَ نَهارَهُ، وتَصَدَّقَ بِجَميعِ مالِهِ، وحَجَّ جَميعَ دَهْرِهِ، ولَمْ يَعْرِفْ وِلايَةَ وَلِيِّ اللهِ فَيُواليهِ، ويَكونَ جَميعُ أَعْمالِهِ بِدَلالَتِهِ إِلَيْهِ، ما كانَ لَهُ عَلَى اللهِ حَقٌّ في ثَوابِهِ، ولا كانَ مِنْ أَهْلِ الإيمانِ»[38].
4.1. التولّي وطاعة الإمام (عجل الله تعالى فرجه)
إذا أردنا ذكر أبرز الخصائص العمليّة التي تمنحنا التوفيق للانضمام إلى جيش إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه)؛ يمكن القول بثقة إنّ الطاعة المطلقة له وموالاته هما من أهمّ تلك الخصائص. وقد جاء هذا المعنى في وصف أنصار الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه): «طاعتُهُم للإمامِ تُفوقُ طاعةَ الأُمَّةِ لِسيِّدِها»[39]. وقد قال جابر بن يزيد الجعفيّ: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاريّ يقول: أنزل الله تعالى على نبيّه هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمرِ مِنكُم﴾ (النساء: 51)، قلت يا رسول اللّه! عرفنا الله ورسوله، فمن هم أولو الأمر الذين قرن طاعتهم بطاعته؟ فقال:
«هُم خُلَفائي يا جابر، وأَئِمَّةُ المُسلِمينَ مِن بَعدي: أَوَّلُهُم عَلِيُّ بنُ أَبي طالِب، ثُمَّ الحَسَنُ والحُسَين، ثُمَّ عَلِيُّ بنُ الحُسَين، ثُمَّ مُحَمَّدُ
بنُ عَلِيٍّ المعروفُ في التَّوراةِ بِالباقِر، وستُدرِكُهُ يا جابر، فإذا لَقِيتَهُ فأَقرِئْهُ مِنِّي السَّلام. ثُمَّ الصّادِقُ جَعفَرُ بنُ مُحَمَّد، ثُمَّ مُوسى بنُ جَعفَر، ثُمَّ عَلِيُّ بنُ مُوسى، ثُمَّ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ، ثُمَّ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّد، ثُمَّ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ، ثُمَّ سَمِيِّي وكُنِيِّي حُجَّةُ اللهِ في أَرضِهِ، وبَقيَّتُهُ في عِبادِهِ ابنُ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ. ذاكَ الَّذي يَفتَحُ اللهُ تَعالى ذِكرُهُ على يَدَيهِ مَشارِقَ الأَرضِ ومَغارِبَها، ذاكَ الَّذي يَغيبُ عن شِيعَتِهِ وأَوليائِهِ غَيبَةً لا يَثبُتُ فيها على القَولِ بِإمامَتِهِ إلَّا مَنِ امتَحَنَ اللهُ قَلبَهُ لِلإيمان»[40].
كذلك قال النبيّ الأعظم (صلى الله عليه وآله) في طاعة قائم آل محمّد (عجل الله تعالى فرجه):
«الْقَائِمُ مِنْ وِلْدِي اسْمُهُ اسْمِي، وكُنْيَتُه كُنْيَتِي، وَشَمَائِلُه شَمَائِلي، وَسُنَّتُهُ سُنَّتِي، يُقِيمُ النَّاسَ عَلَى مِلَّتِي وَشَرِيعَتِي، وَيَدْعُوهُمْ إِلَى كِتَابِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ. مَنْ أَطَاعَه فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَاهُ فَقَدْ عَصَانِي، وَمَنْ أَنْكَرَهُ فِي غَيْبَتِهِ فَقَدْ أَنْكَرَنِي، وَمَنْ كَذَّبَهُ فَقَد كَذَّبَنِي، وَمَنْ صَدَّقَهُ فَقَدْ صَدَقَنِي. إلَى اللَّهِ أَشْكُو الْمُكَذِّبِين لِي فِي أَمْرِهِ، وَالْجَاحِدَيْن لِقَوْلَيْ فِي شَأْنِهِ، والْمُضِلِّين لِأُمَّتِي عَنْ طَرِيقَتِهِ»[41].
لقد سمع أتباع الإمام (عجل الله تعالى فرجه) هذه الكلمات النورانيّة بآذان قلوبهم فتعلّقوا بها بقوّة.
5.1. التفاني في خدمة الإمام (عجل الله تعالى فرجه) وطلب الشهادة
واحدة من صفات أصحاب إمام العصر (عجل الله تعالى فرجه)، التي ذكرتها الأحاديث هي:
«يَتَمَسَّحُونَ بِسَرَجِ الإِمَامِ عَجَّلَ اللَّـهُ تَعَالَى فَرَجَهُ الشَّرِيفِ يَطْلُبُونَ
بِذَٰلِكَ البَرَكَةَ، يَحُفُّونَ بِهِ، يَقوُنَهُ بِأَنْفُسِهِمْ فِي الحُرُوبِ وَيَكْفُونَهُ مَا يُرِيدُ فِيهِمْ»[42].
هذا يبيّن أنّ أنصار الإمام (عجل الله تعالى فرجه) يرخصون كلّ شيء حتّى أرواحهم في سبيل الإمام المعصوم، وأنّهم يشاركون في النهضة العالميّة للإمام المنتظر بروح استشهاديّة.
6.1. التقوى والورع
لقد ذكر الإمام الصادق (عليه السلام) صراحة أنّ التقوى شرط أساسيّ لنصرة إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه)، يقول (عليه السلام):
«مَنْ سُرَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْقَائِمِ فَلْيَنْتَظِرْ وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ وَهُوَ مُنْتَظِرٌ، فَإِنْ مَاتَ وَقَامَ الْقَائِمُ بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ أَدْرَكَهُ. فَجِدُّوا وَانْتَظِرُوا»[43].
من هنا، يُعلم أنّه لا يمكن للمرء أن يصبح لائقاً للدخول في زمرة أصحاب إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) ما لم يحرز هذه الخصلة السامية التي أكّد عليها القرآن الكريم مراراً.
7.1. محوريّة الأخلاق
الحياة المرتكزة على الأخلاق الإسلاميّة هي إحدى الصفات المميّزة الأخرى لأصحاب إمام العصر (عجل الله تعالى فرجه) كما ورد في الحديث السابق عن الإمام الصادق (عليه السلام) بقوله: «مَنْ سُرَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْقَائِمِ فَلْيَنْتَظِرْ وَيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ...».
ويتكرّر هذا المعنى في تفسير الإمام الصادق (عليه السلام) للآية المهدويّة: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾ (المائدة: 54).
فقد عدّ (عليه السلام) أصحاب إمام العصر (عجل الله تعالى فرجه) من المصاديق التامّة للآية السابقة إذ قال (عليه السلام):
«هم الذين قال الله فيهم: «فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ...»[44].
لقد أُشير بوضوح إلى صفتين أخلاقيّتين مهمّتين في أتباع أصحاب إمام العصر (عجل الله تعالى فرجه): التواضع أمام المؤمنين والاعتزاز بالنفس.
8.1. نصرة دين الله ونشر أحكامه الإلهيّة
ثمّة سنن إلهيّة عديدة تجري في هذا الوجود، وقد أشار القرآن الكريم إلى بعضها، ومن بين هذه السنن، سنّة النصرة.
يقول القرآن الكريم: ﴿إِن تَنصُرُواْ الله يَنصُركُم وَيُثَبِّت أَقدَامَكُم﴾ (محمد: 7).
من صفات أنصار الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) الحرص على نشر الدين الحقّ وإبلاغه للناس. قال الإمام السجاد (عليه السلام) وهو يذكر صفات المنتظرين لإمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه): «إنَّ أَهْلَ زَمَانِ غَيْبَتِهِ الْقَائِلِينَ بِإِمَامَتِهِ والْمُنْتَظِرِينَ لِظُهُورِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِ كُلِّ زَمَان... أُولَئِكَ الْمُخْلَصُونَ حَقًّاً وشِيعَتُنَا صِدْقاً وَالدُّعَاةُ إِلَى دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سِرًاً وَجَهْراً»[45].
9.1. الكفاءة والتخصّص
قد ينظر بعضهم إلى أنصار الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) على أنّهم أهل المساجد والعبادة فحسب، لكنّهم في الواقع يتمتّعون بالإضافة إلى التديّن بالكفاءة والتخصّص المبنيّ على تعاليم القرآن. سأل [أبو بصير] الإمام الصادق (عليه السلام) عن أصحاب الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) الـ 313: ليس على الأرض يومئذ مؤمن غيرهم؟
قال (عليه السلام): «بَلَى، وَلَكِنْ هَذِهِ اَلَّتِي يُخْرِجُ اَللَّهُ فِيهَا اَلْقَائِمَ، وَهُمُ اَلنُّجَبَاءُ وَاَلْقُضَاةُ وَاَلْحُكَّامُ وَاَلْفُقَهَاءُ فِي اَلدِّينِ»[46].
نخلص من هذه الرواية إلى أنّ مجرد الالتزام، والإيمان، والمحبّة للإمام لا تكفي لتكون في جمع الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه). فإمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) مُكلّف بإدارة العالم بأسره، وهو يحتاج إلى أنصار يتميّزون بالخبرة والكفاءة في مختلف المجالات.
إنّ القيادة والحكم يتطلّبان كفاءات ومؤهّلات خاصّة. يقول القرآن الكريم: ﴿أَنَّ ٱلۡأَرۡضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّٰلِحُونَ﴾ (الأنبياء: 105). وفقاً لهذه الآية الكريمة، وهي من الآيات المهدويّة؛ فإنّ ورثة الأرض يتميّزون بخاصيّتين إحداهما أنّهم عباد لله ومن أهل التقى، والثانية: امتلاكهم الكفاءة والصلاحيّة اللازمتين، أي المؤهّلات والتخصّص والقدرة على الإدارة.
10.1. القوة الجسديّة
كما ذكرنا سابقاً، فإنّ حكومة الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)، تعتمد إلى
جانب التأييد الإلهيّ، على المؤمنين الصالحين وعلى المسارات الطبيعيّة للأمور. من هنا، ومن أجل القيام بالمطلوب، كانت القوّة البدنيّة صفة أخرى من صفات أصحاب إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه)، فإدارة المسؤوليّات الثقيلة الممتدّة على مستوى العالم؛ تتطلّب قوّة بدنيّة. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في صفات القائد، حيث ذكر القوّة البدنيّة إلى جانب العلم: ﴿وَزَادَهُۥ بَسۡطَة فِي ٱلۡعِلۡمِ وَٱلۡجِسۡمِۖ﴾ (البقرة: 247).
وقد جاءت الروايات المهدويّة على ذكر هذه الصفة أيضاً، يقول الإمام السجّاد (عليه السلام):
«إِذَا قَامَ قَائِمُنَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ شِيعَتِنَا الْعَاهَةَ، وَجَعَلَ قُلُوبَهُمْ كَزُبُرِ الْحَدِيدِ، وَجَعَلَ قُوَّةَ الرَّجُلِ مِنْهُمْ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلاً، وَيَكُونُونَ حُكَّامَ الْأَرْضِ وَسَنَامَهَا»[47].
روى أبو بصير أنّ رجلاً من أهل الكوفة سأل الإمام الصادق (عليه السلام): كم يخرج مع القائم (عليه السلام)؟ فإنّهم يقولون إنّه يخرج معه مثل عدّة أهل بدر ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلاً ؟ قال:
«وَمَا يَخْرُجُ إِلَّا فِي أُولِي قُوَّةٍ، وَمَا تَكُونُ أُولُو الْقُوَّةِ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ آلافٍ»[48].
11.1. الصبر والثبات
في أحاديث المعصومين (عليهم السلام)، يُقرَن الصبر دائماً بالنصر. كما
أشار القرآن الكريم مراراً إلى هذا المبدأ كما في قصّة طالوت وجالوت، بحيث يُروى عن أصحاب طالوت أنّهم دعوا الله أثناء المعركة قائلين: ﴿رَبَّنَآ أَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا﴾ (البقرة: 250).
وفي موضع آخر من القرآن الكريم، عُدّت الاستقامة مقدّمة للنصر الإلهيّ، فقال تعالى: ﴿...فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمۡ نَصۡرُنَاۚ﴾ (الأنعام: 34).
بناء على ما تقدّم: إنّ انتصار امام الزمان(عجل الله تعالى فرجه) وإقامة حكومة العدل العالميّ، يحتاجان إلى الصبر والثبات، ولا ريب في أن يكون الصبر من الصفات الضروريّة للعاملين مع الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه). ولا شكّ في أنّ هذا الصبر يُكتسب في ميدان عصر الغيبة، يقول الإمام الحسين (عليه السلام):
«مِنَّا اثْنَا عَشَرَ مَهْدِيّاً، أَوَّلُهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ، وَآخِرُهُمُ التَّاسِعُ مِنْ وُلْدِي، وَهُوَ الْقَائِمُ بِالْحَقِّ، يُحْيِي اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَيُظْهِرُ بِهِ دِينَ الْحَقِّ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. لَهُ غَيْبَةٌ يَرْتَدُّ فِيهَا قَوْمٌ، وَيَثْبُتُ عَلَى الدِّينِ فِيهَا آخَرُونَ، فَيُؤْذَوْنَ وَيُقَالُ لَهُمْ: مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. أَمَا إِنَّ الصَّابِرِينَ فِي غَيْبَتِهِ عَلَى الْأَذَى وَالتَّكْذِيبِ، بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِينَ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ»[49].
12.1. الإخلاص والعمل في سبيل الله
إنّ أنصار الإمام المهديّ المنتظر (عجل الله تعالى فرجه) لم يسيروا في طريق نصرته لتحقيق مصالح شخصيّة، بل كانت دوافعهم الإخلاص
لله والسعي للتقرّب إليه، وهم لايتوانون أبداً عن تقديم كلّ ما يستطيعون في هذا الطريق. وقد شهد الإمام السجّاد (عليه السلام) لهؤلاء بإخلاصهم لله تعالى، فيقول (عليه السلام):
«إِنَّ أَهْلَ زَمَانِ غَيْبَتِهِ الْقَائِلِينَ بِإِمَامَتِهِ وَالْمُنْتَظِرِينَ لِظُهُورِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِ كُلِّ زَمَانٍ... أُولَئِكَ الْمُخْلَصُونَ حَقًّاً وَشِيعَتُنَا صِدْقًاً»[50].
13.1. اجتناب الغرور
أنصار الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) هم خرّيجو مدرسة القرآن، ولا يزال نصب أعينهم قول الله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيۡتَ إِذۡ رَمَيۡتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ﴾ (الأنفال: 17).
من هنا، ما كان يعتريهم الغرور لما حقّقوا من انتصارات، وهم أهل ذلك لا يتوقّع منهم خلافه.
14.1. روح الجهاد
الجهاد ضدّ الظالمين ومحاربتهم سبب من أسباب نزول النصر الإلهيّ وسنّة إلهيّة تكرّر التذكير بها في القرآن الكريم، يقول الله تعالى: ﴿قَاتِلُوهُم يُعَذِّبهُمُ الله بِأَيدِيكُم وَيُخزِهِم وَيَنصُركُم عَلَيهِم﴾ (التوبة: 14).
ويقول أيضاً:
﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهدِيَنَّهُم سُبُلَنَا وَإِنَّ الله لَمَعَ المُحسِنِينَ﴾(العنكبوت: 69).
كلّ هذا التأكيد يجعل من الروحيّة الجهاديّة صفة من صفات أصحاب الإمام في قضيّة الظهور، مثلاً: جاء في هذه الآيات المهدويّة:
﴿... يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى المُؤمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله وَلَا يَخَافُونَ لَومَةَ لَائِم﴾ (المائدة: 54).
وهي تذكر جملة من صفات أنصار الإمام إحداها الجهاد؛ لذا، لا بدّ لكلّ من يتوق للانضمام إلى جيش الإمام (عجل الله تعالى فرجه) من أن يتحلّى بهذه الصفة.
15.1. الإصلاح في المجتمع
أولئك الذين يطمحون إلى مرافقة المصلح العالميّ؛ عليهم أن يحملوا روحيّة الإصلاح في أنفسهم، والتي تتجلّى بشكل واضح في المجتمع من خلال ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنّ الأمر بالمعروف هو علامة حبّ الناس، علامة المسؤوليّة والشفقة، ورغبة الإنسان في صيانة المجتمع، دليل على الفطرة السليمة الحيّة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من الانضباط الاجتماعيّ الذي يقيّد الرغبات والميول الشخصيّة عندما تتعارض مع مصلحة المجتمع، وهو في الواقع وسيلة لضبط الأفراد اللامبالين. إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علامة الرشد.
توجّه لوط (عليه السلام) لقومه المذنبين بالسؤال: ﴿أَلَيسَ مِنكُم رَجُل رَّشِيد﴾ (هود: 78).
نعم، إن راقبنا أنفسنا من الداخل، وراقبنا الناس من الخارج،
وظلّل الجميع نظام سياسيّ وحكوميّ يدعو إلى الخير ويمنع الشرّ؛ نصبح خير الأمم، كما جاء في القرآن الكريم:
﴿كُنتُم خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَت لِلنَّاسِ تَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَتَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ وَتُؤمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (آل عمران: 110).
إنّ على المنتظر الحقيقيّ، التوّاق للظهور، الذي يريد للتوحيد أن يعمّ العالم؛ أن يدرك أنّ إعلاء كلمة التوحيد ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
لا تَزالُ «لا إلهَ إلّا اللّهُ (تَنفَعُ مَن قالَها)، وتَرُدُّ عَنهُمُ العَذابَ والنِّقمَةَ، ما لَم يَستَخِفّوا بِحَقِّها.
قالوا: يا رَسولَ اللّه، وما الاستِخفافُ بِحَقِّها؟ قالَ: يَظهَرُ العَمَلُ بِمَعاصي اللّه، فلا يُنكَرُ، ولا يُغَيَّرُ»[51].
عندما يقول النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله): «مَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ ٱلْمُنْكَرِ فَهُوَ خَلِيفَةُ ٱللَّهِ فِى أَرْضِهِ»[52]، وعندما يقول الإمام عليّ (عليه السلام): «ٱلْأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّهْىِ عَنْ ٱلْمُنْكَرِ خُلُقَانِ مِنْ أَخْلَاقِ ٱللَّهِ، وَمَن يُعِينُ عَلَىٰ هَٰاتَيْنِ ٱلْفَرِيضَتَيْنِ، يُعْطِيهِ ٱللَّهُ ٱلْعِزَّةَ»[53].
يجب على من يحكمون الأرض في ظلّ الولاية المهدويّة ويتسنّمون العزّة بذلك؛ أن يكونوا من العاملين على إصلاح المجتمع، على حدّ سواء في عصر الغيبة أم في عصر الظهور، وذلك عبر القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لذا، كان أحد العهود التي يأخذ إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) البيعة عليها مع بدء نهضته العالميّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث يقول: «أبايعكم على أن... تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر»[54].
2. الشروط الخاصّة بعموم الناس
إلى جانب الشروط الإنسانيّة الخاصّة بأنصار الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) وأتباعه، ثمّة شروط أخرى لازمة تتعلّق بعموم الناس، والجامع المشترك بين كلّ هذه الشروط؛ هو تحقيق الاستعداد العالميّ لقبول حكومة الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) والعدل الذي يأتي به، بحيث يصدح الجميع بصوت واحد، ويدعون الله: «إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ»[55].
نعم، في اللحظة التي يصبح فيها الناس قادرين على قبول إمام وقائد حقّ معصوم، عندها سيظهر إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه).
وهذه بعض الشروط الممهّدة -والتي هي بالطبع أدنى مستوى مقارنة باستعداد أنصار الإمام–:
1.2. الاستعداد الروحيّ
كما أشرنا في بداية هذا القسم، فإنّ أحدى حِكَم الابتلاءات والمحن في عصر الغيبة هي تهيئة الظروف الإنسانيّة اللازمة للظهور. وذكرنا أنّ هذه الابتلاءات والمصاعب تؤدّي إلى إيقاظ الفطرة الإنسانيّة، وتوجّه القلوب نحو خالق هذا الكون، والعودة إليه. وتحقّق ذلك أمر لا بدّ منه لحصول الظهور.
قال الإمام الصادق (عليه السلام):
«إِنَّ قُدَّامَ اَلْقَائِمِ عَلاَمَاتٍ تَكُونُ مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُؤْمِنِينَ. قُلْتُ: وَمَا هِيَ؟ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: ذَلِكَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم﴾ يَعْنِي اَلْمُؤْمِنِينَ قَبْلَ خُرُوجِ اَلْقَائِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ﴿بِشَيْءٍ مِنَ اَلْخَوْفِ وَاَلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ اَلْأَمْوٰالِ وَاَلْأَنْفُسِ وَاَلثَّمَرٰاتِ وَبَشِّرِ اَلصّٰابِرِينَ﴾. قَالَ: يَبْلُوهُمْ بِشَيْءٍ مِنَ اَلْخَوْفِ، مِنْ مُلُوكِ بَنِي فُلاَنٍ فِي آخِرِ سُلْطَانِهِمْ وَاَلْجُوعِ بِغَلاَءِ أَسْعَارِهِمْ ﴿وَنَقْصٍ مِنَ اَلْأَمْوٰالِ﴾، قَالَ: كَسَادِ اَلتِّجَارَاتِ وَقِلَّةِ اَلْفَضْلِ. ﴿وَنَقْصٍ مِنَ اَلْأَنْفُسِ﴾، قَالَ: مَوْتُ ذَرِيعٍ. ﴿وَنَقْصٍ مِنَ اَلثَّمَرَاتِ﴾، قَالَ: قِلَّةُ رَيْعِ مَا يُزْرَعُ. ﴿وَبَشِّرِ اَلصّٰابِرِينَ﴾ عِنْدَ ذَلِكَ بِتَعْجِيلِ خُرُوجِ اَلْقَائِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ»[56].
لقد ابتلى الله الإنسان بالمصائب حتّى يقطع أمله من الدنيا ويلتجئ إليه تعالى، ليبتعد عن التمسّك بالدنيا فتصافح روحه يد الله تعالى، من كان يضع يده بيد أحدهم ما كان ليتمكّن من مدّ يده للآخر.
لا يمكن أن تمدّ يدك لأكثر من شخص في الوقت عينه. إذاً، ما لم يتخلّ المرء عن الدنيا ويتمكّن من الفكاك من قبضتها؛ لن يتمكّن من التمسّك بالآخرة والتوجّه نحوها، لا بد من الخروج من بيعة الظالم لنتمكّن من مبايعة الإمام، ومغادرة وادي الكفر لندخل في وادي الإيمان. ما لم تنقض اللحظات الأخيرة من الليل، لن تسفر اللحظات الأولى من الصبح. نعم، هذه حرفة المصائب،
يمكن لها أن تنزع يد الإنسان من قبضة الدنيا وإلى الأبد. ولأنّ الله تعالى يريد أن يخرج الإنسان من حبائل الدنيا والتعلّق بها؛ يلقي عليه بثقل الآلام وأنواع المصائب. قد نضطرّ أحياناً أن نصفع من فقد وعيه لنوقظه، والمصائب هي الصفعة الإلهيّة على وجه الغافلين وسكارى وادي الدنيا.
2.2. الاستعداد المعرفيّ
لقد كرّر الله وعده في القرآن الكريم بانتصار الإسلام ودخول الناس فيه في سائر أنحاء المعمورة، وإقامة حكومة الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)، لكنّ ثمّة شروطاً لتحقّق هذا الوعد: اهتمام العالم بالإسلام والتعرّف عليه، أيضاً التعرّف على القائم على تطبيق التشريعات الإسلاميّة أي الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)؛ من جملة تلك الاستعدادات الفكريّة والمعرفيّة التي ينبغي للناس امتلاكها. کیف لمن لم يتعرّف على الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) وعدله ورحمته أن يخضع لحكمه ويسلّم له؟! إنّما يظهر إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) يوم يكون الناس مهيّئين من سائر الجهات، وعلى دراية بالمعارف والمقاصد القرآنيّة والإسلاميّة، يوم يكون الناس مستعدّين للقبول بحكومة إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه).
3.2. الطاعة العمليّة
إنّ المشكلة الأكبر التي واجهها الأئمّة المعصومون (عليهم السلام)على امتداد حياتهم المباركة؛ هي عدم امتثال الناس لأوامرهم على المستوى العمليّ على الرغم من محبّتهم لهم (عليهم السلام)؛ في حين أن الناس إن أرادوا خروج الإمام (عجل الله تعالى فرجه)، فلا بدّ لهم من أن يكونوا مهيّئين واقعاً وعمليّاً
لذلك، وللخضوع لأوامر الإمام (عجل الله تعالى فرجه) والامتثال لها، حتّى ينالوا رضى الله تعالى ويأذن بالظهور. جاء في كلام للإمام الباقر (عليه السلام):
«ذِرْوَةُ الأَمْرِ وَسَنَامُهُ وَمِفْتَاحُهُ وَبَابُ الأَشْيَاءِ وَرِضَى الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الطَّاعَةُ لِلإِمَامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ.»[57].
فمن المؤكّد أنّ الله تعالى إذا رأى أهليّتنا –التي تمثّل شاهد صدقنا في طلب الفرج– عجّل في ظهور الإمام (عجل الله تعالى فرجه).
4.2. التقوى والورع
لا بدّ أن نعلم من أنّنا غير مأمورين بترك أعمالنا والسعي لرؤية إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه)؛ كما أنّ أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) لم يكونوا مأمورين بذلك؛ المهمّ في الأمر هو المعرفة والطاعة. نعم، اللقاء بالإمام (عجل الله تعالى فرجه) أمر عظيم، لكن أن نترك أعمالنا للبقاء مع الإمام حيثما كان فهذا ما لم نكلّف به. زيارة الإمام فضيلة، لكن ما من آية أو رواية تدعونا إلى ترك أعمالنا لنحفّ بالإمام في كلّ آن! جاء في الحديث: «اتَّقُوا اللّه»! عندها يأتي الإمام بنفسه إليكم.
أحدهم ركب الصعب والذلول كي يرى الإمام (عجل الله تعالى فرجه)، وفي نهاية المطاف بلغه أنّ إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) سيحضر في منزل معيّن في المدينة الفلانيّة في اليوم الفلانيّ. فقصد ذلك المكان ليجد رجلاً مشغولاً بعمله، قد جلس بجانبه سيّد جليل –عُلِم بعد ذلك أنّه إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه)-، خاطبه السيّد الجليل قائلاً: «لماذا ترهق نفسك ذهاباً وجيئة، تقصد هذا المكان وذاك المكان؟! قال: سيّدي! أريد أن
أرى إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه). فقال ذلك السيّد: «كن تقيّاً منصفاً كهذا الرجل؛ فيأتي إليك إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) بنفسه».
وجاء في حادثة أخرى أنّ أحد العلماء علم بحضور إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) في أحد المنازل. قصد ذلك المنزل فإذا بمرأة هناك قد فارقت الحياة والإمام جالس إلى جانبها. فسأل هذا الرجل الإمام (عجل الله تعالى فرجه): ماذا صنعت هذه المرأة حتّى تحضر إليها عند وفاتها؟ فقال (عجل الله تعالى فرجه): «عندما منع رضا شاه الحجاب [في إيران]؛ امتنعت هذه المرأة التقيّة سبع سنوات عن الخروج من منزلها حتّى لا يعمد رجال الأمن التابعون لرضا شاه إلى نزع عباءتها بالقوّة. فلتكن فيك مثل هذه التقوى حتّى تحظى بعناية إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه)»!
ليس بالضرورة أن نذهب إلى جمكران –والذهاب إليه فضيلة– حتّى نرى الإمام (عجل الله تعالى فرجه). يسأل الكثيرون: ماذا نصنع لنلتقي بإمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه)؟ الجواب: لا تعصِ الله تعالى، فتصبح لائقاً باللقاء.
5.2. اجتماع القلوب على طلب الظهور
من الشرائط المطلوبة في المجتمع المنتظر لإمام العصر (عجل الله تعالى فرجه)؛ أن يكون هذا المجتمع على قلب واحد، وتجتمع فيه القلوب على طلب تعجيل الظهور. لا يكفي أن يطلب فرد أو جماعة صغيرة ظهور إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) ليقيم الحكومة العالميّة؛ بل لا بد أن يكون ذلك مطلباً صادقاً لدى عموم الناس، وفي الحدّ الأدنى أن تجتمع كلمة جميع المعتقدين بالإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) وقلوبهم على الولاية المهدويّة، لأنّ إمام الزمان نفسه (عجل الله تعالى فرجه) يقول:
«ولو أنّ أشياعنا وفّقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في
الوفاء بالعهد عليهم، لما تأخّر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلّت لهم السعادة بمشاهدتنا على حقّ المعرفة وصدقها منهم»[58].
6.2. خيبة الأمل من المناهج البشريّة
من بين العوامل التي تهيّئ الأرضيّة العامّة لظهور المهديّ الموعود (عجل الله تعالى فرجه)؛ الوعي بعقم المناهج البشريّة المختلفة وأساليب الحكم المتعدّدة. فحينئذ، يبدأ الناس في البحث عن منهج وحكومة يمكن لها فعلاً أن تُوصلهم إلى السعادة في الدنيا والآخرة، وأن تضمن لهم الفوز والفلاح.
قال الإمام الباقر (عليه السلام):
«دَوْلَتُنَا آخِرُ الدُّوَلِ، وَلَنْ يَبْقَ أَهْلُ بَيْتٍ لَهُمْ دَوْلَةٌ إِلَّا مُلِّكُوا قَبْلَنَا، لِئَلَّا يَقُولُوا إِذَا رَأَوْا سِيرَتَنَا إِذَا مُلِّكْنَا سِرْنَا مِثْلَ سِيرَةِ هَؤُلَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ»[59].
وبالفعل، بدأت تظهر جليّاً بوادر يقظة الشعوب ويأسها من المناهج الحكومات القائمة. فأيّ قانون ظالم هذا الذي يمنح دولاً عدّة في الأمم المتحدة من دون سواها حقّ النقض (الفيتو)، بحيث لو اجتمعت جميع الدول على موقف محقّ يتعارض مع مصالحهم، أمكنهم إبطاله؟! إنّ امتلاك هذا الحقّ لخمس دول يعدّ إهانة واحتقاراً لبقيّة الدول والشعوب، وقد رأينا مراراً كيف انتُهكت حقوق الشعوب باستخدام هذا الحقّ غير المشروع.
7.2. طاعة نائب الإمام والوليّ الفقيه
من بين شروط ظهور الإمام (عجل الله تعالى فرجه) المرتبطة بالناس، أن يثبتوا صدقهم من خلال طاعتهم لخلفاء الإمام ونوّابه. إنّ سبب غيبة الإمام الثاني عشر هو عدم جاهزيّة الناس لقبول قيادته. لقد ادّخره الله عزّ وجلّ للزمان المناسب، حينما تصل معرفة الناس ووعيهم إلى المستوى الذي يمكّنهم من فهم نور الإمامة والاهتداء بهديه. لكن من جهة أخرى، فإنّ أهل البيت (عليهم السلام)لم يخلّونا وأنفسنا في زمن غيبة الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)، بل أمرونا باتّباع الفقهاء العدول الأتقياء الذين هم النوّاب العامّون للإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه). من هنا، كان لزاماً علينا في الحوادث الواقعة امتثال حكم الله فيها من خلال الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط العادل.
إنّ دور ولاية الفقيه هو نفسه دور الإمامة والامتداد لطريق الأنبياء (عليهم السلام). إنّ في الإسلام أحكاماً وقوانين اقتصاديّة، وجزائيّة، وعسكريّة وقضائيّة، لا يرضى الإسلام بتعطيلها من جهة، كما لا يرضى أن يُعهد بإقامتها إلى أشخاص جاهلين بتلك الأحكام من جهة أخرى. إنّ تطبيق تلك الأحكام وإقامتها إنّما هما بيد الفقهاء العدول، وعلماء الإسلام الأتقياء الذين يحكمون في جميع الحوادث وفق القانون الإلهيّ، وإطاعة مثل هؤلاء الفقهاء واجبة كطاعة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله)، والإمام المعصوم (عليه السلام).
ألا يحتاج المسلمون إلى حكومة ونظام؟ ألا ينبغي حفظ المجتمع والبلاد الإسلاميّة؟ ألا يجب الذود عن الحدود؟ ألا يجب تطبيق القوانين في البلدان الإسلاميّة؟ ألا ينبغي أخذ حقّ المظلوم من الظالم ومجازاة الظالم على ظلمه؟ ألا ينبغي أن تعمّ كلمة
الإسلام العالم؟ هل كان سعي الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام)وجهادهم خاصّيْن بزمانهم، أم كانا من أجل سائر الأماكن وجميع الأزمنة؟
إذا كان الجواب عن هذه الأسئلة بالإيجاب، وكان الإسلام يحتاج إلى النظام، والحكومة، والمجتمع والقانون، وحفظ الحقوق والحدود، كان وجود الحكومة الإسلاميّة في عصر الغيبة واجباً أيضاً. فمن دون تشكيلات وإدارات منظّمة ومحكمة –لا سيّما في هذا الزمن الذي يملك فيه جميع أعداء الإسلام تشكيلات ومؤسّسات ضخمة ومحترفة-؛ لا يمكن لنا أبداً الدفاع عن حريم القانون، والمذهب، والحدود والأرواح، والأموال، وعن ماء وجهنا. فإذا كانت الحكومة واجبة وضروريّة، كان وجود الحاكم أيضاً واجباً وضروريّاً، إذ يستحيل وجود حكومة دون حاكم.
بعد أن تبيّن أنّ الإسلام يحتاج إلى الحكومة والحاكم من أجل تطبيق أحكامه؛ لا بدّ من أن نعلم ما هي الشروط التي يجب توفّرها في الحاكم: هل يجب أن يكون عميقاً في معرفة حكم الله أم لا؟ هل يجب أن يكون عادلاً أم لا؟ هل يجب أن يكون مطّلعاً على ما يجري اليوم ومتطلّبات العصر أم لا ؟ فإن كان الجواب بالإيجاب؛ وكنّا نحتاج إلى حاكم عارف بالإسلام تقيّ وعالم بالسياسة؛ فهذا هو ما نسمّيه نحن ولاية الفقيه.
8.2. الدعاء الجماعيّ وظيفة الجميع
جرى التأكيد في العديد من الأحاديث المهدويّة على ضرورة الدعاء لإمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه)، وأمرنا أهل البيت(عليهم السلام) باللجوء إلى
الله تعالى وطلب حفظ الدين والتعجيل في الفرج، وقد جاء عن إمام العصر (عجل الله تعالى فرجه) نفسه: «أَكْثِرُوا اَلدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ اَلْفَرَجِ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ فَرَجَكُمْ»[60].
لكن قد يرد إلى الذهن السؤال عن الدواعي التي لأجلها ندعو للإمام. والجواب:
- إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) من زمرة المؤمنين؛ وقد أمر النبيّ (صلى الله عليه وآله) بالدعاء للمؤمنين.
- هو نصير المستضعفين، وإمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) نفسه قال: «إِنَّا غَيْرُ مُهْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلاَ نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ»[61].
- هو محيي دين الله: «أَيْنَ مُحْيِي مَعَالِمَ الدِّينِ؟»[62]، وأيضاً: ﴿يُظهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ (التوبة: 33).
- هو المضطرّ. سئل الإمام الباقر (عليه السلام) عن قوله تعالى: ﴿أَمَّن يُجِيبُ المُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ (النمل: 62)؛ فقال (عليه السلام): «نَزَلَتْ فِي الْقَائِمِ»[63].
- هو مؤلّف القلوب: «أَيْنَ مُؤَلِّفُ شَمْلِ الصَّلَاحِ وَالرِّضَا؟»[64].
- هو رحيم بنا. قال الإمام الصادق (عليه السلام) وهو يصف الأئمّة (عليهم السلام)–وإمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه)من جملتهم-: «وَاللَّهِ إِنَّا أَرْحَمُ بِكُمْ مِنْكُمْ بِأَنْفُسِكُمْ»[65].
– به (عجل الله تعالى فرجه) تُقبل أعمالنا.
– به (عجل الله تعالى فرجه) يُدفع عنّا البلاء. قال (عجل الله تعالى فرجه): «بِي يَدْفَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْبَلَاءَ عَنْ أَهْلِي وَشِيعَتِي»[66].
- هو ناشر العدل كما جاء في عدد كبير من الروايات.
- هو شفيعنا يوم الدين. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في وصف إمام العصر (عجل الله تعالى فرجه): «الْمَهْدِيُّ شَفِيعُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»[67].
الخاتمة: في الإجابة عن بعض الأسئلة
تمهيد
سعينا في هذا الكتاب من خلال ما ورد فيه من توضيحات حول مسألة الظهور؛ إلى تبيين لزوم تهيئة شروط الظهور، وذكرها، لكن قد يرد على ذهن القارئ لهذه المطالب، حول شرائط ظهور إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) أسئلة في هذا الخصوص. كما قد تنتج بعض الأسئلة عن الشبهات التي يلقيها أعداء المهدويّة في وسائلهم الإعلاميّة.
من هنا، سعينا في خاتمة هذا الكتاب إلى ذكر إجابات مختصرة عن بعض الأسئلة المتداولة حول هذا الموضوع.
1. السؤال: جاء في بعض الأحاديث أنّ كلّ قيام قبل قيام إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) باطل. فما هو المراد من ذلك؟
الجواب: إنّ الأحاديث التي تنهى عن القيام قبل قيام إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه)؛ إمّا موضوعة، وإمّا أنّها لم تُفهم على وجهها الصحيح. فالروايات إنّما تتحدّث عمّن يقوم قبل ظهور الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)، ويدعو الناس إلى نفسه. إنّ مثل هذا الشخص طاغوت، وهذا ما يصرّح به هذا الحديث:
«كُلُّ رَايَةٍ تُرْفَعُ قَبْلَ قِيَامِ اَلْقَائِمِ، فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»[68].
أمّا لو قام شخص لتمهيد الأرض لظهور الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)؛ فلا وجه لبطلان هذا القيام. فلو أنّ كلّ شيء كان منوطاً بإمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه)؛ ماذا يبقى من حاجة لكلّ هذه الآيات التي تحدّثنا عن الدفاع عن المظلوم، والضرب على يد الظالم، والنهي عن المنكر وإجراء الحدود الإسلاميّة؟ وهل يمكن تعطيل أحكام القرآن لأكثر من ألف سنة إلى حين ظهور إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه)؟
علينا من أجل فهم مثل هذه الأحاديث؛ أن نعلم أنّ المعصومين (عليهم السلام)أمرونا في روايات أخرى أن نعرض كلّ حديث يصلنا عنهم على القرآن، وأن نضرب بكلّ حديث يخالف القرآن عرض الحائط.
قال الإمام الصادق (عليه السلام) في كلام له:
«مَا وَافَقَ كِتَابَ اللَهِ فَخُذُوه، وَمَا خَالَفَ كِتاَبَ اللَهَ فَدَعُوه»[69].
بعض المصادر السنيّة ذكرت لزوم إطاعة الحاكم مهما كان ظالماً، هذا في حين أنّ القرآن الكريم يقول: ﴿وَلَا تُطِعۡ مِنۡهُمۡ ءَاثِمًا أَوۡ كَفُورا﴾ (الإنسان: 24). فهذه الآية تنهى عن إطاعة العاصي، ومنها يعلم أنّ هذا الحديث موضوع.
ويؤيّد ذلك قيام زيد بن الإمام السجّاد (عليه السلام)، الذي كان محلّ تأييد الأئمّة (عليهم السلام). وفي مثال آخر على ذلك، فإنّ الإمام الصادق(عليه السلام) –
وعلى الرغم من أنّه لم يجز القيام في خصوص المورد المسؤول عنه في هذه الرواية- قد شجّع على الخروج في زمان هشام ومن بعده، وعلى الأمر بالمعروف وزعزعة سلطان السلطة الحاكمة، يقول (عليه السلام):
«لاَ أَزَالُ أَنَا وَشِيعَتِي بِخَيْرٍ مَا خَرَجَ اَلْخَارِجِيُّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ اَلْخَارِجِيَّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ خَرَجَ وَعَلَيَّ نَفَقَةُ عِيَالِهِ»[70].
2. السؤال: نحن مأمورون بطاعة إمام العصر (عجل الله تعالى فرجه)، فكيف لنا اليوم حال غياب إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) إحراز موافقة أعمالنا لرضاه؟
الجواب: في زمان غيبة الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه)، لم يدعنا الإمام وحدنا، بل أمرنا باتّباع الفقهاء العدول الأتقياء، والذين هم نوّابه العامّون في زمن الغيبة، يقول (عجل الله تعالى فرجه):
«وَأَمَّا اَلْحَوَادِثُ اَلْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ»[71].
من هنا، كان لا بدّ لنا في الحوادث الواقعة من امتثال حكم الله فيها، والذي يقضي بالرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط العادل. طبعاً، للمجتهد الذي يجب علينا الرجوع إليه خصائص وصفات ذكرها الإمام العسكريّ (عليه السلام) بقوله:
«مَنْ كَانَ مِنَ اَلْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلاَهُ، فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ»[72].
وهذه مواصفات تنطبق على بعض فقهاء الشيعة لا على الجميع. لذلك، كان تكليفنا إطاعة المجتهد العادل. صحيح أنّ المجتهد غير معصوم، لكن وتبعاً لحكم العقل وحكم الإسلام؛ يجب على كلّ مسلم إمّا أن يكون مجتهداً أو مقلِّداً لفقيه من الفقهاء. إن أصاب الفقيه فله حسنتان، وإن أخطأ، مع أنّه عادل ومراع لأصول الاجتهاد، كان له أجر واحد (لا أدري كم يحسن الاستدالال بهذا الحديث الذي لم يرد في مصادرنا والذي يوجد اختلاف بين الفقهاء في التعامل معه وحتى من قبل مضمونه فاعتمادنا على المباني لا على نفس الحديث). حتّى لو ذهب أحدهم إلى أنّ الفقيه الفلانيّ مثلاً أخطأ في المورد الفلانيّ، فذلك أيضاً لا يشكّل مشكلة، كما هو الحال حينما يذهب المرء إلى الطبيب ويصف له الدواء ثمّ لا يكون مؤثّراً، فليس لأحد أن يمزق الوصفة.
3. السؤال: جاء في أحاديث كثيرة أنّ إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) إنّما يخرج بعدما تمتلئ الدنيا ظلماً وجوراً، فإن كان الأمر كذلك، فما الداعي لتهيئة شروط الظهور؟
الجواب: إذا دقّقنا في الروايات المهدويّة، نجد أنّها ذكرت كلمة «ظُلْماً»، وبين الظلم والظالم فرق. هذه الأحاديث تقول إنّ الدنيا تمتلئ من الظلم لا من الظلمة! بينهما فرق فتأمّله، مثلاً تارة تقول: سأطلي الجدار باللون الأبيض عندما يصبح الجميع مدّخنين، وتارة أخرى تقول: سأطلي الجدار باللون الأبيض إذا امتلأ المكان بالدخان. ففي الحالة الثانية، يكفي أن يقوم شخص واحد بإشعال حطب في المكان فيمتلئ دخاناً. إذاً، يكفي دولة
واحدة كأمريكا حتّى تملأ الدنيا ظلماً، ويمكن [لكيان غاصب] كإسرائيل أن يملأ منطقة بالفساد. وعليه، هذه الأحاديث تقول إنّ الإمام (عجل الله تعالى فرجه) سيأتي بعدما تمتلئ الدنيا ظلماً، وامتلاؤها ظلماً لا يعني بالضرورة امتلاءها بالظالمين. يضاف إلى ذلك أنّ الدنيا الآن مليئة بالظلم، ومع ذلك، فإمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) لم يظهر بعد؛ من هنا، يُعلم أنّ هذه المسألة ليست هي السبب في عدم خروج إمام العصر (عجل الله تعالى فرجه)، وإنّما عدم تحقّق شروط الظهور.
الأمر الآخر هو أنّ فلسفة قيام إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) هي القضاء على الظلم، فكيف يمكن أن يكون إحلال الظلم والإفساد شرطاً في الظهور؟!
4. السؤال: هل انتظار إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) يعني السكوت عن الظلم وعدم المبالاة به؟
الجواب: نحن في كلّ ليلة ننتظر طلوع شمس اليوم التالي، لكنّ انتظار طلوع الشمس لا يعني أن نضع يداً فوق يد ونقعد في ظلمة الليل إلى الصباح، بل يعمد كلّ منّا إلى إنارة غرفته التي هو فيها. في الشتاء، نكون في حالة انتظار لقدوم الربيع، ولكنّ انتظارنا للربيع لا يعني أن نقضي الشتاء ونحن نرتجف من البرد من دون أن نقوم بتدفئة غرفتنا. كذلك الحال في زمن غيبة إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه)؛ إذ علينا مواجهة الظلم والمضيّ في طريق الإصلاح ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً.
عندما نقرأ في الروايات أنّ «أَفْضَل الأَعْمَالِ انْتِظَارُ الفَرَج»[73]، ندرك أنّ الانتظار ليس حالة، بل عمل: «أفضل الأعمال»؛ لذا، المنتظرون الحقيقيّون عليهم أن يكونوا من أهل العمل.
المنتظرون للمصلح لا بدّ من أن يكونوا صالحين، من كان ينتظر ضيفاً لا يجلس في داره غير مبال. نعم، إنّ وظيفة الناس في زمن الغيبة إصلاح أنفسهم، والأمر بالمعروف، ودعوة الناس إلى الحقّ وبثّ الوعي فيهم.
5. السؤال: يشكّل الصبر والثبات أحد الشروط الإنسانيّة الأساسيّة للظهور، وهو أيضاً من جملة العوامل الأساسيّة للنجاح في البلاءات والاختبارات في عصر الغيبة. فما هو السبيل للصبر على المصاعب والمشكلات في نظر القرآن الكريم؟
الجواب: في هذا السياق، يرشدنا القرآن الكريم إلى هذه السبل:
أ. امتلاك رؤية كونيّة إلهيّة
في مدحه للمؤمنين الصابرين عند المصاعب والمصائب، يذكر القرآن الكريم أنّ هؤلاء يقابلون الأحداث التي تواجههم بالقول: أنّهم لله تعالى وليس لهم أيّ استقلال في أنفسهم، وهم يسلّمون أمرهم له تعالى، وأنّ وجودهم والنعم التي هم فيها وكلّ شيء منه تعالى، وذلك كلّه أمانة عندهم ليس إلّا؛ يقول تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتهُم مُّصِيبَة قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ﴾ (البقرة: 156).
إنّ الصابرين لا يُسلّمون أنفسهم للخوف، ولا يلجأون إلى الآخرين، بل يلوذون بالله وحده، فهم يعلمون أنّ الكون بأسره ميدان للتعلّم والامتحان الذي من خلاله نسلك طريق تكاملنا. الدنيا ليست دار مقرّ واستراحة ومنادمة، والشدائد والصعوبات التي فيها ليست دليلاً على عدم رحمة الله لنا، بل المصائب هي الشعلة التي أوقدت تحت أرجلنا كي لا نقف في أماكننا فنتحرّك بسرعة. من هنا، فإنّ في المرارات حلاوة أيضاً، لأنّها تفتّح القابليّات ويعقبها الفوز بالثواب الإلهيّ. هذه هي النظرة والرؤية الكونيّة التي تمكّن الإنسان من التعامل الصحيح مع الأحداث.
ب. معرفة السنن الإلهيّة
يخبرنا القرآن الكريم أنّ الجنّة لن تكون من نصيبنا من دون أن نكون عرضة للاختبار والألم والمشقّة، بل لا بدّ لنا من أن نواجه أصعب الأحداث حالنا حال من سبقنا من الناس والأمم، يقول تعالى:
﴿أَم حَسِبتُم أَن تَدخُلُواْ الجَنَّةَ وَلَمَّا يَأتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبلِكُم مَّسَّتهُمُ البَأسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمنوا مَعَهُ مَتَى نَصرُ الله أَلَا إِنَّ نَصرَ الله قَرِيب﴾ (البقرة: 214).
تحدّثنا هذه الآية أنّ أهل الإيمان وأتباع الحقّ كانوا طوال التاريخ عرضة لأصعب البلاءات، وأنّه قد وصلت النوبة إليكم الآن، فمواجهة الأحداث المريرة ليست بالأمر الجديد، ولستم وحدكم من ابتُلي بهذه الصعوبات والمشاكل؛ إن هي إلّا سنّة إلهيّة ستمضون عليها. مكرّراً ما جاء في القرآن الكريم قوله
تعالى: ﴿وَاذكُر فِي الكِتَابِ﴾ (مريم: 41-51)، اذكروا ما جرى على الأنبياء (عليهم السلام)والأمم السابقة، ولا تظنُّن أنّكم خصصتم بالمصائب، ثمّ يأمر نبيّه (صلى الله عليه وآله) بالصبر: ﴿فَٱصۡبِرۡ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلۡعَزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ﴾ (الأحقاف: 35).
نعم، حينما يعلم الإنسان أنّ المكاره والصعوبات قانون وسنّة إلهيّة ستجري على الجميع؛ يكون أكثر استعداداً لمواجهتها. الصائم في شهر رمضان لا يجد صعوبة في الصوم لأنّ الجميع في ذلك الشهر صيام، أمّا الصيام خارج شهر رمضان فيكون أصعب.
ج. التعرّف على الصابرين ومستوى صبرهم
إنّ الاطّلاع على استقامة من سبقنا؛ أحد أسرار النجاح في مواجهة الأحداث، وقد تحدّث القرآن الكريم كثيراً عن ذلك، وذكر لنا الأمم السابقة ومن كانوا فيها أسوة في الصبر، وأنواع الصبر والاستقامة التي تحلّت بها الأفراد والأمم السابقة. يذكر القرآن الكريم أنّ الأنبياء (عليهم السلام)وفي مواجهة أشدّ المخالفين لهم، كانوا يقولون: ﴿وَلَنَصۡبِرَنَّ عَلَىٰ مَآ ءَاذَيۡتُمُونَاۚ﴾ (إبراهيم: 12)؛ كذلك الأمر بالنسبة إلى السحرة الذين جاؤوا لمواجهة النبيّ موسى (عليه السلام) والتغلّب عليه؛ ما إن عرفوا أنّه (عليه السلام) جاءهم بالحقّ حتّى آمنوا به، وقابلوا تهديدات فرعون بالقول: ﴿فَٱقۡضِ مَآ أَنتَ قَاضٍۖ إِنَّمَا تَقۡضِي هَٰذِهِ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَآ﴾ (طه: 72).
إنّ العلم بتاريخ الماضين له بالغ الأثر في صبر الإنسان وتحمّله،
كذلك العلم بأسرار المستقبل يؤثّر في قدرته على الصبر والتحمّل، لذلك أخبر الخضر(عليه السلام) موسى (عليه السلام) أنّه لن يكون قادراً على الصبر والتحمّل لعدم علمه بأسرار ما سيقوم به: ﴿وَكَيفَ تَصبِرُ عَلَى مَا لَم تُحِط بِهِ خُبرا﴾ (الكهف: 68).
د. الشعور بحضور الله
عندما يعلم الإنسان ويتيقّن أنّ الله تعالى مطّلع على سائر أعماله وسلوكه وحتّى أفكاره، وأنّه تعالى حاضر ناظر في كلّ الأحوال، عندها سيتمكّن من الصبر على المصاعب، وتصبح الشدائد سهلة عنده، بل أحياناً تصبح عذبة يقدم عليها بنفسه. لقد أمر الله موسى وهارون (عليهما السلام) أن يذهبا إلى فرعون، وأن يُسمعاه قول الحقّ، ويدعواه إلى توحيد الله! ثمّ أعلمهما أنّه تعالى معهما يرى عملهما ويسمع كلامهما: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسمَعُ وَأَرَى﴾ (طه: 46).
كذلك عندما أمر الله تعالى نوحاً (عليه السلام) بصنع السفينة لتكون سبباً في نجاة المؤمنين من العذاب بحيث قال تعالى: ﴿وَاصنَعِ الفُلكَ بِأَعيُنِنَا﴾ (هود: 37)، فما إن بدأ بصنع السفينة حتّى راح الكفّار يسخرون منه ويقولون له: لم تفلح في النبوّة فرحت تعمل في النجارة! لكن ما مكّن النبيّ نوحاً (عليه السلام) من الوقوف في وجه هذه السخرية والاستهزاء، هو قول الله له أنّه وعمله بعينه تعالى، هذا الإيمان وهذه الرؤية يعزّزان الاستقامة في الإنسان.
هـ. تذكّر الثواب الإلهيّ
من الأمور التي تحيي الاستقامة في روح الإنسان تذكّر آثارها الحسنة والثواب الإلهيّ، لأنّه بتحمّله للشدائد ينال أعظم الثواب في الدنيا والآخرة، والشواهد على ذلك في القرآن الكريم كثيرة.
الفهرس
الفصل الأوّل: قضيّة الظهور في القرآن الكريم والأحاديث.. 9
أوّلاً: حتميّة ظهور المهديّ (عجل الله تعالى فرجه) في القرآن. 11
ثانياً: علّة الغيبة وارتباطها بقضيّة الظهور. 15
ثالثاً: التمهيد للظهور في القرآن. 16
رابعاً: القرآن ومكانة السعي في تحقيق الآمال. 18
خامساً: العلاقة بين السعي والدعاء في القرآن. 19
سادساً: مكانة التوكّل في التمهيد للظهور. 21
سابعاً: القرآن والإمداد الغيبيّ. 23
ثامناً: شروط نزول الإمدادات الإلهيّة في القرآن. 26
تاسعاً: حقيقة الانتظار في العمل على التمهيد 29
عاشراً: وظيفتنا في أمر الظهور. 33
حادي عشر: لزوم الاهتمام بشروط الظهور لا بعلاماته. 34
الفصل الثاني: شروط ظهور إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه) 37
أوّلاً: الشروط الإلهيّة للظهور. 39
ثانياً: المقدّمة الإنسانيّة للظهور. 53
ثالثاً: الشروط الخاصّة بالخواصّ والعوامّ 56
الخاتمة: في الإجابة عن بعض الأسئلة. 81
[1] كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق، ج2، ص484.
[2] التوبة: 33.
[3] الكهف: 20.
[4] التوبة: 8.
[5] تفسير العيّاشيّ، العيّاشيّ، ج1، ص183.
[6] كشف الغمّة، الإربليّ، ج2، ص465.
[7] تفسير القمّيّ، القمّيّ، ج2، ص77.
[8] بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج99، ص101.
[9] المصدر نفسه، ج53، ص176.
[10] كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ج2، ص435.
[11] كشف الغمّة، مصدر سابق، ج2، ص465.
[12] الاحتجاج، الشيخ الطبرسيّ، ج2، ص291.
[13] كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ج2، ص485.
[14] التهذيب، الشيخ الطبرسي، ج6، ص325، ح894.
[15] مستدرك الوسائل، الميرزا النوريّ، ج11، ص217.
[16] الغيبة، النعمانيّ، ص200.
[17] تفسير نور الثقلين، العروسيّ الحويزيّ، ج2، ص44.
[18] نهج الفصاحة، ح409.
[19] تفسير الصافي، الفيض الكاشانيّ، ج5، ص136.
[20] مفاتيح الجنان، تعقيبات الصلاة.
[21] البرهان في تفسير القرآن، السيّد البحرانيّ، ج5، ص367.
[22] نهج البلاغة، الخطبة 40.
[23] عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، الشيخ الصدوق، ج1، ص216.
[24] الإرشاد، الشيخ المفيد، ج2، ص386.
[25] كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ج1، ص277.
[26] المصدر نفسه، ج2، ص367.
[27] الكافي، الشيخ الكلينيّ، ج1، ص69.
[28] تفسير العياشيّ، مصدر سابق، ج1، ص197.
[29] كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ج1، ص331.
[30] الغيبة، الشيخ الطوسيّ، ص472.
[31] نهج البلاغة، الخطبة 178.
[32] الغيبة، مصدر سابق، ص198.
[33] كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ج2، ص654.
[34] بحار الأنوار، مصدر سابق، ج25، ص308.
[35] المصدر نفسه، ج25، ص308.
[36] كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ج1، ص320.
[37] الكافي، مصدر سابق، ج1، ص337.
[38] تفسير الصافي، الكاشاني، ج2، ص18.
[39] بحار الأنوار، مصدر سابق، ج25، ص308.
[40] بحار الأنوار، مصدر سابق، ج25، ص308.
[41] المصدر نفسه، ج2، ص411.
[42] الأنوار، مصدر سابق، ج25، ص308.
[43] الغيبة، مصدر سابق، ص200.
[44] الغيبة، مصدر سابق، ص316.
[45] كمال الدين تمام النعمة، مصدر سابق، ج1، ص320.
[46] دلائل الإمامة، الطبريّ الآمليّ، ص562.
[47] الخصال، الشيخ الصدوق، ج2، ص541.
[48] كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ج2، ص456.
[49] كفاية الأثر، الخزاز، ص232.
[50] كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ج1، ص320.
[51] ميزان الحكمة، الريشهريّ، ج6، ص266.
[52] مستدرك الوسائل، مصدر سابق، ج12، ص179.
[53] الخصال، مصدر سابق، ج1، ص42.
[54] إلزام الناصب، الحائريّ، ج2، ص168.
[55] الكافي، مصدر سابق، ج3، ص424.
[56] كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ج2، ص646.
[57] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج1، ص185.
[58] الاحتجاج، مصدر سابق، ج2، ص499.
[59] الغيبة، الشيخ الطوسيّ، ص437.
[60] كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ج2، ص48
[61] الاحتجاج، مصدر سابق، ج2، ص495.
[62] إقبال الأعمال، ابن طاووس، ص297.
[63] الغيبة، مصدر سابق، ص31.
[64] إقبال الأعمال، مصدر سابق، ص297.
[65] دلائل الإمامة، الطبريّ، ص134.
[66] كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ج2، ص441.
[67] إلزام الناصب، مصدر سابق، ج1، ص174.
[68] الكافي، مصدر سابق، ج8، ص295.
[69] همان، ج1، ص69.
[70] وسائل الشيعة، الحرّ العامليّ، ج15، ص54.
[71] كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ج2، ص484.
[72] تفسير الإمام العسكريّ (عليه السلام)، ص299.
[73] بحار الأنوار، مصدر سابق، ج75، ص208.