تعيش المجتمعات اليوم حالة من التحولات العميقة خاصة فيما يتعلق بسلوك الشباب وتوجهاتهم، في ظل غياب رؤية حكومية واضحة لمعالجة التحديات المتزايدة التي تواجه هذه الفئة، فالشباب، الذين يشكلون عماد المستقبل، يجدون أنفسهم وسط فوضى ثقافية واجتماعية ناجمة عن تراجع القيم التقليدية من جهة، والتأثيرات الخارجية غير المنضبطة من جهة أخرى، ناهيك، عزيز القارئ، عن النقص الملحوظ في المؤسسات الشبابية التي تكاد ان تكون معدومة من التي يقع على عاتقها احتضان هذه الطاقات والاستفادة منها لبناء مجتمع اكثر وعياً وجعلهم نواة حقيقية لغدٍ رخي حافل بالنتاجات الثقافية والعلمية.
في العقود الماضية، كانت الأنظمة الحاكمة تفرض رقابة صارمة على الإنتاج الثقافي والفني، بحجة الحفاظ على القيم المجتمعية وحماية الأجيال الناشئة من الانحرافات الفكرية، ورغم أن تلك السياسات كانت تقيد حرية التعبير إلى حد كبير، إلا أنها على الأقل كانت توفر إطارًا معينًا يحكم السلوك العام، أما اليوم، وبعد زوال تلك الأنظمة، فقد أصبحت الساحة مفتوحة أمام تدفق غير محدود للأفكار والسلوكيات، دون وجود أي استراتيجية واضحة من قبل الجهات الرسمية لتوجيه هذه الفوضى نحو مسار يخدم المجتمع.
وبات واضحًا أن غياب الرقابة المنظمة لا يعني بالضرورة تعزيز الحرية، بل قد يساهم في تفشي ظواهر اجتماعية خطيرة، مثل ازدياد الجريمة المنظمة، وانتشار المخدرات، وارتفاع معدلات الانتحار بين الشباب، كما أن تصاعد موجة الإدمان على منتجات مثل السجائر الإلكترونية بات يشكل تهديدًا جديدًا للصحة العامة، إذ انتشرت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ بين الشباب من كلا الجنسين، وأصبحت تُمارس في الأماكن العامة وحتى داخل المؤسسات التعليمية، دون الأخذ بعين الاعتبار ان هذا السلوك اذا ما استمر قد يتحول الى ظاهرة والظاهرة الى "عادة"، والعادة مرض خطير قد يضرب جذور المجتمع ويؤدي الى نتائج لا يُحمد عقباها.
ومع ذلك، فإن معالجة هذه الظواهر لا تعني بالضرورة العودة إلى أساليب الرقابة الصارمة التي كانت تُمارس في الماضي، والتي كانت تصل أحيانًا إلى حد تكميم الأفواه والتدخل في أدق تفاصيل حياة الأفراد، بل المطلوب اليوم هو إيجاد توازن بين الحرية الفردية والمسؤولية المجتمعية، من خلال وضع سياسات واضحة ورؤى وتخطيط يستندان إلى أسس علمية وثقافية، وليس إلى ردود أفعال عشوائية.
اليوم، يقع على عاتق المؤسسات الرسمية والمؤثرة دورًا محوريًا في خلق بيئة تضمن للشباب خيارات بديلة وإيجابية، بدلًا من تركهم ضحايا للفراغ والتأثيرات السلبية، فبدلًا من الاكتفاء بإصدار القوانين التي تحظر بعض السلوكيات، ينبغي التركيز على تقديم حلول عملية، مثل تعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية، ودعم المشاريع الشبابية، وتوفير فرص عمل تحفزهم على بناء مستقبلهم بعيدًا عن الانحرافات.
الوعي المجتمعي هو الآخر عامل أساسي في هذه المعادلة، إذ لا يمكن للحكومة وحدها أن تتحمل مسؤولية ضبط إيقاع المجتمع، ما لم يكن هناك وعي جمعي بخطورة بعض الممارسات وضرورة تبني أسلوب حياة متوازن يحافظ على القيم دون الانغلاق على الذات، اذ إن المجتمعات التي تستطيع أن توازن بين الحرية والرقابة، وبين الانفتاح والحفاظ على الهوية، هي وحدها القادرة على التقدم وخلق تواصل بين الأجيال دون أن تفقد بوصلتها الأخلاقية والثقافية.
اليوم، يقف الجميع أمام تحدٍ حقيقي يتطلب إعادة التفكير في النهج المتبع لمعالجة القضايا الشبابية، فإما أن تُترك الأمور على حالها، مما يؤدي إلى مزيد من الفوضى والانحلال، أو يتم تبني سياسات عقلانية تستند إلى التوعية والتوجيه بدلًا من القمع والتضييق، وحدها الحلول الذكية القائمة على التفاعل الإيجابي بين الدولة والمجتمع يمكنها أن تصنع الفارق، وتضمن مستقبلاً أكثر استقرارًا للشباب بعيدًا عن الاستقطاب والتطرف والانجراف نحو خيارات قد تكون كارثية على المدى البعيد.




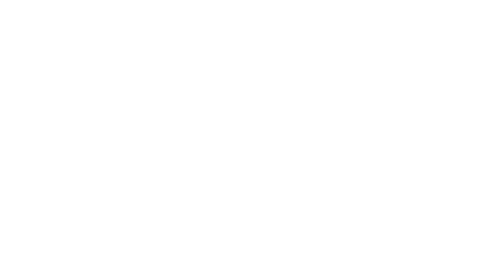
 تقييم المقال
تقييم المقال



